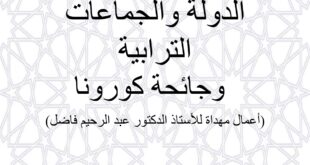دور التعليم الإلكتروني في تجاوز الأزمات” نموذج جائحة كورونا “
فيصل العمادي
طالب بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي.
ABSTRACT
This research tries to address the issue of e-learning, especially in light of the Corona pandemic, considering that education that provides educational content through electronic media such as the Internet, screens, satellites, laser disks or audiovisual tapes, through which the problem of total stoppage and closure is by passed by providing a new method. In education, through the use of modern communication mechanisms such as computers, networks, and multimedia in order to deliver information to learners in the fastest time and in the least costly manner, in a manner that enables the management of the educational process, measurement and evaluation of learners’ performance.
ملخص
يحاول هذا البحث أن يعالج موضوع التعليم الإلكتروني خصوصا في ظل جائحة كورونا باعتبار أن التعليم الذي يقدم محتوى تعليمي عبر الوسائط الإلكترونية مثل الأنترنت أو الشاشات أو الأقمار الاصطناعية أو الأقراص الليزرية أو الأشرطة السمعية البصرية، من خلاله يتم تجاوز مشكلة التوقف والاغلاق الكلي عبر تقديم طريقة جديدة في التعليم من خلال استخدام أليات الاتصال الحديثة كالحاسوب وشبكات والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين بأسرع وقت وأقل كلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء المتعلمين .
مقدمة:
لم يعد من المقبول في مجتمع اليوم، خصوصا بعد التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستمرار في نفس النهج التعليمي الذي رافق فترة قبل اكتشاف الأنترنت وما صاحبها من وسائط إلكترونية، وهو ما أثر على طريقة التعلم الكلاسيكية التي شهدت العديد من التغييرات حيث لم يستطع مواكبة مختلف التطورات المتسارعة والتي رفعت من التحديات التعلمية.
لقد أظهرت جائحة كورونا على حجم التحديات التي تلقي بظلالها على المنظومة التعليمية والصحية والاقتصادية…وما يهمنا في هذا السياق، هو التأثير البالغ الذي تركته جائحة كورونا على النظام التعليمي الذي توقف بسببها في أغلب دول العالم، ومن تم لجوئها إلى تقنية التعليم الإلكتروني.
لقد أدى ظهور الإنترنت إلى تسريع التغييرات التي لحقت التعليم التقليدي نظرا لقدرتها على توفير إمكانيات متعددة للوصول إلى المعلومات والمعارف، وكل ذلك يعتمد على التقنيات الديناميكية والشفافية والحوار المفتوح. حيث أصبح الإنترنت في كثير من الأحيان مصدرا أساسيا للوصول إلى التعليم والثقافة، وهو ما عزز التعليم الإلكتروني باعتباره شكل جديد من أشكال التعليم الذي يقترح نفسه كبديل مع مراعاة احتياجات التدريب والمعرفة المستمرة، كما أنه يتضمن عدة نماذج عملية فعالة تعتمد على أنشطة تعاون واتصالات راسخة؛ لأن الميزة الكبرى للتعليم الإلكتروني هي إلغاء الحواجز الرسمية عن طريق إزالة المسافات، من خلال إدخال المرونة الزمنية وإنشاء نوع جديد من العلاقة بين الطالب والمعلم.
لكن هناك سؤال لا يجب أن يغيب عن ذهننا ونحن بصدد مناقشة موضوع التعليم الإلكتروني، وتتعلق أساسا، بالفوائد العظيمة لهذه الطريقة الجديدة في التعلم عبر الوسائط الإلكترونية، هل ستظل سارية لمن هم في وضع تعليمي ومالي جيد، وبالتالي تعميق الفرص غير المتكافئة وزيادة نسب الجهل والأمية في الأوساط الفقيرة أم أن الأمر يمكن التغلب عليه من خلال توفير هذه الخدمات لجميع المستفيدين على قدر المساواة والتغلب على صعوباتها المالية والتقنية؟
لا يمكن التنبؤ بمستقبل التعليم الإلكتروني ولا بالفرص التي يمكن أن يمنحها ولا المساوئ التي يمكن أن يجرها على المنخرطين في دهاليزه، لكن لا يمكن إنكار واقعيته وجاذبيته وبالتالي ضرورة التعامل معه بواقعية وموضوعية أكثر من أجل الانخراط الواعي فيه وتلافي كل ما من شأنه أن يؤثر على العملية التعليمية التي يمنحها للنشء.
ولمعالجة هذا البحث نقترح الإشكالية التالية:
ما هي دوافع ومبررات تبني نظام التعليم الإلكتروني؟ وكيف يساهم في تجاوز اختلالات التعليم التقليدي؟
أهمية البحث:
يساهم التعليم الإلكتروني إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنيات الحاسب الآلي والشبكة العالمية للمعلومات، وهو ما يمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان، وبالتالي تكمن أهميته في تجاوز كل ما من شأنه عرقلة سير منظومة التعليم التي يتلاقاها النشء.
تقسيم البحث:
المحور الأول: دوافع تبني منهج التعليم الإلكتروني
المحور الثاني: التعليم الإلكتروني وبناء مجتمع المعرفة
المحور الثالث: العوائق وسبل تجاوزها
المحور الرابع: الأفاق المستقبلية
المحور الأول: دوافع تبني منهج التعليم الإلكتروني
أولا: في المفهوم
التعليم الإلكتروني هو ذلك التعليم الذي يقدم محتوى تعلمي عبر الوسائط الإلكترونية مثل الأنترنت أو الشاشات أو الأقمار الاصطناعية أو الأقراص الليزرية أو الأشرطة السمعية البصرية، من خلاله يتم تقديم طريقة جديدة في التعليم عبر استخدام أليات الاتصال الحديثة كالحاسوب وشبكات والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين بأسرع وقت وأقل كلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء المتعلمين[1].
ويمكن القول كذلك، أن التعليم الإلكتروني أسلوب حديث من أساليب التعليم توظف فيه أليات الاتصال الحديثة، من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وأيضا بوابات الأنترنت سواء كان عن بعد أو داخل الفصل الدراسي[2]. وهناك من عرفه بأنه تقديم محتوى تعليمي عبر الوسائط التي تعتمد الحاسوب وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم ومع أقرانه سواء كان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضلا عن إمكانية إدارة هذا التعليم أيضا من خلال تلك الوسائط؛ أي أنه طريقة إبداعية لتقديم بيئة تفاعلية متمركزة حول المتعلمين ومصممة مسبقا بشكل جيد، وميسرة لأي فرد، وفي أي مكان، وفي أي وقت، باستعمال خصائص ومصادر الأنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة والمرنة والموزعة[3].
ثانيا: الدوافع والمبررات
دائما ما كانت تشكل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية والحروب الكونية والأوبئة والجوائح العالمية دافعا أساسيا لابتكار حلول جديدة لما يعانيه العالم من أزمات ومأسي وطالما شكلت حافزا لتجاوزها، وتهييئ أرضية علمية صلبة، رغم ثقل هذه الكوارث والأزمات على النفس البشرية وتداعياتها الوخيمة على الاقتصاد وحصدها لملايين الضحايا. ومع ذلك، فإنها تترك بصيصا من الأمل في إعادة تشكيل حياة الناس أفضل مما كانت عليه صحيا واقتصاديا واجتماعيا؛ فالحرب العالمية الأولى والثانية ساهمت بشكل كبير في بناء مجتمع دولي خفت فيه أسباب الحروب من خلال خلق منظمة الأمم المتحدة والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان دوليا ووطنيا؛ كما خرج الاقتصاد أقوى مما كان عليه إثر الأزمة الاقتصادية 1929 أو ما عرف بالكساد الكبير والخميس الأسود التي ابتدأت من الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت إلى باقي دول العالم[4]، حيث استفادت الرأسمالية من أخطائها السابقة وجددت ألياتها لمواجهة أي كساد أو تضخم اقتصادي قد يأتي في المستقبل؛ وكانت الأوبئة والجوائح التي هزت العالم كالإنفلونزا الاسبانية مدخلا رئيسيا لتطوير المجال الصحي والانكباب على البحث العلمي في هذا الميدان والحد من العديد من الفيروسات الفتاكة.
ولم يكن فيروس كورونا المستجد بخارج عن هذا المسار، فرغم ما أحدثه من هزة غير مسبوقة في نفس البشرية، وما أحدثه من اضطراب وتخبط، فإنه شكل كذلك، محطة لاكتشاف نقط ضعف المنظومة الصحية والأمنية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية… مما يسهل تفاديها في الآت من الأيام. وأهم ما كشفت عنه هذه الجائحة هشاشة النظام التعليمي التقليدي الذي لم يستطع مواكبة هذه التغيرات مما استدعى إعادة التفكير في التعليم الإلكتروني.
لقد أبانت جائحة كورونا عن ضرورة التعلم الإلكتروني الذي لم يعد ترف ثقافي أو فكري وإنما بات ضرورة حتمية لا يرتقي العمل التربوي إلا بها، وليس من المسوغ على الدول التنصل من حتميته في ظل الأوضاع الراهنة والتي أبان عليها فيروس كورونا المستجد بما لا يدع مجالا للشك. ناهيك عن التطور المعرفي والتكنولوجي السريع، الذي بات يشكل جزء أساسي من حياتنا اليومية، والذي أثر على منظمات وهيئات المجتمع، وأدى إلى ضرورة البحث في المجال التربوي عن أفضل الطرق والأساليب التي تساعد المتعلمين على التعلم، وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية تناسب احتياجات المتعلمين في القرن الحادي والعشرين، وتساعدهم على تطوير قدراتهم، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع متغيرات هذا العصر وتواكب تطوراته وتواجه تحدياته.
ومن المعلوم أنه في العصر الحالي لم يعد التعليم منحصر في طبقة أو فئة معينة دون غيرها بل أصبح واجبا وطنيا يلزم الجميع بالتمدرس الاجباري في سن معينة ومن يتخلف عن ذلك يتعرض للعقاب. كما ساهمت ثورة المعلومات والاتصالات في التشجيع على التعليم وتسهيل عملية الولوج إليه، وبالتالي ازدادت تشهد المؤسسات التعليمية وتقدمت تقدما واضحا في مواكبة العملية التعليمية، كما ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم، وازدياد معدل انتقال الطلبة من بلد إلى آخر، إضافة إلى دخول الجامعات في العملية التنافسية على الصعيد العالمي، وذلك بسبب النمو السريع لتقنيات الإنترنت، لذا أصبحت الحاجة ضرورية لإدخال نظم تعليمية حديثة من شأنها أن تنهض بتطوير التعليم العالي، والتقدم والارتقاء به من التعلم التقليدي إلى التعلم الإلكتروني.
كما تعتبر مشكلة استيعاب الطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم خاصة المؤسسات التقنية من أبرز التحديات التي تواجه أنظمة التعليم في بلدان الدول النامية بصوره عامة وفي الوطن العربي بصورة خاصة، لذا فإن الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات أدني بكثير من الطلب الاجتماعي والتدفق الطلابي على التعليم، ولا يمكن لحكومات هذه الدول في ظل أوضاعها المالية وإمكاناتها المادية أن تلبي جميع احتياجات شعوبها وتغطي الخصاص الحاصل على مستوى البنية التحتية التعليمية؛ ويبقى أحد الحلول الناجعة هو تبني مقاربة شاملة للتعليم الإلكتروني للتغلب على هذه الصعوبات. فالمؤسسات التي تطبق التعليم الإلكتروني هي بمثابة مركز تدريب مفتوح ومستمر بدون حواجز حيث يمكن للطالب التواجد في أي مكان في العالم في المكتب أو المنزل وفي أي وقت كما يمكنه متابعة مستقبله المهني وأعماله مع تقدمه في دراسته؛ لأن من أهداف التعليم الإلكتروني التغلب على صعوبة التدفق الطلابي والازدحام في صفوف التلاميذ من خلال أنه[5]:
- يعمل على زيادة فرص التعليم للجميع والحصول على مؤهلات ودرجات علميه في الاختصاصات المختلفة؛
- يتيح فرصه لربات البيوت في المجتمع العربي وللطالبات و الطلبة تحت ظروف الاحتلال ولسكان المناطق النائية والموظفين و المعاقين من مواكبة التعليم في شتى ظروفهم؛
- يراعي التعليم الإلكتروني الفروق الفردية للدارسين في متابعة تعليمهم حيث يتمكن كل دارس من مواصلة الدراسة في أي وقت يشاء وبالسرعة التي يراها مناسبة داخل المرحلة الواحدة، وبالتالي يستطيع أن تختصر الوقت المحدد له وحسب قابليته؛
- يساهم في تعزيز الجانب التقني وزيادة الثروة المعرفية في مجتمعات بلدان دول العالم الثالث وخاصة الوطن العربي؛
- إعداد الكفاءات البشرية ورفع مستواها المعرفي وتنميتها بما ينتج عنه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة للمجتمع.
المحور الثاني: التعليم الإلكتروني وبناء مجتمع المعرفة
إن التعليم يمثل الأسس المتينة التي تنهض بالمجتمع وتساهم في بناء الدولة جنبا مع القضاء والصحة والأمن…بل يمكن القول أن التعليم أهمها؛ إذ لا يمكن أن نؤسس لقضاء جيد دون تعليم جيد وهكذا بالنسبة للصحة والأمن وغيره من المجالات التي تبقى مشروطة في جودتها بالتعليم. ولا يمكن الحديث عن تنمية خاصة في بعدها المستديم دون بناء تعليم حيوي يستجيب لتحديات العولمة التي باتت تهدد خصوصيات الدول وتمحي هوياتهم وتطمس شخصيتهم الثقافية والفكرية دون مرتكز تعليمي قادر على مواجهة تداعياتها ودفع تحدياتها بما يتلاءم مع تعزيز الهوية دون الانكفاء عليها ولكن الانخراط الايجابي في العصر ومواكبة تطوراته دون الانمحاء والذوبان فيه. وبالتالي، التعليم اليوم يواجه في عصر الثورة التكنولوجية والثورة الرقمية العديد من التحديات والفرص التي فرضتها التطورات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات الرقمية وما تخولها من أفاق مستقبلية متعددة إذا تم التعامل معها بمنطق الفرصة التي يجب أن تغتنم.
ولقد تم اعتبار التعليم منذ القديم من أهم الحقوق الإنسانية التي يجب الدفاع عنها وصيانتها وضمان استمرارها وحصول الجميع على تعليم جيد وملاءم ومتاح، لأن العملية التعليمية خصوصا في المراحل الأولى هي التي تصنع عقل الإنسان وتصوغ فكره، ويهذب أخلاقه ويصقل مهاراته وقدراته، ويطور إبداعاته، ويساعد في تشكيل وعيه الاجتماعي والسياسي الذي ينعكس على دوره في المجتمع ومشاركته في صناعة مستقبله وبناء دولته. وقد تنبهت الدول العربية لخطورة التعليم ومكانته ضمن أولويات المجتمع ولو متأخرا بعض الشيء، حيث أصدرت قرارا عن طريق مجلس الجامعة العربية رقم (2443 في عام 1968) والذي تضمن إنشاء لجنة إقليمية عربية دائمة الحقوق الإنسان العربي، وتنمية الوعي بحقوق الإنسان لدى الشعب العربي، وبالأخص حقه في التعليم. وبعد أن أبرزت المادة (26) من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، حق الإنسان في التعليم، وذلك من خلال مبادئ أساسية يمكن أن نجملها في ما يلي[6]:
- مجانية التعليم خصوصا، في مراحله الأولية والأساسية؛
- أن يكون التعليم الأولي إجباريا؛
- أن يكون التعليم الفني و المهني متاحا بشكل عام؛
- أن يكون التعليم للجميع على قدم المساواة؛
وفي هذا الصدد، يشكل التعلم الإلكتروني أحد المداخل الرئيسية لمعالجة اختلالات التعليم ولمواجهة تحديات العصر كتحدي وباء كورونا، ويمثل التعليم الإلكتروني أحد أشكال التعليم الحديث الذي يعتمد على استخدام الوسائط الإلكترونية في العملية التعليمية من خلال تسهيلها وتيسير ولوجيتها لأنه يقوم على إلغاء قيد الزمن وقيد المكان وعدم الالتزام بوقت معين أو مكان محدد إلا في حدود قليلة وضمن شروط معينة، كما أنه يركز على الحس الإبداعي لدى الطالب والتلميذ من خلال التفاعل الإيجابي وتجاوز عملية التلقين التي تعتمد على شحن الطالب بكمية المعلومات التي لا فائدة منها عوض تمكينه من البحث الذاتي عن المعلومة ونقدها وتمحيصها؛ وهو ما يعمل على تفعيله التعليم الإلكتروني، من خلال تحويل العملية التعليمية برمتها من أسلوب التلقين إلى أسلوب الإبداع والابتكار، وهو ما يسهم في تنمية مهارات التفكير، وإنتاج طلبة باحثين أكثر منهم متلقين، مما يزيد في توسيع مفهوم التعليم الذاتي بالاعتماد على طاقاته وقدراته، وسرعة تعلمه ووفقا لما لديه من خبرات ومهارات سابقة؛ وذلك بغية إرضاء الطالب بأن يصبح مطلوبا بعد تخرجه في سوق العمل وإرضاء كافة أجهزة المجتمع المستفيدة من هذه العملية[7].
وعليه، فإن التعليم الإلكتروني يعمل على تحقيق أعلى درجات الجودة من خلال أنه يستجيب للمتغيرات الراهنة في المعرفة التي بات تتجاوز كل ما هو قديم، كما أنه يلبي احتياجات الطلبة والتلاميذ ويتيح لهم جميع الفرص التعليمية على قدم من المساواة خصوصا الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، لأنه من المتيسر اليوم الانفتاح على تجارب أخرى من خلال ما تتيحه الشبكة العنكبوتية، وبالتالي، تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة والبحث والتمحيص والنقد، ما يعزز التعلم الذاتي القائم على أسس نشطة ويعزز القيم الاجتماعية ويسهم في تربية الأجيال وينمي قدرتهم على التواصل مع الآخرين بحيث يسمح التعليم الإلكتروني بإتاحة الفرصة للطلبة للتفاعل الفوري فيما بينهم من جهة وبينهم وبين المعلم من جهة أخرى من خلال الوسائل الإلكترونية مثل حلقات النقاش وغرف الحوار وغيره كما يعمل على نشر ثقافة التعلم والتدرب الذاتيين في المجتمع ويعد الأفراد لتحمل أعباء المستقبل بما يحقق تنمية المجتمع[8].
المحور الثالث: العوائق وسبل تجاوزها
تمثل أول عوائق التعليم الإلكتروني هو نقص التنظيم المنطقي لمجموع المعلومات المتاحة عبر الوسائط الإلكترونية خاصة الأنترنت لأنها تختلف عن أية معلومات مطبوعة أو مكتوبة و إذا أراد المتعلم الحصول على معلومات في موضوع ما قد تكون هذه المعلومات محيرة لأن الشبكة منتشرة في جميع العالم وغير مرتبة منطقيا ومبعثره إلى حد بعيد يصعب على المتلقي خصوصا المبتدئ جمع شتاتها ومعرفة أفضلها. كذلك هناك مشكل قضاء المتعلمين وقتا طويلا في البحث عبر تلك الوسائط عن مواضيع شتى مما يؤدي إلى عدم تركيزهم على الموضوع الأصلي و من خلال البحث في الشبكة يصل المتعلم إلى معلومات قد لا تتفق ومعتقداته الدينية أو القومية وتتعارض مع عاداته وتقاليده، فضلا على عدم وجود جهات قانونية محددة تحكم المعلومات على الشبكة مما يؤدي إلى تعرض المعلومات والمواقع للاختراق والضياع وأن تكون فريسة في أيدي جهات خطره أو عابثه لا تفكر إلا في الربح السريع ولو على حساب المحتوى الملائم لمختلف الفئات والأعمار. كما نجد اختلاط المعلومات على الصفحات من دعائية وثقافية واقتصادية وتعليمية وبالتالي إمكانية تشتيت التركيز على الأهداف الخاصة بالمتعلم وضياعه في محتويات كثيرة وغزيرة قد يخرج منها بدون أي استفادة بل قد تنعكس سلبا على أدائه التعليمي. بالإضافة إلى ذلك، هناك عوائق على المستوى التقني المتمثل في الحاجة لتعلم كيفية التعامل مع هذه التقنيات الحديثة لأنها تتميز بالتغير السريع مما ينتج صعوبة مواكبة التطور السريع لهذه التقنيات، وكذلك ضعف البنية التحتية للاتصالات في بعض الدول مما يؤثر سلبا على الاتصال بشبكة الإنترنت. ولا ننسى كذلك حاجز اللغة، فليس الجميع متمكن من اللغات العالمية الأولى وليس جميع المحتويات متاحة بجميع اللغات، حيث أن اللغة المستخدمة بنسبة كبيرة في المنتجات التقنية والمعلوماتية في شبكة الإنترنت هي اللغة الإنجليزية خاصة في الشعب العلمية. ولاشك كذلك، أن العامل الاقتصادي يبقى من العوائق الأساسية في تبني نظام التعليم الإلكتروني خاصة على المستوى الفردي من حيث القدرة الشرائية لبعض الشرائح المجتمعية التي لا تستطيع شراء المنتجات التي تعرض على الوسائط الإلكترونية ولا دفع بعض الرسوم التي تتطلبها العملية التعليمية الإلكترونية. ولا ننسى، أخيرا، وجود ممانعة من قبل بعض الأطر التعليمية التي تقلل من شأن هذا المنهج الإلكتروني في التعليم وبالتالي عدم التزامهم بما تتيحه أو عدم قدرتهم على دخول هذا المضمار الذي يتطلب كفاءات شابة ملمة بالتطور الحاصل على المستوى الإلكتروني[9].
ورغم الإيجابيات التي يحملها التعليم الإلكتروني للمجتمعات خاصة المجتمعات العربية ومجتمعات الدول النامية، إلا أن قدرتها على استخدام التكنولوجيا وتطوير البرامج التربوية، لا يزال بعيد المنال في أغلب خذه الدول، نظرا لأن أغلب المؤسسات التعليمية عاجزة عن تمويل هذه التكنولوجية المكلفة والباهظة الثمن، وبالتالي تظل أغلب المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات غير مهيأة لاستيعاب هذه الوسائط الإلكترونية، خصوصا وأن استعمالها يحتاج تكوين معين الأمر الذي لا يوجد في أغلب مجتمعاتنا التي تفتقر للعنصر البشري الكفء في هذه المجالات رغم المجهودات المبدولة على هذا الصعيد، ناهيك عن ضعف الاستثمار في مجال البحث العلمي، ولتجاوز هذه العثرات يقترح الباحثون جملة من المعايير والأسس التي يجب التوفر عليها ومن جملتها[10]:
- إصلاح التعليم يتعين أن يتم في إطار تكاملي، ومقاربة شمولية تجمع أجزاءه مع بعض وينظر إليه كوحدة متجانسة؛
- العمل على تكوين عنصر بشري متخصص ينتج لنا خبراء متخصصين في مجال التعليم الإلكتروني من أجل تحسين جودة التعليم ورفع قيمته؛
- تبني منظومة حديثة سواء في الأليات والوسائل؛
- الابتعاد عن التعميم؛
- الاستمرارية والاستدامة كمنهج عمل.
المحور الرابع: الأفاق المستقبلية
كانت البدايات الأولى في استخدام مصطلح التعليم الإلكتروني في منتصف التسعينيات مع التطورات التي عرفها العالم في الاستعمالات المختلفة لشبكة الويب العالمية والاهتمام المتزايد بمجموعات المناقشات غير المتزامنة. وقد كان الهدف من التعلم الإلكتروني هو خلق مجتمع استفسار مستقل عن الزمان والمكان من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمعنى خلق مجتمع استقصاء تربوي من خلال إيجاد مجموعة من الأفراد الذين يشاركون بشكل تعاوني في الخطاب النقدي الهادف والتفكير البناء الواعي لبناء مجتمع علمي قوامه التفاهم المتبادل. وهنا فالتعليم الإلكتروني يعكس بهذا المنظور، نهجًا تعليميًا معينا يستخدم إمكانيات التقنيات الجديدة والناشئة لبناء مجتمعات التعلم البناءة التعاونية.
وإذا كان الأساس الذي يقوم عليه التعليم التقليدي هو الحضور المباشر والتفاعل داخل الفصل بين المعلم والمتعلم، فإن الأساس التكنولوجي للتعلم الإلكتروني هو الإنترنت وتقنيات الاتصال المرتبطة به، حيث يشكل التعليم الإلكتروني شكلا من أشكال التعليم عن بعد نظرا لطبيعته التفاعلية، ورغم ذلك فإنه ليس شكلاً صناعياً للتعليم عن بعد؛ لأن التعلم الإلكتروني العالي هو أولا وقبل كل شيء يسعى توفير تجربة تعليمية جيدة في حين أن التعلم الإلكتروني يحتوي على عنصر من عناصر التعليم عن بعد، لكنه تطور بشكل كبير جعله يراهن على الجودة ويدمج بين النظرية والتطبيق؛ لأن الجودة هي العامل الأهم والحاسم التي تحدد مستقبل التعليم الإلكتروني[11].
لقد أصبح التعليم عن بعد مجرد قيد هيكلي بسيط نسبيا في توفير تجربة تعليمية عالية الجودة وتفاعلية عند ارتباطه بالتعلم الإلكتروني الذي يمثل نموذجا حقيقيا للتحول فيما يتعلق بالتعليم عن بعد. وبالتالي فإنه، يمثل نقلة نوعية للتعليم عن بعد عبر نموذج الاستقلال الذاتي والإنتاج الصناعي لمواد الدراسة المعبأة المميزة للتعليم عن بعد، فالتعليم الإلكتروني يعتبر فرعا تعليميا متميزا له جذوره في المؤتمرات التي تعقد حول الكمبيوتر والأساليب البنائية التعاونية للتعلم. هذا التحول في الافتراضات والنهج التربوية المنعكسة في نظرية وممارسة التعلم الإلكتروني هو حقبة جديدة من التعليم عن بعد توصف بأنها حقبة ما بعد الصناعة للتعليم عن بعد والتي تميزت بالعودة إلى النموذج الحرفي لتصميم خبرات تعليمية تعاونية محددة السياق يدمج فيها التعلم عبر الإنترنت بما يشكله من استقلالية أي التواصل غير المتزامن، مع التفاعل بما يشكله من اتصال الذي يتغلب على قيود الوقت والمكان بطريقة تحاكي قيم التعليم التقليدي، وبالتالي يدمج بين المنهجين للحصول على أرقى درجات التعلم[12].
في نفس الوقت، لكي يتم دمج التعلم الإلكتروني بشكل كامل في التيار الرئيسي للتعليم، يجب ألا نقوض أو نستبعد القيمة الهائلة للتعلم ولا الخبرة التعليمية التي تراكمت عبر كل هذه العقود. إذ لا ينبغي النظر إلى التعلم الإلكتروني على أنه يحل محل هذه التجارب. ومع ذلك، لا ينبغي لنا أن نتجاهل أو نقاوم المزايا الواضحة لتقنيات التعلم الإلكتروني للوصول إلى المعلومات والحفاظ على الخطاب التعليمي. كما لا ينبغي النظر إلى تقنيات التعلم الإلكتروني على أنها تخلق رابحين وخاسرين. فالتعليم الإلكتروني تكمن قوته في المزج بين التجربتين التي تخول احترام المزايا والتفضيلات المميزة المرتبطة بمجتمعات التعلم الحضوري أو التقليدي مع التعرف على نقاط القوة الهائلة للتعلم الإلكتروني ودمجها لتوفير خطاب مستدام وصارم[13].
لتحقيق إمكانات التعلم الإلكتروني كنظام مفتوح ومتماسك، من الضروري أن نعيد التفكير في أصول التدريس بمختلف مناهجه؛ لأن التعليم هو عبارة عن أفكار، وليس مجرد أجزاء معزولة من المعلومات تتم بفصول دراسية أو في قاعات المحاضرات الكبيرة مع إجراء كم من الاختبارات الموضوعية الموحدة على رأس كل فصل، حتى أصبح التعليم يتخذ طابعا صناعيا. حيث أن أغلب مؤسسات التعليم يهيمن عليها التعامل مع تحدياتها المالية من خلال زيادة أحجام الفصول الدراسية دون معالجة قضايا الجودة. في حين أن التعلم الإلكتروني يمكن أن يدعم الممارسات الحالية، مثل إلقاء المحاضرات والتواصل مع الطلبة أو التلاميذ، بل ويعززها بشكل تزامني، وهذا هو التأثير الحقيقي للتعليم الإلكتروني خصوصا في تعجيل مناهج جديدة تتعرف على الإمكانات التعاونية للتعلم الإلكتروني وتغتنمها، لأنه يخلق مجتمع البحث الذي يتم فيه التعرف على الخبرات والأفكار الفردية ومناقشتها في ضوء المعرفة والمعايير والقيم المجتمعية[14].
خاتمة:
في خضم اجتياح وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) للكوكب، انهارت كثير من الأنظمة التي طالما كانت مفخرة للعالم المتقدم، وعلى رأسها النظام التعليمي، إذ بمجرد انتشار الوباء دخلت أغلب المؤسسات التعليمية بحالة من الصدمة والإرباك عرت الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات، وأظهرت مدى تقصيرها وضعفها في مواكبة تكنولوجيا التعليم. ولم يكن من سبيل لتجاوز ذلك التخبط والارتباك إلى اللجوء لتقنيات التعليم الإلكتروني الذي عمل على تخفيف صدمة الوباء.
فالتعليم الالكتروني باعتباره أحد أهم ثمار الثورة المعلوماتية المميزة للعصر الحالي، والتي فرضت واقعا مغايرا بدأت تستعصي خيوطه على الانفصال من خلال التماهي المتزايد بين العالمين الواقعي والافتراضي، خاصة الوتيرة المتسارعة للشبكة العنكبوتية، والنمو المطرد للمحتوى الالكتروني وللذكاء الاصطناعي في المنظومة التي تحكم الحياة اليوم. بشكل أدى إلى تزايد استخدام الوسائط التكنولوجية في طرق عرض المواد التعليمية وتيسير العملية التربوية، ولذلك، يبقى التعلم الإلكتروني نظام مفتوح يمزج بين الوصول إلى المعلومات والتواصل الهادف في مجتمع تعلم ديناميكي ومليء بالتحديات الفكرية التي تفتح لنا أفاق مستقبلية غير مسبوقة.
[1] مزهر شعبان العاني، التعليم الالكتروني التفاعلي، مركز الكتاب الاكاديمي، 2015، ص13
[2] شريف الأتربي، التعليم الإلكتروني والخدمات المعلوماتية، العربي للنشر والتوزيع، 2015، ص17
[3] شريف الأتربي، م،س، ص18
[4] عبدالعليم أبو المجد، قضايا عالمية معاصرة، الجنادرية للنشر والتوزيع، 2012، ص138
[5] مزهر شعبان العاني، التعليم الالكتروني التفاعلي، م،س، ، ص10-11
[6] رافدة الحريري، نظم وسياسات التعليم وتطويرها في دول مجلس التعاون الخليجي، دار اليازودي، 2018، ص54
[7] أحمد إبراهيم أحمد، الجودة الشاملة في الإدارة التعليمية والمدرسية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2003، ص 166.
[8] بوطهرة أسيا، دور التعليم الإلكتروني في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة الجزائرية، مرجع ساب مجلة الدراسات الإعلامية، المركز الديمقراطي العربي، العدد الأول، يناير 2018، ق، ص66
[9] حمزة الجبالي، التعليم الالكتروني مدخل الى حوسبة التعليم، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع، 2016، ص12
[10] سعاد محمد عيد، تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرة، مرجع سابق، ص173
[11] Ulf-Daniel Ehlers، Jan Martin Pawlowski, Handbook on Quality and Standardisation in E-Learning, springer, 2006, p1
[12] Randy Garrison, E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice, Routledge, 2011, p2
[13] Randy Garrison, ibid, p3
[14] Randy Garrison, ibid, p4
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية