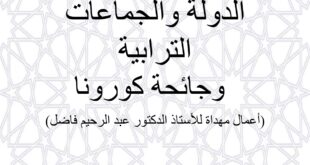مقال تحت عنوان :
“ تطورآليات تنفيذ سياسات الدول الداخلية في مجال حماية البيئة “
إعداد الباحث :
–اناس بندوز
حاصل على الدكتوراه في القانون العام
–جامعة محمد الخامس – الرباط
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية -أكدال-
مقدمة:
أصبحت مسألة حماية البيئة من القضايا المعاصرة التي تطرح نفسها بقوة على الساحة الدولية ، حيث أخذت مشاكل البيئة في السنوات القليلة الماضية حيزا كبيرا ضمن خطط الحكومات والدول وصانعي السياسات العامة، وباتت من اهتماماتها الأساسية في الوقت الراهن للحد من خطورة التلوث الذي تتعرض له البيئة ، نظرا للنهضة الصناعية والتقدم التكنولوجي الذي عرفته المؤسسات الإنتاجية والتي تعد المسؤول الأول عن تلوث البيئة نتيجة لمخلفات العمليات الإنتاجية التي يتم طرحها في المحيط الإيكولوجي أو نتيجة لمنتجاتها التي تؤثر على البيئة أثناء وبعد استعمالها.
ونظرا لهذه الأخطار البيئية التي أصبحت تهدد حياة الأفراد والمجتمعات، فإن دول العالم المعاصر لم تتردد في وضع تشريعات وطنية لحماية البيئة في مختلف قطاعاتها، إلى جانب اعتمادها البرامج وخطط العمل اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها في حدود اختصاصها الإقليمي، وذلك موازاة مع الجهود الدولية التي تنخرط فيها لمواجهة الأخطار البيئية التي تهدد البشرية .
هكذا، اعتمدت الدول والحكومات سياسات بيئية كجزء مهم من السياسة العامة ، تهتم بالوقاية من المشاكل البيئية وتقليل الأخطار الناجمة عنها، ومعالجة الأضرار البيئية القائمة، كما تسعى إلى إيجاد وتطويرالإجراءات والآليات الداخلية الفعالة لحماية صحة الإنسان وحياته ومحيطه من كافة أشكال التلوث.
في هذا الإطار، تسعى هذه الورقة البحثية إلى إبراز الآليات الداخلية لحماية البيئة، أي الوسائل والأساليب التي تلجأ إليها الحكومات لتنفيذ سياستها البيئية الوطنية قصد الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ومن بين أهم هذه الآليات والإجراءات هناك التدابير القانونية والتدابير الاقتصادية ثم المقاربات الطوعية.
إذن، كيف يتم اعتماد آليات حماية البيئة على المستوى الداخلي؟
للإجابة عن هذا التساؤل سيتم التفصيل في العناصرالثلاث التالية:
- أولا: على مستوى التدابير التنظيمية.
- ثانيا: على مستوى التدابير الاقتصادية.
- ثالثا: على مستوى المقاربات الطوعية.
أولا: على مستوى التدابير التنظيمية
تعتمد الحكومات التدابير التنظيمية استجابة للضغوطات المتزايدة للرأي العام وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب البيئة المسماة بأحزاب الخضر التي أصبحت حماية البيئة من أولويات اهتماماتهم، حيث تعتبر الأكثر نجاعة في الحفاظ على البيئة وحمايتها نظرا لطابعها الإلزامي والردعي .
وتتشكل هذه التدابير أساسا من مجموعة من المعايير[1] التي يجب الإلتزام بها وإلا سيتم الوقوع تحت طائلة العقاب المثمتل غالبا في أداء غرامات مالية، وتتحدد هذه المعايير في أربعة أنواع أساسية :
- معايير جودة البيئة : تتحدد تبعا لقدرة الوسط البيئي على تحمل نوع معين من الملوثات مثل الحد الأقصى لتركيز غاز ثاني أكسيد الكاربون في الجو ،أو كأن ينص القانون على وجوب أن لا يزيد تركيز الأتربة العالقة في الجو عن 230 ميكوغرام في المتر المكعب.[2]
- معايير الإنبعاثات : تحدد الكميات القصوى لانبعاث ملوث معين في مكان محدد مثل تحديد قوة الضجيج الصادر من السيارات أو كأن ينص القانون على أن أقصى تركيز من الزئبق يسمح بانبعاثه من عوادم المصانع هو 15 ميكوغراملا في المتر المكعب.[3]
- معايير المنتج: تحدد الخصائص المتعلقة بالمنتج مثل مستوى الرصاص في البترين، أو قابلية الغلاف لإعادة التدوير.
- معايير الطرائق: تحدد الطرق والأساليب التكنولوجية الواجب استعمالها في العملية الإنتاجية مثل أساليب الإنتاج النظيف، أو التي يجب أن تتوفر في التجهيزات التي تستعمل من أجل مكافحة الثلوت مثل المصافي المثبتة في مداخن مصانع الإسمنت ومحطات تصفية الملوثات السائلة.
يعد احترام التنظيمات البيئية لهذه المعايير شرط ضروري لضمان الحفاظ على البيئة ، حيث يهدف التنظيم البيئي بالأساس إلى منع حدوث الآثار الخارجية للإنتاج والتي تضر بالثروة الطبيعية ، ويتشكل من مجموع التدابير المؤسساتية التي تمنع أو تحد من بعض الأنشطة أو المنتجات التي تشكل تهديدا لتوازن الوسط البيئي.
وتصدر جل التنظيمات البيئية على شكل قوانين أو مراسيم بمختلف أنواعها ، ويعتبر الإلتزام بالتنظيم البيئي المحرك الأساسي لأي تقدم في مجال حماية البيئة[4] ، فبعض الدول المتقدمة وضعت تشريعات صارمة في مجال البيئة دفعت بمؤسساتها إلى طلب ملائمة دولية في مجال التشريع البيئي للقضاء على المنافسة الضارة الناتجة عن اختلاف الأعباء التي تتحملها المؤسسات لاستيفاء متطلبات حماية البيئة التي يفرضها المشرع .
ونتيجة لغياب هذه الملائمة الدولية، يشهد العالم حاليا إعادة تموقع الصناعات عالية التلويث والصناعات الأكثر استهلاكا للموارد الطبيعية غير المتجددة والطاقة نحو الدول التي تتميز بتشريعات بيئية أقل صرامة ، وذلك بهدف خفض التكاليف.[5]
فمن خلال تنظيم بيئي رادع، يمكن للحكومات أن تخفز مؤسساتها بطريقة غيرمباشرة للبحث عن أساليب وطرائق إنتاج ذات فعالية بيئية أعلى، لكن هذا التنظيم البيئي لن يكون فعالا إذا كانت قدرة الحكومات على الرقابة ضعيفة ، كما أن المعايير التي يضعها التنظيم تدفع المؤسسات إلى نهج سلوك يلتزم فقط بمستوى الأهداف البيئية الذي تحدده هذه المعايير دون أن تقوم بجهد إضافي في مكافحة التلوث.[6]
ثانيا:على مستوى التدابيرالإقتصادية
يعيب الخبراء الاقتصاديين على التدابير التنظيمية أنها غير فعالة إقتصاديا‘ ويقصدون بذلك أن نفس الأهداف البيئية المرجوة يمكن تحقيقها وبتكلفة أقل على المجتمع بالإعتماد على ما يسمى بـــ ” قوى أوآليات السوق”، ولذلك تعرف أيضا هذه المجموعة من التدابير بالحوافز الإقتصادية أو الأدوات المعتمدة على السوق.
وهناك نوعان من أدوات التحفيز الإقتصادي نتجا عن اختلاف المقاربتين اللتين اعتمدهما كل من الخبيرين الإقتصاديين “بيكو”Pigou و”كواز “Coase.
- مقاربة” بيكو” : الرسوم الإتاوات والإعانات
يركز هذا النوع من التدابير الإقتصادية على الجبايات (الرسوم)، شبه الجبايات (الإتاوات) ثم الإعانات وهي أموال تقدم للمؤسسة لتشجيعها على اعتماد الممارسات النظيفة ،كما يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى أسلوب الإستثمار العام المباشر لإدارة النفايات، مكافحة التلوث أو حماية الموارد الطبيعية، وبسبب الأعباء المالية الكبيرة لهذا الأسلوب، لا يتم اللجوء إليه إلا عندما تعجز الأدوات الأخرى عن حل المشكل.
وتستند فلسفة هذه التدابير إلى مبدأ “الملوث الدافع” والذي يقضي بضرورة دفع الملوث تكاليف إزالة الأضرارالتي تسبب فيها، حيث تقوم الحكومات بتحديد مستوى هذه التدابير وتتدخل باستعمالها في تعديل أسعار وتكاليف الأعوان الإقتصاديين.
فالرسوم تفرض من أجل :
- تمويل تكاليف إزالة التلوث واستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة من خلال الإيرادات المتأتية من فرضها، وهذا النوع يسمى”رسوم التمويل”.
- الخفض المباشر لفارق التكلفة الذي غالبا ما يحد من قيام المؤسسة بنشاطات أقل ضررا بالبيئة ، ويسمى هذا النوع من الرسوم بـ”الرسوم المحفزة في المصدر” وهي أفضل تطبيق لمبدأ”الملوث – يدفع”.
فعلى المستوى النظري ينظر إلى الرسوم على أنها أداة تسمح باستدخال الآثار الخارجية أي أنها تعادل بين التكلفة الخاصة التي يتحملها المنتج والتكلفة الإجتماعية التي يتحملها المجتمع نتيجة التلوث، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يتم تقييم التكلفة الإجتماعية بطريقة صحيحة، أما على المستوى التطبيقي، فإن الرسوم البيئية تهدف إلى تحقيق هدف بيئي بأقل تكلفة جماعية.[7]
ويتم فرض الإتاوات في مجال جمع ومعالجة النفايات ، كما أن استعمال الإعانات المالية من طرف الحكومات يتم بحيطة وحذرشديدين بالنظر إلى إمكانية التعسف في منحها وإمكانية تحويلها عن وجهتها الاصلية .
- مقاربة” كواز”: حقوق الملكية وأسواق التداول
تعتبر البيئة من الناحية الإقتصادية من الموارد المشاع ملكيتها أو المتاحة للجميع ويقال أن الموارد التي يملكها الجميع لا يملكها أحد، ومن تم لا يهتم بصونها أحد.
ويعتقد بعض المتخصصين في الإقتصاد البيئي والسياسة البيئية على رأسهم عالم الإقتصاد الإنجليزي “غاريت هاردن GARRET HARDIN ” في نظريته الشهيرة “مأساة المشاع”[8] التي أطلقها عام 1968، أن الموارد المتاحة للجميع –دون قيود- يستغلها الفرد بشكل أكبر مما لو كانت تخصه لوحده، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهورها السريع ، ومن تم يعتبرون أن تحديد حقوق الملكية والإنتفاع من هذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى حمايتها من التدهور.
وتبقى هذه النظرية محط جدل واختلاف بين علماء الإقتصاد، وقد بينت الباحثة المتخصصة في اقتصاديات البيئة “إلينورأوستروم ELINOUR OSTROM” عام 1990 كيف أن الأفراد الذين يستخدمون الموارد المشاعة ملكيتها يعملون على إقامة قواعد عرفية أو أعراف للحد من المخاطر التي تتحدث عنها نظرية “مأساة المشاع” .
ويعتبر القانون الأمريكي الذي يعرف باسم “قانون حماة أنهر الولايات المتحدة” أحد الأمثلة على تطبيق أساليب تحديد حقوق الملكية، حيث يعطي هذا القانون المواطنين الذين يعيشون أسفل النهر الحق في إنهاء مصادر الثلوت أعلى النهر إذا لم تقم الحكومة بذلك.[9]
يستند هذا النوع من التدابير الإقتصادية إلى إنشاء حقوق ملكية على السلع البيئية أي خوصصة موارد الطبيعة وإحداث أسواق لتداول هذه السلع ، هذا التداول يحدد لها سعرا و قيمة وينظم استغلالها، ومن الأمثلة على ذلك “حقوق رخص التلويث” و”الحصص الفردية للصيد القابلة للتداول”.
يؤدي إنشاء مثل هذه الأسواق إلى تحويل الآثار الخارجية للمؤسسات الإنتاجية لسلعة جديدة وهي الحق في التلويث والذي يهدف إلى توزيع جهود مقاومة التلوث بين الفاعلين المختلفين، في حين تتيح للسلطات العمومية الإبقاء على حد أقصى إجمالي للإنبعاثات الملوثة يتجزأ إلى عدد ثابت من حقوق الإنبعاثات الفردية القابلة للتداول، وتعمل السلطات العمومية على توزيع هذه الحقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها بالمزاد أو عن طريق توزيعها على المؤسسات المعنية حسب إنتاجها، في هذه الحالة، يسمح لكل مؤسسة أن ثلوت في حدود حقوق التلويث التي تملكها ، ويتم معاقبة كل تلويث إضافي إلا في حالة شراء المؤسسة حقوق ثلويت جديدة من مؤسسة أخرى أكثر “نظافة” منها لم تستنفد بعد حقوقها في التلويث.
عندها، وفي منطقة معينة يمكن تعويض ارتفاع درجة تلويث مؤسسة أخرى عن طريق تداول رخص التلويث، أي أن السلطة العمومية تقوم بتحديد حد أقصى لانبعاث الملوثات يجب تحقيقه ، لكن توزيع الأعباء على مختلف الأطراف المعنية يتم من خلال السوق الذي يتم فيه تداول حقوق التلويث.[10]
ثالثا:على مستوى المقاربات الطوعية
تعتبر المقاربات الطوعية الجيل الثالث من آليات السياسة البيئية، وهي عبارة عن مبادرات تسمح للمؤسسة الإنتاجية بإظهار أدائها البيئي الفعال، كما تشجع التنظيم الذاتي للقطاعات الإقتصادية ، ويثمن هذا النوع من الآليات التفاوض والتفاهم بين القطاعات الاقتصادية من جهة والسلطات العمومية – وفي بعض الحالات المنظمات غير الحكومية- من جهة أخرى، ويمكن التمييز بين أربعة أنواع أساسية من المقاربات الطوعية:
1- الأنظمة الطوعية العمومية : هي عبارة عن دفاتر شروط تعدها السلطات العمومية ويمكن للمؤسسات أن تنخرط فيها بشكل طوعي وفردي مقابل الإستفادة من “التوصيف البيئي” أي العلامة البيئية لمنتجاتها، ويمكن لدفاتر التحملات هذه أن تتعلق بالأداء البيئي، التكنولوجيا أو طرائق الانتاج المنتهجة ، كما تمكن “الوكالات الوطنية للمعايرة” المؤسسات التي تستجيب لمتطلباتها من الاستفادة من الاعتراف.
2- الاتفاقيات البيئية المتفاوض عليها بين السلطات العمومية والقطاعات الصناعية: هي عقود تبرم بين السلطات العمومية وقطاع صناعي معين تتضمن الأهداف البيئية الواجب تحقيقها والجدول الزمني لذلك، ويتعهد القطاع الصناعي ببلوغ الأهداف في الآجال المحددة ، وبالمقابل تتعهد السلطات العمومية بعدم إصدار تشريعات جديدة (رسوم، معياربيئي إجباري) وتقوم بمراقبة مدى احترام القطاع لبنود الاتفاق.
3- الاتفاقيات الخاصة بين المؤسسات الملوثة وضحايا الثلوث: هي عقود تبرم بين مؤسسة أو عدة مؤسسات انتاجية وتلك الأطراف المتضررة من انبعاثاتها الملوثة (العمال، السكان، مؤسسات مجاورة، جمعيات محلية ، جمعيات حماية البيئة ، نقابات، تنظيمات مهنية )، وينص العقد على بعث برامج لإدارة البيئة أو وضع آليات لإزالة التلوث.
4- الالتزامات أحادية الجانب للمؤسسات: تتمثل في إعداد المؤسسة الانتاجية لبرنامجها البيئي الخاص بها وإعلام المساهمين، الزبائن المستخدمين والرأي العام بهذا البرنامج ، وتعتبر هذه الالتزامات أحادية الجانب أحد أشكال “التنظيم الذاتي” للمؤسسة ،بحيث تحدد لنفسها معايير وأخلاقيات في التعامل مع مختلف الأطراف تفوق ذلك التي تحددها التشريعات وهي أرقى مراحل النضج الذي يمكن أن تصل إليه المؤسسة.
الخاتمة :
إجمالا يمكن القول، أن كل الآليات الداخلية لحماية البيئة سواء التنظيمية ، الاقتصادية أو المقاربات الطوعية لها إيجابيات وسلبيات تعقد من مهمة السلطة العمومية عند بناء سياستها البيئية، فاعتماد التدابير التنظيمية له ضروراته ومزاياه وأيضا عيوبه أوحدوده، كما أن سن قوانين بيئية جديدة ليس بالأمر الصعب أو المكلف في حد ذاته، وإذا ماتم تطبيقها والالتزام بها يمكن الوصول إلى نوعية البيئة المرجوة، ولكن فرض تلك القوانين هو أمر مكلف وصعب المنال ، فضمان التزام الأفراد والمؤسسات بالقوانين البيئية يعني ضرورة توافر مراكز للرصد والتحليل تضم خبراء مؤهلين وأجهزة حديثة ،ومتابعة دورية لمختلف المؤسسات الصناعية .
وعلى عكس التدابير التنظيمية، فإن للتدابير الإقتصادية هدفا تحفيزيا يدفع المؤسسة نحو انتهاج سلوك مسؤول اتجاه البيئة، وعادة ما تأخذ التدابير الاقتصادية شكل تحويل مالي أو تصحيح للأسعار النسبية ، لذلك فهي تهدف إلى تعديل السلوك البيئي ليس فقط من خلال معاقبة المؤسسات الملوثة فحسب، وإنما تمنح أفضلية لتلك المؤسسات التي تدمج الاعتبارات البيئية في إدارتها لنشاطاتها المختلفة ، ونتيجة لذلك يتم تغيير قواعد المنافسة لصالح الشركات التي تحترم البيئة والتي تتحصل على ميزة تفضيلية أمام الشركات الملوثة.
وبمقابل ذلك، يمكن اعتبارأن المقاربات الطوعية تتميزبزيادة حافزية المسؤولين في المؤسسات لتحقيق أهداف بيئية محددة ، كما تساهم في تسهيل عملية مشاركة المؤسسات والهيئات الممثلة للقطاعات الاقتصادية في إعداد السياسة البيئية للدولة، هذا بالإضافة إلى كونها تسمح لها بالتحقيق السريع لأهدافها.
وتبقى أغلب النقاشات والآراء التي تدعم أو تعارض أي من هذه الآليات تتم على مستوى الطرح الإيدولوجي وليس على مستوى عقلانية وفعالية هذه الأليات، لذلك فبالرغم من كونها تعتبر الوسائل والأساليب الكفيلة بتغيير السلوك، إلا أنه ثبت فشلها عند الإنتقال من المستوى النظري إلى التطبيق في الميدان، وعليه فإن أي سياسة بيئية تتوقف على إيجاد التوليفة الأمثل بين مختلف الآليات المتاحة، والتي يجب أن تتكيف مع الوضع البيئي، الاقتصادي والإجتماعي القائم.
[1] -F. Bonnieux , B. Desaigues , Economie et Politiques de l’environnement , Dalloz, Paris,1998, p: 124-125
[2] – انظر هشام الزيات،” الإدارة البيئية : الإدارة والمفاهيم الأساسية” ، سلسلة عالم البيئة ، جائزة زايد الدولية ،سنة 2010، ص: 78.
[3] – انظر نفس المرجع ص:79.
4- Salamitou J, Management environnemental : application à la norme ISO 14001 révisée, Dunod , Paris ,2004, p:24
[5] – Raspiller S , Riedinger N , ” les différences de sévérité environnemental entre pays influencent-elles les comportements de localisation des groupes français ? ” Economie et prévision, N°169″, paris,2005,p: 197.
[6] – Chiroleu , Assouline M,” Efficacité comparée des instruments de régulation environnemental” , Notes de synthèse du SESP (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire) Paris, 2007, P: 6.
[7] – Beaumais O, Chiroleu Assouline M,”Economie de l’environnement”, Bréal, Paris, 2001,P:78.
[8] – “مأساة المشاع” هو مصطلح اقتصادي يستعمل في معظم الأحيان فيما يتصل بالتنمية المستدامة ،الربط بين النمو الإقتصادي وحماية البيئة ،وكذلك في النقاشات حول ظاهرة الإحتباس الحراري.
[9] – أنظر هشام الزيات،” الإدارة البيئية : الإدارة والمفاهيم الأساسية” ، مرجع سابق ص: 81.
[10] – يشارهنا إلى أن قواعد التوزيع الأولي لحقوق التلويث هي من اختصاص السلطة العمومية.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية