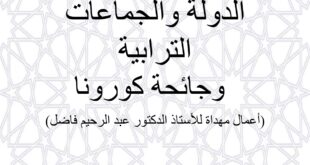التأثيرات المختلفة لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على الجمهور في ظل جائحة كورونا
جاسم محمد البدر
طالب بسلك الدكتوراه
بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي.
ملخص:
لاشك أن جائحة كورونا تعتبر مادة خصبة لوسائل الإعلام، حيث يواجه الناس وفرة من المعلومات من مصادر مختلفة، كثير منها غير موثوق به، بل ويشكل خطرا على الصحة العامة والأمن الاجتماعي، وأصبحت الطريقة التي يتم بها نقل المعلومات الأساسية للجمهور أمرًا بالغ الأهمية. في الواقع، يمكن أن تساعد وسائل الإعلام في تعزيز تغيير السلوك الصحي، خصوصا في المراحل الأولى من الوباء، عندما تكون إمكانية احتوائه ممكنة. لكن في ذات الوقت، يؤدي التأطير الكبير للأحداث المتعلقة بالجائحة وخلق الإثارة بشأنها، والتقارير المكثفة لوسائل الإعلام، إلى الخوف وحتى الهستيريا، مما يؤدي إلى تقليل إمكانية تعبئة الجمهور وتوعيتهم، لإن الاعتماد على المعلومات الشخصية غير الرسمية يؤدي إلى تصاعد التهديد الصحي و ضرب مصداقية الإعلام بجميع مستوياته مما يخلق نوع من الفوضى المجتمعية في تلقي مصادر المعلومة وزرع الشك والريبة في نفوس الناس.
كلمات مفتاح: الإعلام، جائحة كورونا، وسائل التواصل الاجتماعي، الخوف، الصحة العامة.
Abstract
In light of the Corona pandemic, people are facing an abundance of information from various sources, many of which are unreliable, and even pose a threat to public health and social security, and the way in which basic information is transmitted to the public has become critical. In fact, the media can help promote healthy behavior change, especially in the early stages of an epidemic, when the potential for containment is higher. But at the same time, the over-framing and excitement of events related to the pandemic, and intense media reporting, can spark fear and even hysteria, reducing the possibility of crowd mobilization. Conversely, negative feelings can be amplified through prolonged exposure to negative news. The level of trust in information sources also plays an important role in motivating engaging in self-protection behaviors. Therefore, reliance on unofficial personal information increases the health threat.
مقدمة:
إذا كان القانون الدولي “عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم المجتمع الدولي، حيث يتألف هذا المجتمع بالدرجة الأولى من الدول الأشخاص السيدة والراشدة الوحيدة في القانون الدولي. يضاف إليها المنظمات الحكومية الداخلية والمواطنون العاديون وبعض الكيانات غير الدولتية كالشعوب وحركات التحرير الوطنية[1]” فإن مجموع العلاقات الدولية تخضع له، فهذه الأخيرة في أبسط معانيها مجموعة من الأنشطة والتفاعلات والأفعال وردود الأفعال بين مختلف الفاعلين في المنتظم الدولي، سواء كانوا دولا أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية[2].. وهذه العلاقات التي تعبر الحدود القومية للدول تستقطب اهتمام الأفراد والدول والجماعات لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلم وتحقيق الأمن ناهيك عن التعاون الدولي في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية. وهذه العلاقات ما فتأت تزدهر وتتطور بتطور المجتمعات منذ أن وجدت الجماعات البشرية وتنوعت وتعددت، انطلاقا من قيام الدولة المدينة في أثينا إلى العصر الحديث الذي أرسى مفهوم العلاقات الدولية كعلم قائم بذاته.
يشكل الحديث عن الواقع الإعلامي العالمي في ظل العلاقات الدولية بشكل عام، وعن تأثيره في زمن الأزمات بشكل خاص، حديث مثير للاهتمام، فتأثير البعد الإعلامي على الأوضاع الدولية وصياغة الرأي العام بات من الأمور التي تجذب الباحثين والقراء على حد السواء. ولعل ذلك يرجع لما جاءت به الثورة التكنولوجية للإعلام، وما رافقها من تحولات على الصعيد المؤسساتي المصاحب لها، والذي طرح مع نهاية القرن الماضي وقرن الواحد والعشرين مطلع الألفية الثالثة، مسألة المجتمع الإعلامي الكوكبي ومجتمع الاتصال المعرفي.
ومع ظهور الشبكات الاجتماعية ووجودها في كل مكان، لا سيما الدور الذي تلعبه كمصدر للمعلومات في وقت الأزمات والمواقف الحرجة، أصبحت بيئة المعلومات أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ منذ الوباء العالمي الأخير لأنفلونزا H1N1. واليوم، في ظل جائحة كورونا، يواجه الناس وفرة من المعلومات من مصادر مختلفة، كثير منها غير موثوق به، بل ويشكل خطرا على الصحة العامة والأمن الاجتماعي، وأصبحت الطريقة التي يتم بها نقل المعلومات الأساسية للجمهور أمرًا بالغ الأهمية.
في الواقع، يمكن أن تساعد وسائل الإعلام في تعزيز تغيير السلوك الصحي، خصوصا في المراحل الأولى من الوباء، عندما تكون إمكانية احتوائه أعلى. لكن في ذات الوقت، يشكل التأطير الكبير للأحداث المتعلقة بالجائحة وخلق الإثارة بشأنها، والتقارير المكثفة لوسائل الإعلام، يمكن أن تثير الخوف وحتى الهستيريا، مما يؤدي إلى تقليل إمكانية تعبئة الجمهور. وعلى العكس من ذلك، يمكن تضخيم المشاعر السلبية من خلال التعرض المطول للأخبار السلبية، يلعب مستوى الثقة في مصادر المعلومات أيضًا دورًا مهمًا في تحفيز الانخراط في سلوكيات الحماية الذاتية. ولذلك، فإن الاعتماد على المعلومات الشخصية غير الرسمية يؤدي إلى تصاعد التهديد الصحي. وبالتالي، ضرب مصداقية الإعلام بجميع مستوياته مما يخلق نوع من الشك والفوضى المجتمعية.
الإشكالية: ما مدى تأثير وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على خلق نوع من الخوف لدى الناس في ظل جائحة كورونا؟
مسار البحث:
المحور الأول: سطوة الإعلام على المجتمع الدولي
المحور الثاني: تأثير وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع في ظل جائحة كورونا
المحور الأول: سطوة الإعلام على المجتمع الدولي
لقد ارتبط هذا القرن أساسا بالتحولات التقنية الكبرى، التي كرست قيم السوق والليبرالية والخصخصة وغيرها، وأدَّت إلى تشكيل ما اصطُلح على تسميته بنهاية التاريخ[3] ونهاية الجغرافيا ونهاية الايديولوجيا…بانتصار الليبرالية والرأسمالية على قيم اعتبرت في تبعاتها وامتداداتها، تكريسًا لما يبشر به الإعلام بمختلف وسائله باعتباره الحق الذي لا يجب رفضه؛ وهو تأثير غاية في الخطورة خصوصا للدول التي لم تبني مناعة تحمي ثقافتها وخصوصيتها من الذوبان في قيم الغير، حيث يتم عبر سطوة الإعلام، تسليع كل شيء حتى القيم.[4]
ومع بزوغ شمس القانون الدولي لحقوق الانسان بدأت تلوح في الأفق بوادر ظهور فرع آخر، ألا وهو القانون الدولي للإعلام، الذي يعد مشتقا عنه كحق من حقوق الانسان الأساسية في المعرفة وحرية الحصول على المعلومة لتحرص العديد من المواثيق الدولية على التأكيد عليه مع شروع الدول للاعتراف به كمبدأ في دساتيرها وتشريعاتها ليكون مبدأ عاما معترفا به من قبل الدول المتحضرة فمنذ القرن التاسع عشر وخلال الحرب العالمية الثانية مارس الاعلام دورا مهما كان لتطور قواعد القانون الدولي دورا مهما في تطورها وهو ما کرسته الأمم المتحدة منذ عام 1948 في مؤتمرها حول حرية الإعلام، الذي كان يهدف لضمان خلق صحافة حرة دون عوائق لتعمد الأمم المتحدة عام 1950 عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لوضع صياغة جديدة لمشروع اتفاقية حول حرية الاعلام ، التي أقرت عام 1960 مشروع إعلان حرية الاعلام والتأكيد على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان، مع ضمان حرية البحث عن المعلومة، والتأكيد على ضمان الدول لذلك الحق، وعدم فرض قيود عليها، إلا في حدود ضمان حقوق الآخرين واحترامها، وتلبية مقتضيات الأمن القومي والنظام العام في المجتمع لتعود الجمعية العامة مرة أخرى للتأكيد على حرية الإعلام مع التشديد على الممارسة المسؤولة لها، التي تتمثل بجمع ونشر المعلومات بحرية وبصورة مسؤولة وموضوعية وصحيحة، ليعود التأكيد تارة أخرى في الاعلان الصادر عن الجمعية العامة في قرارها المرقم ( 295 ) في دورتها الحادية والستين لسنة 2007، فالإعلام مارس دورا مهما في إيصال المعلومة الصحيحة من مصادرها أو عبر وسائط تتمتع بالمصداقية نقل تلك المعلومة واعتمادها لتوجيه الرأي العام وصناعة القرار وتحقيق التنمية؛ فالاعتراف بالحق في النشر والوصول إلى المعلومة حقان مترابطان يتداخلان في مفهوم واسع وشامل، وهي إحدى أهم مقومات القانون الدولي للإعلام[5].
لقد حملت التغيرات الإعلامية تأثيرات مختلفة علي المجتمع الدولي بمستوياتها ومجالاتها المختلفة، ويصعب تحديد بدقة عن ماهية الأدوار والوظائف المتعددة التي تقوم بها وسائل الاتصال في خدمة النظام السياسي لدرجة تجعل من الصعب علي النظم السياسية أن تتعايش من دون الاعتماد علي وسائل الإعلام في علاقاتها مع باقي الدول تأثيرا وتأثرا سلبا وإيجابا، فالإعلام لم يعد تلك الأداة الطيعة التابعة لجهاز الدولة الرئيسي خصوصا بعد الثورة الرقمية الذي أفلتت الإعلام من عقاله، حيث أصبح الإعلام جراء هذه الثورة يدخل في صميم السياسات الدولية علي المستوي الداخلي والخارجي منذ بدايتها وحتى نهايتها، ويمكننا القول، بنوع من الأريحية، أن الإعلام بات يمثل عصب السياسة، وأصبحت وسائل الإعلام فاعلا أساسياً في المشهد السياسي؛ إذ أنها تمتلك قوة سياسية مؤثرة تتركز في قدرته علي تشكيل رؤيتنا للعالم الذي يحيط بنا وفي تشكيل تفكيرنا حول العالم.
ومما زاد من قوة وسائل الإعلام أن المنظمات والقوى الدولية وجدت نفسها مجبرة علي تشكيل وسائلها وتصوراتها السياسية وعلاقاتها الدولية المختلفة بما يتناسب مع وسائل الإعلام المعاصرة الأمر الذي كان له تأثيره في المدركات والتصورات الجماهيرية، وفي العملية السياسية ذاتها التي انعكست على علاقاتها سلبا وإيجابا، وبالتالي فرض الإعلام سطوة غير مسبوقة على المجتمعات.
لقد ازداد تأثير وسائل الإعلام في صنع القرارات والسياسات الداخلية والخارجية للدول، إذ تشهد الأيام الحالية مؤشرات بنائية قوية علي تجسيد العلاقة الارتباطية بين الإعلام وخلق الأزمات، وترسخ في الوقت ذاته مبدأ الاعتماد المتبادل فيما بين البنيات الإعلامية والبنيات السياسية في المجتمع. كما اشتركت وسائل الإعلام في الحروب النفسية والعسكرية كأداة رئيسية من أدوات المعركة، وأصبح من يملك الإعلام يملك الغلبة في شتى مجالات الحياة، وفي ظل ما يعيشه العالم حاليا من تطورات كبيرة وفي مقدمتها الثورة التكنولوجية والاتصالية الواسعة باتت هذه العلاقة أكثر وضوحا وقوة ولاسيما أن الأنظمة السياسية اعتمدت بشكل كبير على وسائل الإعلام لتحقيق أهدافها وتنفيذ استراتيجيتها علي الصعيد الداخلي والخارجي، وكسب الرأي العام لمصلحتها، كما يعد نظام الاتصال والإعلام الدولي مكوناً أساسيا من مكونات النظام الدولي في عصر العولمة. وتمثل السيطرة عليه أحد الأهداف الاستراتيجية للقوى الكبرى باعتبار أن السيطرة عليه تمثل السيطرة علي أحد أدوات الصراع الدولي فضلا علي أن تطورات النظام والإعلام الدولي تعكس التفاعلات والصراعات الدولية في جوانبها المادية والغير مادية.
ولعل الحديث عن الواقع الإعلامي وتأثيره على المجتمعات في زمن الأوبئة، يبقى حديثا شائكا ومعقدا يصعب فك شفراته بسهولة؛ والسبب يكمن في ما جاءت به الثورة التكنولوجية للإعلام، وما رافقها من تحولات على الصعيد المؤسساتي المصاحب لها، والذي طرح معها العديد من المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإعلام تعبيرا عن حجم وقوة هذه الثورة من قبيل: انعتاق الكلمة، انفجار القلم، وسائل التواصل الاجتماعي، العالم الافتراضي، وهي كلها تصب في ظهور المجتمع الإعلامي الكوكبي ومجتمع الاتصال المعرفي الذي حول العالم ليس كما يقولون إلى قرية واحدة بل إلى غرفة واحدة.
ولذلك، بات من الجميع العمل جنبا بجنب وتكثيف الجهود، على تصحيح الرسالة الإعلامية التي بات تتهدد بفقدان المصداقية في كثير من معلوماتها، خصوصا من خلال سيطرة المنطق التسليعي للمعلومة، والسعي وراء الربح السريع وليس بهدف حمل رسالة وأمانة كشف الحقيقة كما هي. ولذلك، فليس الحل هو فقدان الثقة الكامل في وسائل الإعلام المختلفة، وإنما يجب تأسيس لإعلام حر وتشجيع أقلام صادقة، مقابل سطوة الإعلام الحديث وما يمثله من قوة تأثير على الرأي العام[6].
المحور الثاني: تأثير وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع في ظل جائحة كورونا
الأوبئة هي حالات تفشي واسعة النطاق للأمراض المعدية التي يمكن أن تزيد بشكل كبير من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات في منطقة جغرافية واسعة، وتسبب اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة. وتشير الاحصائيات إلى أن احتمال انتشار الأوبئة قد ازداد خلال القرن الماضي بسبب زيادة السفر والتعاون الدولي. وكذلك، التوسع الحضري، والاستغلال الأكبر للبيئة الطبيعية، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع بل من المنتظر أن يزيدا سوءا.
وفي هذا السياق، فإن فيروس كورونا المستجد (COVID-19) يعد من الأمراض المعدية الذي تم اكتشافها حديثًا[7]، حيث ظهرت حالات لهذا المرض لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019، عندما تم الإبلاغ عن مرض غامض في مقاطعة هوبي بمدينة ووهان، بالصين. وسرعان ما تم تأكيد سبب المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد، وانتشرت العدوى منذ ذلك الحين إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وتم إعلانه مرضًا وبائيًا. نشرت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية معلومات حول الفيروس وقدمت تعليمات مختلفة لمستخدميها حول طرق منع انتشار الفيروس، مثل التباعد الاجتماعي أي الحفاظ على مسافة أكثر من متر بين الأشخاص، وكذلك من خلال استخدام الأقنعة والكمامات، وغسل الأيدي أكثر من مرة في اليوم، وتعقيم الأماكن والأشياء قبل استعمالها. وأصبح الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا لنشر المعلومات، ووسيلة فعالة لمواكبة الكم الهائل من المعرفة الطبية[8].
لقد باتت الجوائح تولد تغطية إعلامية مكثفة، تكثر فيها النشرات الإخبارية على مدار اليوم، وينشط فيها الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب دور وسائل الإعلام الرئيسية، حيث إن الآليات الدولية للمراقبة التي تنظمها منظمة الصحة العالمية مفتوحة الآن لتلقي التنبيهات من هذه الوسائط الجديدة، إلى جانب الاتصالات الصادرة من القنوات الرسمية.
لعبت وسائل الإعلام بجميع أنواعها خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي دورا محوريا أثناء انتشار وباء كورونا المستجد، وقد كان هذا الدور بشكل أقل إبان وباء H1N1 لعام 2009 ، لكنه، مع ذلك لعب دورا سيئا في انتشار المعلومات الخاطئة (التي تم تحديدها بنسبة 4.5%)، حيث أربك المشاعر العامة وأشاع الخوف بين الناس، مما دفع بمنظمة الصحة العالمية أن تعلن أنها لا تكافح وباءً دوليًا فحسب، بل إنها تكافح أيضًا وباءً لا وجود له إلا في الإعلام وخاصة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي سرعت المعلومات الخاطئة والمضللة في جميع أنحاء العالم وأججت من حالات الذعر والخوف بين الناس[9].
وفي هذا الصدد أفادت قناة ABC News باستطلاع رأي قامت به، أنه في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ينتشر القلق بشأن فيروس كورونا بشكل أسرع من الفيروس نفسه، مما يؤدي إلى حالة من الذعر العام في جميع أنحاء العالم[10]. فبعد ظهور فيروس COVID-19 وانتقل إلى دول أخرى خارج البؤرة الرئيسية له، تحول الناس إلى وسائل الإعلام لمعرفة المزيد عن هذا الفيروس في ظل التعتيم الرسمي الذي مارسته بعض الدول على شعوبها. إذ في غضون 24 ساعة فقط، كان هناك 19 مليون إشارة إلى COVID-19 عبر وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في جميع أنحاء العالم[11].
لاشك أن العصر الرقمي اليوم له تحدياته أمام الدول والحكومات خصوصا تلك التي تنعدم فيها الحرية الإعلامية وحرية التعبير، وفي زمن جائحة كورونا زادت حدة التقييد على الحريات العامة وكثرت انتهاكات حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، حاولت السلطات الصينية التعتيم على تفشي الوباء، ومنعت كل ما يتعلق بنشر المعلومات المتعلقة بالوباء، حيث لم يتمكن المواطنون الصينيون من الحصول على حقائق كافية حول الفيروس، ولهذا السبب اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي وشاركوا معلوماتهم وصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على نطاق واسع في صفحات الفايسبوك وتويتر واليوتيوب، ولو أنها، أحيانًا، تتم بشكل غير دقيق. وفي نفس الصدد ، ووفقًا لوثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، فقد عمدت بعض وسائل الإعلام الروسية إلى شن “حملة تضليل كبيرة” حول تفشي فيروس كورونا لإثارة الذعر بين عامة الناس في الدول الغربية[12].
لم تكن تأثيرات وسائل الإعلام على تفشي الفيروس فقط، بل امتدت في بعض البلدان، أن مس تأثيرها الأمن الاجتماعي والغذائي للناس من خلال خلق أزمة الشراء، حيث تهافت الناس على المحلات التجارية لشراء ما يحتاجونه خلال فترة العزل المنزلي؛ وذلك، خوفا من تدابير الحجر الصحي التي أعلنت معظم دول العالم أنها ستفرضها، وبالتالي، إغلاق شامل للمحلات التجارية والأسواق…تطبيقا لحالة الطوارئ الصحية تفاديل لانتشار العدوى الوبائية. حيث نشرت العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، لرفوف المحلات وهي فارغة تماما بعد أن اندفع الناس لشراء وتخزين احتياجاتهم، في حال اضطرارهم للمكوث في المنزل تجنبا للإصابة بوباء كورونا[13]. لقد دفع الهلع من انتشار الفيروس، الناس إلى التهافت على الشراء والتخزين بصورة غير مسبوقة فيها كثير من الجشع والأنانية. ولا شك أن هذه الظاهرة لها عواقب عديدة، منها أنها تتسبب في رفع الأسعار ونقص السلع التي قد يحتاجها آخرون بشدة، مثل الكمامات التي يحتاجها عمال الرعاية الصحية.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر معلومات غير دقيقة على شبكات التواصل الاجتماعي حول انتشار الأمراض سيكون له تأثير سلبي على الصحة العامة والصحة العقلية للأشخاص بوجه خاص (الخوف، القلق، الهلاوس، الوساوس، اضطراب النوم..). فقد شهد المجال العام في القرن الحادي والعشرين تحولًا صارخا في تلقي المعلومة ونقلها واستخدامها، من خلال اعتماد تقنيات الاتصال عبر الإنترنت. وهكذا، أصبحت وسائل الإعلام الجديدة مصدرًا مهمًا للمعلومات الصحية ومنصةً لمناقشة الخبرات الشخصية والآراء والاهتمامات المتعلقة بالصحة والأمراض والعلاج؛ لأن الناس يقضون الكثير من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي وقد يشهدون حالات شراء بدافع الخوف في بلدان مختلفة أثناء جائحة كورونا مما قد يؤدي إلى انتشار حالات من الذعر الجماعية.
لقد سعت السلطات الصينية، عند بداية تفشي وباء السارس، إلى إسكات أي تغطية إخبارية رسمية لتفشي وباء خطير وغير مفهوم داخل أراضي الصين، وكذلك منع تداول الأخبار عن خطورته الفتاكة والتكهنات حول أسبابه المحتملة أو احتمال انتشاره أكثر، وقد سمح سوء التعامل الأولي للوباء بالانتشار دون أن يتم اكتشافه، إلى باقي دول العالم من هونغ كونغ وسنغافورة وكندا وفيتنام، بالإضافة إلى وجهات أخرى، فإن ناقوس الخطر بشأن وجود مرض مميت في الصين قد انطلق من خلال التواصل الشخصي عبر البريد الإلكتروني، من قبل أخصائي طبي متقاعد خاطر بشجاعة بعصيان انتقاد الدولة.
وقد دفعت هذه الأحداث منذ ذلك الحين إلى إجراء مراجعات داخل اللوائح الصحية الدولية (منظمة الصحة العالمية) لتغيير طريقة المراقبة (أي الاستفادة من مجموعة أوسع من المصادر، بما في ذلك المصادر غير الرسمية)، وإدخال واجبات جديدة للدول القومية للإبلاغ الفوري عن تفشي أي مرض إلى المجتمع الدولي.
كما تم أيضًا اختبار الأنماط الجديدة لتفعيل جمع البيانات من جميع المصادر بما فيها التغريدات والمدونات وغيرها من مصادر يمكن اعتبارها مصغرة كوسائل التواصل الاجتماعي بهدف الكشف عن نشوء أزمة في الوقت المناسب تقريبًا. حيث يتم دراسة هذه الوسائط أيضًا من حيث قدرتها على توجيه التدخل في حالة فشل شبكات المساعدة الرسمية وإيصال رسائل الطوارئ الصحية إلى جميع الجماهير كتحليل منشورات الفايسبوك من قبل “مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC”، ومنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، فإن التغطية الإعلامية للصحف (المطبوعة أو عبر الإنترنت) ، وخاصة تلك التي يتم إنتاجها من خلال القنوات الوطنية في الغرب، لا تزال مركزية في تأطير المناقشات العامة والسياسات حول الأمن القومي الصحي وحالات الطوارئ الصحية مثل الأوبئة، لأن التغطية الإعلامية السائدة للأوبئة تهدف إلى إعادة إنتاج مواضيع غير مفيدة، مما قد يقلل من نطاق النقاش العام حول أفضل الاستجابات لتفشي الأمراض المعدية الخطيرة[14].
وإذا كانت وسائل الإعلام تعبر عن سياسة الدولة التي تنتمي لها أو التي تعمل على تمويلها فهي امتداد لسياسة معينة، وبالتالي فالحرية التي تتمتع بها حرية نسبية وليست مطلقة، ولنأخذ مثالا على ذلك، قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية التي قامت بتعليق عمل وكالة رويترز في العراق لمدة ثلاثة أشهر مع المطالبة بالاعتذار عن تقرير نشرته الوكالة وصفته الهيئة بأنه يمثل تهديدا للأمن المجتمعي، الذي يفيد بإخفاء وزارة الصحة العراقية لعدد الاصابات الحقيقية دون الإعلان عنها، وفضلا عن تعليق عمل الوكالة حكم عليها بغرامة تقدر بنحو 20 ألف دولار أمريكي لمخالفتها لوائح البث الإعلامي بنشر أعداد المصابين في العراق بما يخالف ما تعلنه منظمة الصحة العالمية، وهو ما عدته الهيئة عائقا لجهود الحكومة في مكافحة انتشار الوباء مع رسمه لصورة سلبية عن خلية الأزمة، وهو ما قوبل بانتقاد وزارة الصحة لوسائل الاعلام التي تعمد لنشر أخبار كتلك ، لأن ذلك يدفع لعدم الالتزام بحظر التجوال وهو ما يدفع باتجاه زيادة احتمالية زيادة أعداد المصابين وانتشار الوباء بشكل أوسع الأمر الذي يدفع لتحميل الجهات المحرضة للمسؤولية القانونية لنشرها معلومات خاطئة لتعود وزارة الصحة العراقية لتؤكد على أنها تعلن أعداد الاصابات والوفيات بعد تأكيدها من قبل وزارة الصحة في مركز وزارة الصحة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات. وتعلن عنها بشكل شفاف وبشكل يومي ومنذ بداية الأزمة على الاحصائيات الرسمية مع التأكيد بأن الوزارة تطبق المعايير الدولية في تعاملها مع الاصابات والوفيات وحالات الاشتباه بالإصابة.
ووفق لما تقدم، نجد أن المعايير الدولية لحرية الاعلام تتقيد بالحفاظ على حريات وكرامة الاخرين وما يقتضيه النظام العام والمصلحة الوطنية، وهو ما أكدته العديد من المواثيق الدولية والاقليمية عبر بيانها لحدود حرية التعبير فهي ليست مطلقة بل وضعت لها حدود تقف عند المحافظة على مصالح وحقوق أخرى معترف بها محددة قانونا تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية للنظام والأمن العام والصحة العامة والآداب العامة، فالسعي للحصول على المعلومة مفيد بحدود كونها صحيحة وواقعية وغير منقوصة على أن تقدم بموضوعية ودون انحياز، مع ضرورة التقيد بحماية الحياة الخاصة، فنشر معلومات خاطئة خصوصا في ظل حالة الطوارئ أو الكوارث الطبيعية أمر غير مقبول وفيه المساس بأمن واستقرار البلد[15].
كما نجد العديد من العوامل التي تؤثر على التحيز السياسي لوسائل الإعلام، خصوصا تأثيرات أصحاب النفوذ من الاقتصاديين، وبالضبط جماعات المصالح الخاصة والأحزاب السياسية، أو الحكومات وما يمتلكونه من الأليات ومن النفوذ للاستثمار في شركات الإعلام والدعاية السياسية، والمقالات المدفوعة الثمن، والإعانات والرشاوي، بل الأمر يزيد سوءا عندما يتعلق بالبلدان التي ترتفع فيها نسبة عدم المساواة، يحتمل أن تكون وسائل إعلامها قد استولت عليها المصالح السياسية والاقتصادية، وإن ارتفاع التفاوت في الدخل يمكن أن يسهل عملية القبض على وسائل الإعلام من قبل الأغنياء، وإن تأثير الأغنياء على وسائل الإعلام هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تفاوت الدخل، والذي يؤدي كذلك إلى عدم المساواة[16].
لقد ظهر بشكل كبير التهويل والتخويف والقلق التي ساهمت في خلقه وسائل الإعلام حينما تعرض المكسيك في العام 2009 إلى وباء إنفلونزا الخنازير، وكان هو الأشد والأكثر مأساوية منذ ( 40 ) عاما، حيث كان مضمون التغطية التلفزيونية ومضمون الصحف في الغرب خلال فترة الذروة للمرض في ديسمبر 2009 مكثفة ومثيرة للقلق خصوصا خلال المرحلتين الأولى والثالثة من هذا الوباء ، لما أبرزته من ضحايا في الأرواح وخسائر مادية واقتصادية. ليتبين من بعد أن مصادر الأخبار كانت مأخوذة من المسئولين الحكوميين عن الصحة والخبراء وهي السبب وراء اعتماد وسائل الإعلام على التهويل والتخويف والقلق في تغطيتها المكثفة لهذا الوباء[17].
لقد كانت تغطية إنفلونزا الطيور والسارس مثيرة ومقلقة، حيث ركزت على سيناريوهات أسوأ الحالات ومليئة باللغة المشحونة عاطفياً. ومع ذلك، فإن الدراسات حول جائحة H1N1 ووسائل الإعلام تظهر نتائج مريبة وجديرة بالمتابعة. حيث مثلا، أن هناك برنامج إخباري تلفزيوني برازيلي ساهم في “سيناريو الذعر”. كما توصل تحليل للصحف البريطانية إلى استنتاج مفاده أن هناك القليل من الأدلة على “المبالغة في تضخيم” وسائل الإعلام للوباء. في حين أن النغمة العامة كانت محايدة وليست مقلقة، فقد أولت وسائل الإعلام الكثير من الاهتمام للإنفلونزا ، وهذا ما أكدته دراسة أخبار التلفزيون الأسترالي حول الوباء: كانت التغطية بشكل عام، غير مثيرة للقلق، ولكن 63.4 % لجميع البيانات الإخبارية التلفزيونية المتعلقة بخطورة H1N1، أعطت انطباعًا بوجود تهديد خطير. من ناحية أخرى، أظهر تحليل التغطية الصحفية لأنفلونزا الخنازير في أستراليا أن قصة “أنفلونزا الخنازير القاتلة” سادت بمزيج من الرسائل المزعجة والمطمئنة[18].
تلعب كل من السلطات الصحية والخبراء العلميين، أثناء الوباء ، أدوارًا مهمة كمصادر للأخبار، حيث يتمتع الخبراء بإمكانية الوصول إلى المعرفة العلمية، بينما تكون السلطات مسؤولة عن سياسة الصحة العامة. تعتبر المصادر موثوقة ومسؤولة، لأن الخبراء ذوو الرسائل المخيفة أكثر جاذبية لوسائل الإعلام. كما أن علماء الفيروسات، الذين حذروا في حملاتهم وخرجاتهم المنسقة من المخاطر المحتملة لوباء جديد بعد تفشي لأنفلونزا الطيور في عام 2005، يتلقون اهتمامًا إعلاميًا عالميًا. فغالبا ما تختار وسائل الإعلام، بدقة، من أين سوف تحصل على مصادرها، ولكن في تغطية الأخبار والتعامل مع المصادر، يقوم الصحفيون أيضًا بتكييف المصادر وتطويرها.
تهدف وسائل الإعلام إلى تضخيم المخاطر الصحية الجديدة، مما يخلق تصورًا بأن الوباء لا يمكن السيطرة عليه، مما يزيد اهتمام الناس به ويزيد من المشاهدات والمتابعات التي تجعل وسائل الإعلام في ضغط مستمر على الحكومة ومؤسسات الصحة العامة لاتخاذ خطوات جذرية من أجل التعامل مع التهديد المزعوم؛ وهو ما يعطي في نهاية المطاف “تضخيم اجتماعي للمخاطر والأزمات”، حيث تصبح هذه المخاطر الجديدة – بغض النظر عن المخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها – قضية اجتماعية مهمة للغاية، حتى أنها خوف صحي حقيقي. إذا كانت هناك أشياء كثيرة غير مؤكدة وغير محددة، في حال ظهور فيروس جديد، كما هو الأمر مع فيروس كوفيد 19، فستظهر أرض خصبة للوسائط المتعددة وتضخيم المخاطر وإنتاج الأزمات.
والمتتبع لمراحل تطور الوباء يجدها ترتبط بالتطورات في التغطية الإعلامية للوباء فقد حددت بعض الأبحاث السابقة حول الإيبولا والسارس وإنفلونزا الطيور ثلاث مراحل في تغطية فيروس جديد، ولكل منها خطاب مختلف، هذه المراحل هي: “دق ناقوس الخطر” و “الرسائل المختلطة” و “الأزمة الساخنة والاحتواء”. وهو نفس الأمر تم مع جائحة H1N1 في عام 2009: خلال المرحلة الأولى كان هناك (الإنذار) من تفشي المرض، من خلال هيمنة الادعاءات المخيفة على الأخبار مع التركيز على احتمال حدوث تغير في الفيروس وانتشار العدوى. قد تتميز المرحلة الثانية من الاستعداد للأزمة القادمة بمزيج من الرسائل المخيفة والمطمئنة. المرحلة الثالثة، عندما يكون الوباء حقيقة، يتوقع أن يصاحبها خطاب “أزمة واحتواء” يؤكد أن الوضع خطير ولكنه تحت السيطرة[19]. وهذا ينسحب بشكل كبير على جائحة كورونا التي تجاوزت في حجم انتشارها كل الأوبئة التي سبقتها.
إن نقل المعلومات حول المخاطر الصحية ليس بالأمر الصعب، ولكنه، في ذات الوقت، أصبح يخضع لمنطق الربح، فعدم اليقين بشأن التهديد الذي يمثله كوفيد 19 يؤدي إلى تكهنات حول سيناريوهات جد سيئة ، لأنه في المواقف المحفوفة بالمخاطر، تكون حالة عدم اليقين هي المسيطرة باعتبار أن المعلومات الصحية معقدة ومتغيرة بسبب تراكم المعلومات المتزايدة دائمًا. كما لا يمكن الوصول إليها بشكل كامل. ولا يمكن الاستغناء عن المعلومات التي تنقلها وسائل الإعلام، لأن المجتمع يحتاج أيضًا إلى المعلومات الصحية في سياق أوسع، من أجل توجيه سلوكهم الصحي أثناء تفشي الوباء، فتغطية وسائل الإعلام للوباء ومخاطر العدوى يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل تصور الجماهير تجاه الأزمة، مثل ما إذا كان ينبغي اعتبارها وباءً محليًا أو وباءً عالميا[20].
خاتمة:
أظهر وباء كورونا، الحرب التي تشنها وسائل الإعلام على عقول ومشاعر الناس، حرب تستخدم فيها جميع الوسائل والعتاد الحربي الشرعي وغير الشرعي، لتدمير معنويات الإنسان وجعله يفقد بوصلة التفكير الصحيح، فجائحة كورونا أدت إلى موجات إخبارية ضخمة وسريعة التطور تشارك فيها جميع وسائل الإعلام. تستند هذه ما يسمى بالوسائط الإعلامية التي تؤدي بدورها، إلى زخم تفاعلي بين جميع الناس، مما يؤدي إلى إنشاء حلقات تغذية عكسية على مدار الساعة في إنتاج الأخبار.
[1] عائشة واسمين، القانون الدولي العام، مصادره، أشخاصه، مجالات تطبيقه، ط1، 2005، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص15
[2] وهبة الزحيلي، لعلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث، دار المكتبي، 2011، ص 13
[3] طرح نظرية نهاية التاريخ للمفكّر الأمريكي من أصول يابانية فرانسيس فوكوياما.
[4] علي كنعان، الإعلام والمجتمع، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2014، ص79
[5] إيناس الربيعي، الوضع القانوني والمسئولية الإنسانية في مواجهة الوباء الكوفيد 19 نموذجا، مجموعة مؤسسة ومجلة المنشورات القانونية، العراق، ط2، 2020، ص62-63
[6] علي عبد الفتاح، الإعلام الاجتماعي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2014، ص60
[7] World Health Organization. Coronavirus. 2020. URL: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_2 [accessed 2020-04-07]
[8] McGowan BS, Wasko M, Vartabedian BS, Miller RS, Freiherr DD, Abdolrasulnia M. Understanding the factors that influence the adoption and meaningful use of social media by physicians to share medical information. J Med Internet Res 2012 Sep 24;14(5):e117 [FREE Full text] [CrossRef] [Medline]
[9] Wongkoblap A, Vadillo MA, Curcin V. Researching Mental Health Disorders in the Era of Social Media: Systematic Review. J Med Internet Res 2017 Jun 29;19(6):e228 [FREE Full text] [CrossRef] [Medline]
[10] Muwahed J. Coronavirus pandemic goes viral in the age of social media, sparking anxiety. URL: https://tinyurl.com/ybnms2se [accessed 2020-03-14]
[11] Molla R. How coronavirus took over social media. 2020. URL: https://tinyurl.com/ycwtmx3u [accessed 2020-03-12]
[12] Emmott R. Russia deploying coronavirus disinformation to sow panic in West, EU document says. 2020. URL: https://tinyurl.com/yx42jzyh [accessed 2020-03-18]
[13] https://www.aljazeera.net/news/lifestyle/2020/3/12
[14] Elisa Pieri, Media Framing and the Threat of Global Pandemics: The Ebola Crisis in UK Media and Policy Response, First Published December 3, 2018
[15] أيناس الربيعي، الوضع القانوني والمسئولية الإنسانية في مواجهة الوباء الكوفيد 19 نموذجا، م،س،، ص64
[16] ماجد فاضل الزبون، الإعلام الاقتصادي: قراءة في القنوات العربية المتخصصة، العربي للنشر والتوزيع، ط1، 2015، ص55
[17] ماجد فاضل الزبون، الإعلام الاقتصادي: قراءة في القنوات العربية المتخصصة، م،س، ص56
[18] Peter LM Vasterman and Nel Ruigrok, Pandemic alarm in the Dutch media: Media coverage of the 2009 influenza A (H1N1) pandemic and the role of the expert sources, 2013 28: 436 originally published online 10 JuneEuropean Journal of Communication 2013, pp 438-439
[19] Peter LM Vasterman and Nel Ruigrok, Pandemic alarm in the Dutch media: Media coverage of the 2009 influenza A (H1N1) pandemic and the role of the expert sources, 2013 28: 436 originally published online 10 JuneEuropean Journal of Communication 2013, p 440
[20] I Gusti Lanang Agung Kharisma, Framing Analysis of the Kompas’ COVID-19 Coverage: January 2020 Edition, July 2020, Jurnal ASPIKOM, p220
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية