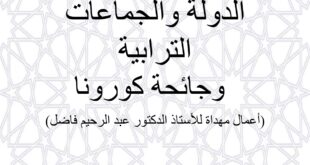استراتيجيات إدارة الأزمات “إدارة أزمة كورونا نموذجا”
عيسى البوعينين
طالب بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي.
ملخص
أدت جائحة كورونا إلى إبراز حجم الأزمة الحقيقية التي يعيشها العالم المتحضر اليوم، من خلال الشلل التام الذي أصاب الحركة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعرف في السابق أكبر اعتقال طوعي للناس في منازلهم عبر إلزامهم بالحجر الصحي الكامل لما يزيد عن ثلاثة أشهر، ما انعكس سلبا على قدرة الحكومات في تدبير الأزمة الوبائية، وقد أظهرت الصين والمغرب تعاملا جيدا في إدارة أزمة كورونا وحدت من انتشارها وأثارها السلبية، من خلال الإسراع باتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية من أجل الحد من تفشي الفيروس وانقاذ الاقتصاد، كالاعتماد على الرقمنة في مختلف المجالات، ومساعدة الأفراد والشركات المتضررة.
كلمات مفتاحية: إدارة الأزمات، أزمة كورونا، التدابير الصحية، التخطيط الاستراتيجي.
abstract
The Corona pandemic has led to highlighting the true scale of the crisis that the civilized world is experiencing today, through the complete paralysis of the economic and social movement, and the largest voluntary arrest of people in their homes was not known in the past by obliging them to complete quarantine for more than three months, which negatively affected the ability of Governments in managing the epidemic crisis, China and Morocco have shown good treatment in managing the Corona crisis and have limited its spread and negative effects, by expediting the adoption of a set of legislative and regulatory measures in order to limit the spread of the virus and save the economy, such as relying on digitalisation in various fields, and helping individuals and companies Affected.
مقدمة:
مفهوم الأزمة من المفاهيم من المفاهيم واسعة الانتشار في المجتمع المعاصر، حيث أصبح يمس بشكل أو بآخر كل جوانب الحياة، بدءا من الأزمات التي يمر بها الفرد، مرورا بالأزمات التي تمر بها الحكومات والمؤسسات، وانتهاءً بالأزمات الدولية[1]، ولذا وجب شحذ الهمم وتضافر الجهود الفردية والجماعية الوطنية والدولية من أجل إدارة سليمة ورشيدة للأزمات التي يمر بها العالم، لأن انعكاساتها لا تكون محلية أو إقليمية ولكنها تشمل مختلف مناطق المعمور.
وفي هذا الصدد يعدّ التخطيط جوهر وقلب ادارة الأزمات، وجميع نماذج إدارة الأزمات تولي عملية التخطيط أهمية كبيرة وتؤكد على أهمية تطوير خطط لإدارة، من خلال استخدام الحكمة والموارد والشجاعة اللازمة من أجل تفادي أثارها الوخيمة، من خلال تفادي صناعة القرارات في ظل بيانات ومعلومات غير كافية، وتحت ضغوط نفسية وعصبية عالية. وتجدر الإشارة إلى أن أحد الأخطاء الكبيرة (المتعلقة بالأزمات) أن يتم التفكير في الأزمة بالاتجاه السلبي فقط، إذ أن هناك جوانب ايجابية في الأحداث الحرجة، وهذا أمر مهم ينبغي إدراكه والتعاطي معه. وعلى الرغم من أنه ينجم عن الأزمة بعض الجوانب الإيجابية، غير أن الغرض الأساسي لعمليات التخطيط لإدارة الأزمة هو تجنب الوقوع في مواقف الأزمات. من جانب أخر، تساعد الأزمة على تبني تغييرات إجرائية جديدة، وتعديل الأوامر التي صدرت في أوقات سابقة[2].
لقد أصبحت إدارة الأزمات سلوكا ومنهجا يحمل في طياته ملامح رؤية للتفاعل والتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة ومع متطلبات التكيف، مع القوى الحاكمة بالرشادة العقلية أو المتحكمة بغطرسة السلطة الإدارية، أو تلك القوى المقامرة والمغامرة التي نصنع الأزمات ونتعامل بها ومعها وفيها، فارضة سطوتها وفارضة جبروتها، لترضي طموحها المادي والمعنوي من أجل إعادة صياغة وتشكيل العالم، ليصبح أكثر انسجاما معها ومع قدراتها. إن هذا ليس مقصودا به قوى محددة بذاتها .. بل إنه أمر ملازم لكل القوى، حتى تلك التي لم تولد بعد. إننا قد نحار في نهم بعض الظواهر المتعلقة بالأزمات ليس فقط لغموضها، بل لما فيها من ضبابية مصطنعة، صنعتها قوى صنع الأزمة لتغطي بها على جانب من جوانبها الحقيقية الخفية والكامنة، بل إن هذه الحيرة أمر ملازم للتعامل مع الأزمات، لما فيها من عوامل و عناصر متلاحقة ومتقاربة يتصارع كل منها ويدفع الآخر دفعا، ويزيحه ليحل محله بسرعة شديدة يصعب معها رصد أي منها ومتابعته إلا من خلال أعين المتخصص الخبير، الذي لديه القدرة على أن يزيح هذه الضبابية المصطنعة، ويكشف عواملها وجوانبها، ويحلل الأزمة إلى أسبابها الحقيقية المحتملة، ويختبر مدى صدق هذه الأسباب والبواعث، ويعرف ويحدد ماهي العوامل المؤثرة الفاعلة، وماهي العناصر المتأثرة المفعول بها؛ ومن ثم التعامل معها بعلمية وعقلانية رشيدة بعيدا عن الانفعال العاطفي المشحون بالتوتر والقلق والخوف معا والذي يحدث نتيجة ضغط الأزمة.
إن الفكر الأزموي قد يحمل في طياته نقصا لا يمكن تجاهله باعتباره علم حدیث .. لم تستقر جميع قواعده ونظرياته ومناهجه … كما أنه لا تزال أسراره الدفينة حبيسة مراكز إدارة وضع الأزمات في الدول الكبرى … إلا أن هذا النقص لن يستمر إلى الأبد ، وهو نقص تكمله التجربة، وتغذیه روافد المعرفة والخبرة والممارسة العملية، وهي عملية مؤكدة الطرح والعرض، وهي بطبيعتها مستمرة باستمرار الحياة، واستمرار نشوء الأزمات، ومن ثم فإن ما هو مقبول اليوم و متعارف عليه ، ليس بالضرورة ملائم للطرح غدا أو بعد غد[3].
إذ أن نجاح الدول والحكومات والمؤسسات، وبمختلف أنواعها يعتمد على قدرتها على مواجهة تلك الأزمات الأمر الذي يتطلب منها العمل على إثبات قدراتها وملاءمتها للتغيرات البيئية المتغيرة باستمرار، وتشكل تحديا لها[4]، ولابد هنا أن نشير إلى أن العامل مع الأزمة منذ البداية بحس نقدي واستشرافي يعطي نتائج محمودة عكس التعامل معها، كما حصل مع أزمة كورونا، بنوع من اللامبالاة يؤدي إلى نتائج كارثية.
ولاشك أن دراسات إدارة الأزمة من منظور شامل، قد تطورت وأصبحت مجالا مشتركا لاهتمام وعمل باحثين وخبراء من مجالات متخصصة مختلفة، تجمع كافة فروع العلوم الإنسانية الاجتماعية والطبيعية[5]. وتعكس الاهتمام الدولي بها ومدى استيعابه لخطورتها، وقد مثلت جائحة كورونا هزة في ضمير المجتمع الدولي واستنفرت جميع مكنوناته العلمية والعملية والنفسية من أجل إدارة هذه الأزمة بما يتوافق مع حجمها وأثارها.
حيث أن ما شهده العالم مع مطلع عام 2020 يعتبر بكل المقاييس كارثة الكوارث الصحية التي سيسجلها التاريخ أبد الدهر لما كان لها من تحديات كبيرة واجهت النظم الصحية على مستوى العالم، ليس على المستوى الصحي فقط، ولكن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي مما سيضطر النظم والحكومات أن تعيد النظر في إعادة هيكلة أنظمتها الصحية وضخ المزيد من الموارد والتقنيات العلمية والعملية لرفع المستويات الوقائية وتجنب الأثار الوخيمة للوبائيات بصفة عامة[6].
لقد كشفت أزمة كورونا التي يمر بها العالم الآن عن عورات النظم الصحية لبعض الدول، وكذلك أظهرت قوة وضعف إمكانيات العديد من الدول في مواجهة هذه الجائحة. فقد ارتجف العالم فجأة في شهر ديسمبر 2019م بعد الإعلان عن وجود فيروس كورونا (كوفيد19) في ولاية ووهان الصينية؛ وتعالت الأصوات والآراء السياسية والعلمية حول هذا الفيروس وقدرته علي إصابة الملايين من البشر، بل وقتلهم. واضطرب الاقتصاد الدولي، وانهارت الكثير من الأسواق؛ وأصيب أكثر من 7 ملايين إنسان حول العالم بالفيروس، وزاد عدد الوفيات عن 400 ألف إنسان حول العالم. وأنفقت العديد من الدول مليارات الدولارات لإدارة هذه الأزمة والتصدي لهذه الجائحة[7].
مشكلة البحث:
إلى أي مدى استطاعت الدول في إدارة أزمة كورونا؟
المحور الأول: الإطار العام لإدارة الأزمات
المحور الثاني: إدارة أزمة كورونا
المحور الأول: الإطار العام لإدارة الأزمات
إن ظاهرة الأزمات، هي إحدى حقائق التي نعيشها بشكل مستمر، منذ فجر التاريخ. وعالم اليوم، يتميز بالمتغيرات السريعة، التي أسفرت عن توترات شتّى، تؤكد اتصافه بالكيانات الكبرى، والمصالح المتباينة والأزمات المتلاحقة التي تعكس نوع من الشرخ الذي يعيشه العالم والذي يحركه صراع المصالح مولدة الأزمة تلوى الأخرى[8].
وعلى الرغم من التقدم الحضاري، وثبات الدعائم والأسس، التي تقوم عليها المنتظم الدولي؛ فإن العالم، يتسم بتعدد الأزمات، التي يواجهها، والناجمة عن اختلال توازنات القوى الكبرى، وتزايد أطماعها؛ مع سعي القوى الصغرى إلى تحقيق مزيد من الاستقلال والنمو؛ ما أدى صراعات عنيفة، وتحالفات متعددة التوجهات. وتمخض ذلك بأزمات، عالمية وإقليمية ومحلية، متعددة الوجوه، ذات طبيعة، زمانية ومكانية، مركبة، ومعقدة[9].
لقد كان تفاعل العلاقات، بين القوى والكيانات المختلفة، وصراعاتها الخفية والعلنية، بهدف نقل مراكز السيطرة والهيمنةـ من عوامل زيادة حدّة الأزمات، إذ بينما تعمل الدول المتقدمة على امتلاك عناصر القوة المختلفة، والارتقاء بوسائلها المادية؛ فإن الدول النامية، تختلف أزماتها، بسبب إفرازاتها المتناقضة، الناتجة من الحقبة الاستعمارية؛ فضلاً عن طموحات الاستقلال والتنمية؛ ما ينعكس على السلوكيات الاجتماعية. وإذا كانت الدول المتقدمة، تتعامل مع أزماتها بمناهج علمية؛ فإن الدول النامية، ترفض إتباع هذه الأساليب، في مواجهة أزماتها؛ ولذلك، تكون تلك الأزمات أشد عمقاً، وأقوى تأثيراً؛ بسبب التفاعل الواضح بين عدم إتباع المناهج العلمية، في التعامل مع الأزمات، بين الجهل بتلك لهذه المناهج، والتمسك بالأساليب، العشوائية والارتجالية؛ ما ينعكس إمكانيات الدولة وقدراتها. وإذا كانت الأزمات، تحدث في كلِّ زمان ومكان؛ فإن العالم المعاصر، بعد أن أصبح وحدة متقاربة، سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً بات يعولم الأزمات، بل يذهب في كثير من الأحيان إلى خلقها من أجل مكاسب مساحات جديدة في ميدان المصالح السياسية والاقتصادية.
ولذلك، أصبح استخدام المناهج العلمية في مواجهة الأزمات، ضرورة ملحَّة؛ ليس لتحقيق نتائج إيجابية من التعامل معها؛ وإنما لتجنّب نتائجها المدمرة. وعلم إدارة الأزمات، يُعَدّ من العلوم الإنسانية حديثة النشأة. وأبرزت أهميته التغيرات العالمية، التي أخلت بموازين القوى، الإقليمية والعالمية، وأوجبت رصْدها وتحليل حركتها واتجاهاتها. ومن ثَم؛ يكون علم إدارة الأزمات، هو علم المستقبل؛ إذ يعمل على التكيف مع المتغيرات، وتحريك الثوابت وقوى الفعل المختلفة، ذات التأثير، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الثقافي. وإذا كان ذلك العلم من العلوم المستقلة بذاتها؛ إلاّ أنه، في الوقت نفسه، يتصل اتصالاً مباشراً بالعلوم الإنسانية[10].
تتعدد أسباب الأزمات بتعدد مسبباتها وتنوّعها. فقد تكون لعوامل، اقتصادية واجتماعية، ناجمة عن ازدياد الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع. وتكون عواملها سياسية، قوامها التفاخر، القومي والديني، في المجتمعات ذات الأعراق والديانات المختلفة، أو الصراعات، الحزبية والثقافية، وعدم السماح لها بالمشاركة السياسية[11].
كذلك، قد يكون سبب الصراع، في مجتمع ما، هو تباين قِيَمه ومبادئه، والذي يؤول إلى تنافر أيديولوجي، بين الطوائف الاجتماعية المتباينة، أو بين نظام الحكم والشعب. وبذلك، تتضح معالم الصراع الداخلي، وتأخذ شكلاً من أشكال المقاومة، حينما تفتقد تسويته الآليات الملائمة، والفاعلة؛ فضلاً عن القدرة على تحقيق التوازن الاجتماعي في الدولة؛ ما يُفْقِد الحكم شرعيته، ويُشعِر أبناء المجتمع بالتمزق، وفقدان الهوية، والاغتراب. وبذلك، تكون الأزمة مرحلة من مراحل الصراع، الذي تتسم به عمليات التفاعل الناشط، أينما وجدت الحياة، وفي أيّ صورة من صورها المختلفة[12].
لقد تطوُّر مفهوم إدارة الأزمات، وبالتالي لم يعد من الممكن تحديد مفهوم دقيق وشامل للأزمة، وخاصة بعد اتساع نطاق استعماله، وانطباقه على مختلف صور العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وفي مجالات التعامل كافة[13]. ومع ظهور أزمة كورونا التي قلبت كثير من المفاهيم وشككت في كثير من التصورات وجعلت منهجنا المعرفي على المحك؛ وأعادت نظرتنا للأزمة ولتصورنا السطحي لها.
وتعني الأزمة تهديداً خطرًا متوقعًا أو غير متوقع لأهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد والمنظمات والدول والتي تحد من عملية اتخاذ القرار[14]. توفي تعريف آخر للأزمة أوردته منى شريف بأنها موقف ينتج عن تغيرات بيئية مولدة للأزمات ويتضمن قدرًا من الخطورة والتهديد وضيق الوقت والمفاجأة ويتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة وسريعة. أيضًا عرّفها عليوة بأنها توقف الأحداث في المنظمة واضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن. من خلال استعراض التعاريف السابقة لمفهوم الأزمة نجد أنها تعني اللحظة الحرجة ونقطة التحول التي تتعلق بالمصير الإداري للمنظمة ويهدد بقائها وغالبًا ما تتزامن الأزمة مع عنصر المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لها[15].
ويستند مفهوم إدارة الأزمات على أسس علمية مدروسة ثابت صحتها وإلى فن ومهارة واجتهاد إضافة إلى خبرة وممارسة ميدانية جيدة.
ويحتاج ذلك إلى تخطيط وتنظيم جيد للمعالجة وقيادة موجه رشيدة ومتمكنة من إصدار التوجهات اللازمة لتحقيق الأهداف مع مراقبة ومتابعة للتنفيذ ولتقويم الخطة أن اقتضت الحاجة.
أنواع الأزمات:
– الأزمات الناتجة عن الاتجاهات العامة في البيئة الخارجية.
– الأزمات الناتجة من خارج المنظمة وليس للمنظمة أي سبب في حدوثها.
– الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والبراكين.
– الأزمات الوبائية.
أولا أنواع الأزمات المحلية:
تعددت الآراء في تقسيم الأزمات المحلية، إلا أنه يمكن تصنيفها في مجموعات متمايزة كما يلي:
(ا) طبقا لتكرار الأزمات : يُعَدُّ التكرر من أهم الأسس في تصنيف الأزمات. وعلى الرغم من أن حدوثها الدوري، يتيح رصد مقدماتها وتجنّبها، فإن أيّ كيان إداري سواء كان فرداً أو مؤسسة أو دولة، لا يستطيع تلافيها، على ما يملك من أجهزة وقائية، ويمكن تقسيمها إلى:
أزمات دورية متكررة: لئن سمح تكرر الأزمات بتوقع حدوثها، فإنه لا يتيح التنبؤ تنبؤاً دقيقاً بمداها وحجمها وشدتها واتساع مجالها، مثل الأزمات الاقتصادية، المرتبطة بالدورة الشرائية والناجمة عن الكساد، والتي قد تنجم، كذلك عن الانتعاش، نتيجة لخلل في قوى الإنتاج.
أزمات غير دورية: وهي تتصف بالعشوائية، ولا يرتبط حدوثها بأسباب دورية، ولذلك، يصعب توقّعها، غير أن المتابعة الدقيقة وملاحظة عوامل نشوئها، يساعدان على تلافيها، مثل الأزمات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية أو تغير الظروف المناخية مثل الأمطار والأعاصير[16].
(ب) طبقا لعمق أسباب حدوثها:
يمكن تقسيم الأزمات، طبقاً لعمق أسباب حدوثها فى الكيان الذي أصابته، إلى نوعَين أساسيَّين، هما:
الأزمات السطحية: و هي أزمات، لا تشكل خطراً، إذ إنها تحدث فجأة، وتنقضي بسرعة، وخاصة إذا عولجت أسبابها. وهي تنجم عن الشائعات الكاذبة، و يمكن القول عنها أنها ازمة بدون جذور،مثل الأزمات التموينية المفتعلة.
الأزمات العميقة : و هي الأشد خطراً،إذ تكون شديدة الضرر والقسوة، لارتباطها ببنية الكيان الذي تعتريه، وقد تدمره إن أهملت مواجهتها
(جـ) طبقا لتأثير الأزمات :
يتفاوت تأثير بتفاوت أسبابها كما يلى:
أزمات محدودة التأثير : و هي وليدة ظروف معينة، ولا يكون لتأثيرها معالم واضحة في الكيان الذي تنتابه، ولذلك فإن مواجهتها تتحقق من خلال تعديل سياساته وأساليب إدارته، مثل افتقاد سلعة تموينية معينة مع توافر بدائلها.
أزمات جوهرية ذات تأثير متسع المجال: يؤثر هذا النوع من الأزمات تأثيراً واضحاً مؤكداً في بنية الكيان الذي يحل به، مما ينعكس على أدائه ويفرض قيوداً على حركته، ويساعد على حرمانه حاجاته و مطالبه الأساسية، التي لا يمكنه الاستغناء عنها. ولذلك، فإنه لا يمكن تجاهل هذا النوع من الأزمات أو إهمال مواجهتها، إذ إن استمرارها قد يسفر عن نتائج صعبة، وقد يلد أزمات أشد خطراً وتدميراً، مثل نقص المياه أو الوقود أو الغذاء[17].
(د) طبقا لشدة الأزمات :
تتراوح الأزمات بين نوعَين أساسيَّين من الشدة والضعف، هما:
أزمات عنيفة: وهي بالغة الشدة والعنف، تؤثر في الكيان الإداري، بل تكاد تدمره، ولا سبيل إلى مواجهتها، غير إفقادها للقوة الدافعة، وتفتيتها إلى أجزاء حتى يمكن معالجة كلِّ جزء على حدة، مثل الإضرابات العمالية والامتناع عن العمل حتى تُستجاب المطالب ما يسبب خسائر ضخمة.
أزمات خفيفة: على الرغم من أنها قد تبدو عنيفًة، إلاّ أن تأثيرها يكون محدوداً، ويسهل معالجته بسرعة، بعد معرفة الأسباب، والكشف الصريح عنها، وقد يُستعان عليها بالجمهور، بتحويله من طرف خصم إلى طرف مشارك وفعال في علاج الأزمة، مثل الأزمات الناتجة من إشاعات خاطئة.
(هـ) طبقا لمستوى الأزمات: يمكن تقسيمها طبقا لمستواها إلى:
الأزمات الشاملة : تصيب الدولة، وتؤثر في المجتمع كلَه فهي أزمات شاملة، سواء في أسبابها ونتائجها، وكذلك متطلبات علاجها، ولهذا النوع من الأزمات تداخلات وأبعاد مختلفة التأثير، مثل الأزمات المتصلة ببنية الدولة وأدائها الاقتصادي و نظامها السياسي، أو وضعها الأمني الداخلي أو الخارجي فضلاً عن سيادتها و استقرارها السياسي والاجتماعي، وهذه الأزمات تتطلب مواجهتها جهداً كبيراً بل تتطلب معونات و دعماً خارجياً أحيانا.
الأزمات الجزئية: تتمثل في أزمات المشروعات أو الوحدات الإنتاجية، وينحصر تأثيرها فيها إلا أنه قد يمتد إلى المشروعات الأخرى المرتبطة بها بل يطاول الدولة برمّتها إن لم يكن السيطرة عليه، وهذا النوع من الأزمات يتميز بالتنوع والتعدد، طبقاً للكيان الذي قد ينشأ فيه، إضافة إلى التأثيرات المتباينة للأزمات، والمتمثلة في عوامل انتشارها وترابطها وتكاملها ونشوئها واختفائها، وفي هذا النوع من الأزمات يجب تدخّل الدولة، لمواجهة الأزمة واحتوائها، إنْ لم يتمكن الكيان الإداري الذي تأثر بها من مواجهتها.
هناك نوعان من أساليب حل الأزمات الأول معروف متداول،ويصطلح عليه بالطرق التقليدية،والثاني عبارة عن طرق لاتزال في معظمها،قيد التجريب ويصطلح عليها بالطرق غير التقليدية:
أولا:الطرق التقليدية: وأهم هذه الطرق[18]:
1. إنكار الأزمة: حيث تتم ممارسة تعتيم إعلامي على الأزمة وإنكار حدوثها, وإظهار صلابة الموقف وان الأحوال على أحسن ما يرام وذلك لتدمير الأزمة والسيطرة عليها. وتستخدم هذه الطريقة غالبا في ظل الأنظمة الدكتاتورية والتي ترفض الاعتراف بوجود اي خلل في كيانها الإداري.
وأفضل مثال لها إنكار التعرض للوباء أو أي مرض صحي وما إلى ذلك.
2. كبت الأزمة: وتعني تأجيل ظهور الأزمة , وهو نوع من التعامل المباشر مع الأزمة بقصد تدميرها.
3. إخماد الأزمة : وهي طريقة بالغة العنف تقوم على الصدام العلني العنيف مع قوى التيار الازموي بغض النظر عن المشاعر والقيم الإنسانية.
4. بخس الأزمة: اي التقليل من شأن الأزمة ( من تأثيرها ونتائجها ). وهنا يتم الاعتراف بوجود الأزمة ولكن باعتبارها أزمة غير هامة.
5. تنفيس الأزمة: وتسمى طريقة تنفيس البركان حيث يلجأ المدير إلى تنفيس الضغوط داخل البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون الانفجار.
6. تفريغ الازمة: وحسب هذه الطريقة يتم إيجاد مسارات بديلة ومتعددة أمام قوة الدفع الرئيسية والفرعية المولدة لتيار الأزمة ليتحول إلى مسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل من خطورته.
ويكون التفريغ على ثلاث مراحل[19]:
أ. مرحلة الصدام: أو مرحلة المواجهة العنيفة مع القوى الدافعة اللازمة لمعرفة مدى قوة الأزمة ومدى تماسك القوى التي أنشأتها.
ب. مرحلة وضع البدائل: وهنا يقوم المدير بوضع مجموعة من الأهداف البديلة لكل اتجاه أو فرقة انبثقت عن الصدام. وهذه العملية تشبه إلى حد ما لعبة البلياردو.
ج. مرحلة التفاوض مع أصحاب كل فرع أو بديل: أي مرحلة استقطاب وامتصاص وتكييف أصحاب كل بديل عن طريق التفاوض مع أصحاب كل فرع من خلال رؤية علمية شاملة مبنية على عدة تساؤلات مثل ماذا تريد من أصحاب الفرع الأخر وما الذي يمكن تقديمه للحصول على ما تريد وما هي الضغوط التي يجب ممارستها لإجبارهم على قبول التفاوض
7- عزل قوى الأزمة: يقوم مدير الأزمات برصد وتحديد القوى الصانعة للازمة وعزلها عن مسار الأزمة وعن مؤيديها وذلك من اجل منع انتشارها وتوسعها وبالتالي سهولة التعامل معها ومن ثم حلها أو القضاء عليها.
ثانيا: الطرق غير التقليدية: وهي طرق مناسبة لروح العصر ومتوافقة مع متغيراته واهم هذه الطرق ما يلي[20]،:
1- طريقة فرق العمل: وهي من أكثر الطرق استخداما في الوقت الحالي حيث يتطلب الأمر وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجالات مختلفة حتى يتم حساب كل عامل من العوامل و تحديد التصرف المطلوب مع كل عامل.
وهذه الطرق أما أن تكون مؤقتة أو تكون طرق عمل دائمة من الكوادر المتخصصة التي يتم تشكيلها،وتهيئتها لمواجهة الأزمات وأوقات الطوارئ،.
2- طريقة الاحتياطي التعبوي للتعامل مع الأزمات: حيث يتم تحديد مواطن الضعف ومصادر الأزمات فيتم تكوين احتياطي تعبوي وقائي يمكن استخدامه إذا حصلت الأزمة. وتستخدم هذه الطريقة غالبا في المنظمات الصناعية عند حدوث أزمة في المواد الخام أو نقص في السيولة.
3- طريقة المشاركة الديمقراطية للتعامل مع الأزمات: وهي أكثر الطرق تأثيرا وتستخدم عندما تتعلق الأزمة بالأفراد أو يكون محورها عنصر بشري.وتعني هذه الطريقة الإفصاح عن الأزمة وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بين الرئيس والمرؤوسين بشكل شفاف وديمقراطي.
4- طريقة الاحتواء: أي محاصرة الأزمة في نطاق ضيق ومحدود ومن الأمثلة على ذلك الأزمات العمالية حيث يتم استخدام طريقة الحوار والتفاهم مع قيادات تلك الأزمات،.
5- طرية تصعيد الأزمة: وتستخدم عندما تكون الأزمة غير واضحة المعالم وعندما يكون هناك تكتل عند مرحلة تكوين الأزمة فيعمد المتعامل مع الموقف، إلى تصعيد الأزمة لفك هذا التكتل و تقليل ضغط الأزمة.
6- طريقة تفريغ الأزمة من مضمونها: وهي من انجح الطرق المستخدمة حيث يكون لكل أزمة مضمون معين قد يكون سياسيا أو اجتماعيا أو دينيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو إداريا وغيرها،ومهمة المدير هي إفقاد الأزمة لهويتها ومضمونها وبالتالي فقدان قوة الضغط لدى القوى الازموية
7-طريقة تفتيت الأزمات: وهي الأفضل إذا كانت الأزمات شديدة وخطرة وتعتمد هذه الطريقة على دراسة جميع جوانب الأزمة لمعرفة القوى المشكلة لتحالفات الأزمة وتحديد إطار المصالح المتضاربة والمنافع المحتملة لأعضاء هذه التحالفات ومن ثم ضربها من خلال إيجاد زعامات مفتعلة وإيجاد مكاسب لهذه الاتجاهات متعارضة مع استمرار التحالفات الازموية. وهكذا تتحول الأزمة الكبرى إلى أزمات صغيرة مفتتة.
8- طريقة تدمير الأزمة ذاتيا وتفجيرها من الداخل: وهي من أصعب الطرق غير التقليدية للتعامل مع الأزمات ويطلق عليها طريقة (المواجهة العنيفة ) او الصدام المباشر وغالبا ما تستخدم في حالة عدم توفر المعلومات وهذا مكمن خطورتها وتستخدم في حالة التيقن من عدم وجود البديل
ويتم التعامل مع هذه الأزمة على النحو التالي[21]:
أ- ضرب الأزمة بشدة من جوانبها الضعيفة.
ب- استقطاب بعض عناصر التحريك والدفع للازمة
ج- تصفية العناصر القائدة للازمة
د- إيجاد قادة جدد أكثر تفهما
9- طريقة الوفرة الوهمية: وهي تستخدم الأسلوب النفسي للتغطية على الأزمة كما في حالات، فقدان المواد التموينية حيث يراعي متخذ القرار توفر هذه المواد للسيطرة على الأزمة ولو مؤقتا.
10- احتواء وتحويل مسار الأزمة: وتستخدم مع الأزمات بالغة العنف والتي لا يمكن وقف تصاعدها وهنا يتم تحويل الأزمة إلى مسارات بديلة ويتم احتواء الأزمة عن طريق استيعاب نتائجها والرضوخ لها والاعتراف بأسبابها ثم التغلب عليها ومعالجة إفرازاتها ونتائجها، بالشكل الذي يؤدي إلى التقليل من أخطارها[22].
المحور الثاني: إدارة أزمة كورونا
إن انتشار الأوبئة والجوائح شكل أزمات دولية خطيرة منذ فجر التاريخ، والذي نعلم منها أقل بكثير مما لا نعلم، فالأوبئة التي تمثل أمراضا معدية، باتت تهدد المجتمعات البشرية وتلقي بظلالها على استقرار الدول واستمرار رفاهيتها[23]، لقد أظهرت جائحة كورونا حجم الأزمة الحقيقية التي يعيشها العالم المتحضر اليوم، من خلال الشلل التام الذي أصاب الحركة الاقتصادية والاجتماعية، ولم يعرف في السابق أكبر اعتقال طوعي للناس في منازلهم عبر إلزامهم بالحجر الصحي الكامل لما يزيد عن ثلاثة أشهر، ما انعكس سلبا على قدرة الحكومات في تدبير الأزمة الوبائية.
لقد جمدت العديد من الحكومات فعليًا النشاط الاجتماعي والاقتصادي في كل أو أجزاء من بلدانها لاحتواء تفشي المرض، وأغلقت الشركات غير الضرورية وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم لأسابيع أو شهور. لا يزال المليارات من الأشخاص في جميع أنحاء العالم تحت نوع من الإغلاق. الصناعات الرئيسية، وخاصة شركات الطيران والقطاعات الأخرى المتعلقة بالسفر، على وشك الإفلاس.
وقد تعاملت الدول مع إدارة أزمة كورونا بكثير من التسرع والعشوائية، نظرا لطبيعة أزمة كورونا الفجائية، التي لم تمهل الدول حيزا زمنيا من التفكير، فكما هو معلوم هناك نوعان من الأزمات النوع الأول هو أزمات متوقعة، نتيجة سوء الإدارة وفساد المقدمات وانحراف واضح ملموس عن الاتجاه الصحيح، فيتوقع الأزمة كل ذي عقل وبصيرة، وهنا يتم تطوير وبناء خطة للطوارئ وكذلك الخطة البديلة fallback plan، والنوع الثاني هو أزمات غير متوقعة وتحدث فجأة مثل جائحة كورونا، فيستلزم الذهاب الى خطة مختلفة عن السابقتين، والتي تعتمد على المعلومات الأولية الواردة، وكذلك مقتضيات العمل علي الأرض، الهدف منها الالتفاف حول الأزمة ومحاصرتها، واحتوائها، وتقليل نتائجها السلبية إلى أدنى مستوى ممكن ويطلق عليها خطة الالتفاف[24].
ولاشك أن التعامل الصحيح مع إدارة خذه الأزمة يؤدي الى نتائج صحيحة، فمن أخذ بالأسباب الصحيحة والمنهجيات العلمية المجربة أو أفضل الممارسات في إدارة مثل هذه الأزمات، استطاع باحترافية شديدة تقليل النتائج السلبية إلى أدنى درجة ممكنة، ومن أغفل هذه الأسباب الصحيحة والممارسات الثابتة، كانت النتائج السلبية عنده عظيمة إن لم تكن كارثية أو شبه كارثية كما حدث بداية أزمة كورونا في إيطاليا وإسبانيا.
والدول التي قامت بالأخذ ببعض من هذه الأسباب الصحية كانت النتائج الإيجابية الصحيحة بنفس القدر تقريباً، مثل ما عملت عليه الصين حيث تعاملت الحكومة الصينية مع تفشي فيروس كورونا باعتباره تهديداً للأمن الداخلي، وليس فقط حالة طوارئ صحية عامة، وحشدت كل أجهزة الدولة على مستوى الحكومة والمجتمع، وبدأت الحكومات في مواجهة الأزمة، وطُلب من المواطنين مراقبة جيرانهم، وزودت شركات التكنولوجيا الصينية الشرطة ببيانات من التطبيقات الصحية التي تحدد إذا ما كان ينبغي عزل المواطنين بالحجر الصحي أو لا، والاعتماد على الفحوصات الواسعة، وتعقيم جميع الأماكن والأشياء، وفُرض حظر على حركة نحو 60 مليون شخص في ووهان من أجل تحقيق الصالح الأكبر والاستقرار الاجتماعي[25].
لقد أخذت الصين بالأسباب الصحيحة والممارسات العلمية الناجحة الثابتة والمجربة في إدارة مثل هذه الأزمات، والتي تعمل وفق مجموعة من المنطلقات والمنهجيات والأدوات، في تسلسل وتنسيق وتكامل واندماج، ووفق رؤية وخطة استراتيجية واضحة المعالم، من خلال عمل مؤسسي فعال.
كما كانت تجربة المغرب ناجحة في التصدي لانتشار جائحة كورونا، لفتت انتباهه العالم[26]، حيث بادرت السلطات إلى اتخاد العديد من التدابير الوقائية والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عبر المرسوم بقانون رقم 20.29.292 الصادر في 23 مارس 2020 الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها[27].
حيث تم تنفيذ الإجراءات بسرعة لتقليل نطاق سلسلة الاحتواء: تم إنشاء “مراكز قيادة فيروس كورونا” على المستويات الإقليمية المناسبة لرصد وتنسيق تحديد الوباء وموقعه مع الخدمات الصحية. وقد تعززت هذه المبادرة بإغلاق الحدود ومنع التجمعات وإغلاق المدارس واتخاذ إجراءات صارمة لتشجيع الإغلاق الطوعي ثم الإجباري.
كما نفذت وزارة الصحة سلسلة من الإجراءات لرفع مستوى يقظتها في مراقبة الوضع الوبائي في الوقت الحقيقي. قامت بتعديل طريقة عملها من خلال إنشاء لجنة استشارية تقنية وعلمية، تتمثل إحدى مهامها في تحديد بروتوكول لرعاية المرضى المصابين بـ Covid-19. في الوقت نفسه، في 25 مارس، تم إنشاء صندوق خاص لإدارة الوباء بقيمة 10 مليار درهم (934 مليون يورو). تم تزويد الصندوق في البداية بموارد الميزانية، ثم تكملته لاحقًا بمساهمات خاصة وعامة، وكان من المقرر استخدامه لتمويل الإنفاق على ترقية الأجهزة الطبية، ودعم الاقتصاد الوطني في التعامل مع الصدمات، والحفاظ على الوظائف وتخفيف الأثر الاجتماعي الوباء. وقادت لجنة مراقبة وزارية مشتركة المكونات الاقتصادية والاجتماعية لخطة العمل[28].
كما منح بدل شهري حتى نهاية يونيو 2020 لموظفي الشركات المتعثرة ، الذين توقفوا مؤقتًا عن العمل والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وهذا يشمل حتى الآن 132 ألف شركة من أصل 216 ألف شركة تابعة للصندوق ، وحوالي 900 ألف موظف. كما تستفيد الأخيرة من التمديدات في سداد القروض الاستهلاكية والإسكانية. تم إجراء تحويلات نقدية إلى 2.3 مليون أسرة تابعة لبرنامج المساعدة الطبية، 38٪ منها من المناطق الريفية. وامتدت هذه التحويلات إلى السكان العاملين في القطاع غير الرسمي وغير المستفيدين من برنامج المساعدة ، أي مليوني أسرة. وبالتالي ، يمكن لـ 4.3 مليون أسرة تعمل في القطاع غير الرسمي الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بجائحة كورونا Covid-19.
وقد اتخذت لجنة المراقبة سلسلة من الإجراءات لصالح الشركات المتضررة من هذا الوباء، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمهنيين العاملين لحسابهم الخاص. وقد منحت تمديدات لائتمانات بنكية وإيجارية (310.000 طلب)، ومنحت تأمين ائتماني للشركات التي تدهور تدفقها النقدي (9000 قرض). وقد ساعدت تدابير أخرى في تخفيف القيود المالية على الشركات: تأجيل الإقرارات الضريبية، وتعليق عمليات التفتيش الضريبي، والإعفاء الضريبي، وتخفيف غرامات السداد المتأخر على العقود العامة، والقروض بدون فوائد لأصحاب الأعمال الحرة. كما أدخلت لجنة المراقبة عدة إجراءات لتسهيل تمويل الاقتصاد من قبل النظام المصرفي من أجل تلبية احتياجات السيولة للشركات. وقد تمت دعوة البنوك لتأجيل المخصصات للقروض التي ستخضع للتعليق واستخدام وسائد السيولة بعد تخفيف النسب الاحترازية[29].
كما عملت الإدارة المغربية على رقمنة بعض الإدارات الوزارية التي جعلت من الممكن ضمان استمرارية الخدمات الأساسية لحياة المواطنين. على سبيل المثال، العمل من المنزل، الدراسة عن بعد، أو الحد من التبادل المادي للوثائق الإدارية والرسمية. دعمت وكالة التنمية الرقمية (ADD) هذه الإجراءات من خلال تطوير منصات رقمية تتوافق مع الممارسات التقنية القياسية في هذا المجال. “بوابة مكتب الطلبات الرقمية”، التي تسهل الإدارة الإلكترونية لتدفقات البريد الوارد والصادر، و “عداد البريد الإلكتروني” بأتممة نظام معالجة البريد داخل إدارة معينة، و “التوقيع الإلكتروني” ، الذي يسمح بإزالة الطابع المادي بالكامل من تدفقات المستندات.
وكان ذلك جلياً من خلال لجوء عدد من القطاعات الحكومية إلى رفع مستوى هذا التعامل من قبيل الجمارك، ومسطرة المشاركة في الطلبات العمومية، والتصريح بالتوقف عن العمل مؤقتاً لدى الضمان الاجتماعي. وعلى مستوى المؤسسة البرلمانية، تم نقل أشغال الجلسات العامة واللجن أيضا عبر تقنية البث المباشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الأمر امتد أيضا، للهيئات المدنية والسياسية، حيث تم تعويض التأطير المباشر بالتواصل عن بعد عن طريق استخدام تقنية البث المباشر، وعقد الاجتماعات بتقنية الفيديو[30].
وختاما، فإن إدارة أزمة كورونا، أبان على اختلاف الدول في إدارة الأزمات، حيث نجد بعض الحكومات كانت الاستجابة عندها سريعة للتعامل مع الأزمة، بينما دول أخرى، كان تعاملها سيء ولم تلجئ إلى التفكير والتخطيط الاستراتيجي لأزمة كورونا، وبالتالي طالت عندها فترة الأزمة، وجاءت النتائج كارثية وغير متوقعة. بينما هناك بعض الحكومات (الصين، سنغافورة، ألمانيا، المغرب، تونس…) كانت استجابتها سريعة للموقف وأحسنت إدارتها وكانت النتائج السلبية على شعبها جيدة إلى حد ما.
[1] اياد نصر، سيكولوجية ادارة الازمات، دار الخليج، 2019، مقدمة الكتاب.
[2] يوسف ابو فار، ادارة الازمات في المنظمات العامة والخاصة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2020، ص13
[3] . محسن الخضري، إدارة الأزمات، مجموعة النيل العربية، ط1، 2003، ص10-11
[4] فادي حسن عقيلان، إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية والغير طبيعية، دار المعتز، 2015، ص210
[5] عبد الكريم أحمد جميل، إدارة الأزمات و الكوارث، الجنادرية، 2016، 35
[6] ضياء السبيري، مصر في زمن الوباء، بوك تيك، 2020، ص7
[7] نبيل البابلي، إدارة أزمة كورونا ـ أسباب النجاح والفشل، المعهد المصري للدراسات، يونيو 2020
[8] ماركو ساسولي . مسؤوليه الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني .المجلة الدولية للصليب الأحمر . مختارات من أعداد 2002 . صـــ236 .
[9] حماد، كمال .النزاع الدولي المسلح والقانون الدولي العام .تقديم ديب، جورج . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .الطبعة الأولى .بيروت .لبنان . 1997، ص34
[10] سهيل حسين الفتلاوي .عماد محمد ربيع . القانون الدولي الانساني .دار الثقافة .عمان الاردن .الطبعة الأولى .2007 ، ص87
[11] الجندي ، غسان . المسؤولية الدوليه . بدون دار نشر . الطبعة الأولى . 1990 ، ص56
[12] أبوزينة، آمنه محمدي .آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني . دار الجامعة الجديدة .الإسكندرية .مصر . 2014، ص35
[13] ثامر كامل الخزرجي، العلاقات السياسية الدولية وإستراتيجية إدارة الأزمات، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 2009.
[14] قحطان حسين طاهر، “ماهية الأزمة الدولية..دراسة في الإطار النظري”، مجلة العلوم السياسية، ع.42، جامعة بغداد.
[15] عباس رشدي العامري، إدارة الأزمات في عالم متغير، القاهرة: مؤسسة الأهرام، 1993.
[16] عليوة السيد، إدارة الأزمات و الكوارث: مخاطر العولمة والإرهاب الدولي، ط.2، القاهرة: دار الأمين للنشر و التوزيع، 2002.
[17] ثامر كامل محمد الخزرجي، العلاقات السياسية الدولية وإستراتيجية إدارة الأزمات، الأردن: دار مجدلاوي للنشر و التوزيع، 2005.
[18] خليل عرنوس سليمان، “الأزمة الدولية و النظام الدولي: دراسة في علاقة التأثير المتبادل بين إدارة الأزمات الإستراتيجية الدولية و هيكل النظام الدولي”، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، 2011.
[19] نفسه
[20] حسين قادري، النزاعات الدولية: دراسة و تحليل، باتنة: منشورات خير جليس، 2007.
[21] مصطفى بخوش، ماهية الأزمة الدولية، محاضرة مقدمة في مقياس إدارة الأزمات الدولية (غير منشورة)، جامعة بسكرة، 2015-2016.
[22] علي بن هلهول الرويلي، الأزمات: تعريفها، أبعادها، أسبابها، حلقة علمية خاصة بمنسوبي وزارة الخارجية “إدارة الأزمات”، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية التدريب، 2011.
[23] Stenseth NChr et al, Plague: Past, Present, and Future. PLOS Medecine, 2008, p 5
[24] نبيل البابلي، إدارة أزمة كورونا ـ أسباب النجاح والفشل، م،س.
[25] الصين تملك مفتاح إدارة حالة الفوضى الناجمة عن فيروس كورونا، مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ماي 2020
[26] https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/4/%D8%A7%
[27] الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، 29 رجب 1441 الموافق ل 24 مارس 2020 ص1782
[28] Larabi Jaidi, Coronavirus and Africa – Morocco, a Model in Crisis Management?, https://www.institutmontaigne.org/en/blog/coronavirus-and-africa-morocco-model-crisis-management
[29] Larabi Jaidi, Coronavirus and Africa – Morocco, a Model in Crisis Management?, https, ibid.
[30] https://www.amadeusonline.org/publications/analyses-covid-19
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية