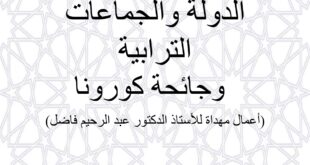العملية الديمقراطية في المغرب بين الفكر والممارسة:
علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني نموذجا
سيدي مولاي أحمد عيلال،
باحث أكاديمي بجامعة عبد الملك السعدي، طنجة
اتفق أغلب الباحثين على أن الفكر السياسي كفكر إنساني هو وليد واقع موضوعي وذاتي من خلال عملية تفاعلية بين المفكر ومحيطه، على هذا الأساس تأتي أهمية دراسة الفكر السياسي المغربي المعاصر وما ارتبط به من مفاهيم، لمعرفة مدى عكسه للواقع المغربي ومدى مشروعية التحدث عن فكر سياسي مغربي، وذلك بالاعتماد على التراث الفكري لمجموعة من رواد النخبة المغربية التي برزت بثقلها في الساحة السياسية قبل وبعد الاستقلال.
وكان لزعماء الحركة الوطنية المغربية تصورات خاصة عن الإصلاح السياسي وعن النموذج الدستوري المقترح لتنظيم السلطة، نجم عنه ظهور بعض التباينات بينهم والقصر من جهة، وبين رواد الحركة أنفسهم من جهة أخرى، غير أن التوجه العام كان يسير في اتجاه اعتماد نظام سياسي ودستوري حديث في إطار ملكية دستورية.
فلقد حظي موضوع الإصلاح السياسي والدستوري عند كل من علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني كنموذجين لهذا الفكر بأهمية خاصة، حيث طالب كل منهما بإرساء ملكية دستورية والحد من الحكم المطلق، مع تباين في معالجتهما للإشكاليات المتصلة بالإصلاح. إذ انتقل علال الفاسي من الدفاع عن فكرة “مجمع شعبي منتخب” إلى القبول بأطروحة المؤسسة الملكية المتعلقة بالاستفتاء الدستوري، في مقابل محمد حسن الوزاني الذي طرح مفهوما متطورا لإصلاح النظام السياسي بالمغرب ووضع الأسس القانونية والسياسية لنظام ملكية دستورية تسود ولا تحكم.
هذا الاختلاف الفكري، أدى بتبني كل منهما نظرية خاصة بالديمقراطية، فبينما وظف كل منهما مفهومها بما يرتبط بها من قيم كالحرية والمساواة والعدالة والشورى والدستور، ينظر إليها محمد حسن الوزاني من أعلى (القمة) مقابل رؤية علال الفاسي التي ترتكز على تطبيقها من أسفل (القاعدة).
فما القصد إذن بالديمقراطية في سياقها التاريخي؟ وكيف أسس لها علال الفاسي فكرا وممارسة؟ وعلى ماذا اعتمد محمد حسن الوزاني لتجليها ضمن النسق السياسي المغربي؟ وكيف وظفاها في سياقاتها السياسية وبخاصة بعد استقلال المغرب؟
هذه الأسئلة ستتم مقاربتها وفق الآتي:
أولا: مفهوم الديمقراطية
تعني الديمقراطية في أصلها لدى اليونان حكم الشعب، أو كما قال ابراهام لنكولن حكم الشعب من قبل الشعب ومن أجل الشعب، وهي وليدة تحولات طويلة الأمد، عميقة الغور تتجذر مع تقدم المجتمع وتتطور مع تطور المجتمعات فتتكيف مع التحولات الاقتصادية والثقافية[1].
وتعرفها الموسوعة السياسية بأنها حكومة الشعب، أي اختيار الشعب لحكومته وغلبة السلطة الشعبية أو سيطرة الشعب على هذه الحكومة التي يختارها[2]، بمعنى أنها نظام من أنظمة الحكم الذي تكون فيه سلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس[3].
ويعرفها أرسطو بأنها “نظام سياسي يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه، شرط أن يكون هذا النظام خاليا من الشوائب وعلى أساس وعي الشعب وتفهمه لحقوقه وواجباته..، والتحرر من تأثير الغوغائيين والدجالين المضللين”.
أما جان جاك روسو فيعلن أن الديمقراطية الحقيقية هي “حكم الإله لا حكم الشعب”، في حين لخص توماس جيفرسون فكرة الديمقراطية بقوله “إن الناس خلقوا متساويين، فقد وهبهم الله حقوقا فطرية لا يمكن التنازل عنها، وهي تشمل حق الحياة والحرية في طلب السعادة، ولتأمين هذه الحقوق ظهرت الحكومات بين الناس واستمدت سلطتها العادلة من موافقة المواطنين، ومن حق الشعب أن يغيرها أو يلغيها إذا تعارضت مع هذه الأهداف، وأن يقيم حكومة جديدة تستند أسسها إلى هذه المبادئ، بحيث يرى الأفراد أن الغاية منها هي تأمين أكبر قسط ممكن من أمنهم وسعادتهم”[4].
ولقد حظيت الديمقراطية في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 باهتمام فئة من مثقفي الطبقة الوسطى، الذين أرادوا تحدي سلطة الملكية والكنيسة بشرعية الشعب، فحاولوا التوفيق بين فرضيات القرن الخامس قبل الميلاد وواقع أوربا في عهد الثورة الصناعية ليخلصوا إلى وضع صورة جديدة لديمقراطية معاصرة تتغاير في أصولها مع الديمقراطية اليونانية[5].
الديمقراطية إذن، كانت في العصور القديمة تعني السيادة الكاملة للشعب دون أن يساهم كل أفراده في الحياة السياسية. وفي العصور الحديثة تأسست على ركيزتين أساسيتين هما الحرية والمساواة، وجدت الأولى أساسها في الديمقراطية الليبرالية، في حين الديمقراطية الماركسية تعتبر مرجعية للثانية[6].
إن أصل الحديث عن الديمقراطية ووجودها في المجتمعات العربية مثل ما هو الحال عليه في المجتمعات كافة، هو تأسيس الشرعية، أي انبثاق السلطة عن الجماعة الوطنية عامة، باعتبار أن ذلك هو القاعدة الشكلية لتأمين اتفاق قيم ومعايير السلطة وممارستها مع قيم ومعايير المجتمعات التي تخضع لها، وبهذا فإن الشرعية تؤلف الضمانة لانسجامهما وتوافقهما ومن ثم مصدر الاستمرارية والتداول السلمي للحكم وبالتالي مصدر وجود الدولة[7]،
ولكن ذلك يحتاج إلى دستور يرتكز على مبدأ العقد الاجتماعي[8]، حيث يساهم المواطنين في إعداده وإقراره إما بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة أو من خلال استفتاء دستوري[9]. إذ أنه لا تتحقق الديمقراطية كفكرة ومشروع إلا حين تتوفر المقومات الضرورية المتمثلة في دولة القانون والمواطنة[10]، وتنقسم الديمقراطية إلى ثلاثة أنواع:
- الديمقراطية المباشرة: تعتبر النموذج المثالي للحكم الديمقراطي، ذلك أن الشعب هو الذي يمارس السلطة بنفسه ودون اللجوء إلى وسيط،
- الديمقراطية شبه المباشرة: تقوم على أساس مبدأ التمثيل من جهة، ومن جهة أخرى مشاركة الشعب في اتخاذ القرار بنفسه، ويقوم هذا النوع على المزج بين نظرية السيادة الشعبية والسيادة الوطنية،
- الديمقراطية النيابية: تعني ممارسة الأمة السيادة بواسطة نواب تنتخبهم لهذه الغاية يؤلفون البرلمان سواء كان مكون من مجلس أو مجلسين[11].
ثانيا: الفكر الديمقراطي عند علال الفاسي وأبعاده السياسية
- الديمقراطية في فكر علال الفاسي
تميز علال الفاسي بالمزاوجة بين الثقافة الفقهية والاطلاع على أدبيات الفكر الأوربي[12]، كما ساهمت الدروس السلفية التي تلقاها على يد بلعربي العلوي -نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات-في بناء الوعي السياسي لديه، ومن ثم تحديده للديمقراطية من منطلق أن الحكم يُعد وسيلة لتحقيقها بالمجتمع، نتيجة لما تمنحه للفرد من حق في الحرية والعمل والتعليم والصحة..، إلى أن تمتد إلى خلية التشريع والدفاع عن مصالح المجتمع ككل بالرقابة على الحكم فيه[13]. ويلح في هذا السياق إلى أن الديمقراطية قرينة بالحرية، لأنها مبادئ وعقائد دينية ودنيوية غايتها العدل والصدق[14]، وتعني بذلك حق الاختيار في إطار الحوار والعمل الهادف من أجل رفع مستويات الإنسان –المواطن-[15].
وقد أولى علال الفاسي عناية بهذه المبادئ والقيم باعتبارها ثوابت في الشريعة الإسلامية، مؤكدا على أن الحرية وكل ما يرتبط بها يجب أن يرتكز على أسس قويمة لقيام الديمقراطية، فتحدث عن طبيعتها ومجالاتها وعلاقاتها بالدين والحقوق والأخلاق وعن الوعي بها والإرادة في التمتع بها والدفاع عنها.
فمن طبيعتها، يقول – علال الفاسي-في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، أن “الحرية لا تعني أن يفعل الإنسان ما يشاء ويترك ما يريد، ولكنها تعني أن يفعل ما يعتقد أنه مكلف به وما فيه الخير لصالح البشر، لأنها في آخر المطاف خلق وليست غريزة”[16]. وعليه فإن الديمقراطية الصحيحة “تخضع فيها الأقلية لرأي الأغلبية من غير تأثير، والفكر العام المتحرك عامل أساسي في النظام الديمقراطي الذي يستند على تأييد الشعب الاختياري، ومن أجل ذلك فإن في مقدمة المظاهر الديمقراطية، العمل الجدي لتنوير الرأي العام وإصلاح ما فسد منه ومقاومة كل ما يمنعه من التطور والعمل بوسائل التقدم”[17].
وفي حديثه عن النظام الديمقراطي في الإسلام، أدرج في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية “أن المجتمع الإسلامي يقوم على أساس العقيدة الإسلامية والأخلاق الدينية ومقاصد الشريعة في حفظ المقومات الإنسانية التي تؤول إلى العقل والدين والمال وحفظ الأجسام..، وتنظيم هذه الأسس في قواعد عامة تتغلغل في أعمال الإنسان وتصرفاته سواء حينما يخلو إلى نفسه كفرد أو حينما يكون جزءا من جماعة أو جزءا من المجموع كالأمة والدولة[18]. وعلى أساس ذلك، أقر بأن الديمقراطية في الإسلام مرتبطة بالإيمان والعدل والإحسان، وممارستها حق لكل إنسان وواجب عليه لارتباطها بالاستخلاف والمسؤولية الفردية والجماعية[19].
- تجليات العملية الديمقراطية في سياق الممارسة السياسية
يوضح علال الفاسي المنهجية المقترحة للتعامل مع إشكالية التجديد بمعناها العام والذي يمس مختلف المجالات المعرفية، وما يرتبط به من مفاهيم كالدولة والسلطة والدستور وسبل تنظيم التعايش بين الدولة والمجتمع، بحيث عبر عن ذلك بالقول: “..إن من واجب الذين يعملون لصالح أمتهم أن يدرسوا مجتمعهم المغربي من جميع نواحيه، ثم يحتفظوا بالأسس الصالحة فيه، ويهدموا ما تراكم عليها من أطلال وأنقاض، وبعد ذلك يرممون الأسس ويبحثون عن المادة الصالحة للبناء، ويتقدمون للعمل فيشيدون بناء عصريا شامخا على أسسهم الدينية والقومية التي لا تضعف قواها أبدا”.
فاعتبر أن الدستور يعد مظهرا من مظاهر سلطة الأمة ورقابتها على حكومتها[20] المرتكزة على أسس صحيحة تؤدي إلى انبثاقها من أغلبية برلمانية منتخبة انتخابا حرا وسليما يكرس سيادة الشعب على الحكم، والذي لن يتأتى إلا بإيجاد تنظيم عام للشعب يوازيه تنظيم الهيئات النيابية التي تمثله[21]، مما يزيد النظام الملكي تثبيتا في مركزه المؤسس على ملكية دستورية تنظم الشورى الإسلامية بما يوافق شروط التطور الدستوري ومعطيات الرقابة الشعبية على السياسات العامة[22] التي تعزز الأساس الديمقراطي للمغرب بنظام برلماني[23].
بناءا على هذا التأسيس، قدم علال الفاسي عدة انتقادات حول طبيعة الحكم الذي سار عليه المغرب، حيث اعتبر بأن “المغرب ما يزال لحد الآن في أنظمته العتيقة، وعلى الرغم من رغبة الملك وطموح أمته لنيل الحياة النيابية التي تيسر لها سبيل الإعراب عن وجهة نظرها والمراقبة على سير شؤونها فإن البلاد ما تزال ترزح تحت ثقل نظام من العصور الوسطى تدعمه إقطاعية جديدة يأبى بعض الناس إلا دوامها”[24].
وأكد على مسؤولية الفرد الكبرى في إقرار النظام الديموقراطي، حيث قال بأنه “لا يصح أبدا أن يتخلى فرد من أفراد الأمة عن العمل السياسي عن طريق مراقبة السلطة وأعمالها، والذين يغيبون في الانتخابات مــثلا، يعتبرون أخلاقيا مقصرين في أداء ما فرض عليهم، وبالتالي مسؤولين عما يترتب على تقصيرهم من عبث أو استغلال أو خيانة كبرى”[25].
إن علال الفاسي وهو أحد الأقطاب المعروفين في المشهد السياسي المغربي حينها، رسم -في كتابه “الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (1948)”- الإطار المستقبلي لتوزيع السلطة وتنظيم ممارستها، حين اعتبر “دستور الجمهورية الريفية حدثا مؤقتا مَكَّنَ أصحابه من تنظيم الإدارة وتدريب الجمهور على أن يحكم نفسه بنفسه، ومتى تم التحرر الكامل لسائر أبناء الوطن سلموا البلاد المحررة لصاحب العرش ولم يطالبوا بأكثر من تطبيق نظام دستوري يحقق رغبات الشعب في مراقبة أعمال الدولة والتعاون على تسييرها[26].
وبالرغم من أن علال الفاسي كان يطالب في الدرجة الأولى بالاستقلال وتأجيل مهام الإصلاح الدستوري إلى أن يتحقق الاستقلال، فإنه أثار قضية السلطة التأسيسية منذ عهد الحماية، حيث دعا إلى ضرورة توفر البلاد على “دستور ديموقراطي يعترف بحقوق الإنسان والمواطنين ويراعي في وضعه ما تتوقف عليه حياة المغاربة وحاجياتهم”. إلا أنه بعد الاستقلال انتقل موقفه من الدفاع عن فكرة “مجمع شعبي منتخب” إلى الاقتناع بأطروحة المؤسسة الملكية من مسألة وضع الدستور وتبنيها مع القبول بالاستفتاء الدستوري[27]، حيث أكد بأن “المجلس المنتخب أو مجلس الدستور المعين يؤديان معا إلى مكة”، اعتبارا منه لأن “تسييس قضية الدستور ليس من مصلحة المغرب، ما دام الشعب والملك متفقين على إنجازه سيما وأن الاستفتاء الشعبي من الطرق الشائعة في كثير من الدول الديمقراطية”[28]. وذلك بعد الانتقادات التي وجهت له على إثر تعيينه رئيسا للمجلس التأسيسي المعين من طرف الملك، والذي بَرَّرَهُ “بحالة المغرب التي لم تكن تسمح بالاختيار، لكون الرغبة في الخروج بالبلاد من حالة الحكم المطلق إلى حالة الحكم الدستوري أهم مما لا يستوجب الإلحاح ما دام الملك والشعب مقتنعين بضرورة إقرار الحياة النيابية قبل كل شيء”[29].
ومن هذا المنطلق المؤدي إلى التعبير عن مرونة موقف علال الفاسي النابعة من قناعة سياسية حول المكانة الجوهرية التي تحتلها المؤسسة الملكية داخل النسق السياسي[30]، يرى بأن المسؤولية الوزارية والحكومية لها إيجابياتها على نظام الحكم[31] من خلال:
- إضفاء نوع من الاستقلالية للجهاز الحكومي،
- إشراك الوزراء في عملية اتخاذ القرارات السياسية،
- إشعار الوزراء بتحملهم للمسؤولية السياسية[32].
وفيما يخص المشاركة السياسية للشعب، فقد اعتمدت عنده على مفهوم مركزي تأسس على وجود الجماعة التي هي عبارة عن جمعية منتخبة محليا تملك كل المقومات الاجتماعية والاقتصادية للتأثير في قرارات السلطة المحلية وكذلك قرارات السلطة المركزية التي يمثلها الملك[33].
ثالثا: الديمقراطية فكرا وممارسة لدى محمد حسن الوزاني
- أساس منظور الوزاني الفكري للديمقراطية
ارتبط الاهتمام بالديمقراطية في فكر محمد حسن الوزاني بتزايد الحاجة إلى برامج سياسية واجتماعية وخطط تنموية لمواجهة ما عَبَّرَ عنه بالأزمة الشاملة التي كانت تواجه المجتمع المغربي بعد الاستقلال، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الأمة والدولة والاقتصاد والمجتمع بشكل عام[34]، تأسيسا على مزاوجته الفكرية بين المرجعيتين السياسيتين الإسلامية (السلفية) والغربية (الليبرالية)[35] والتي رأى ضمنها بأن الديمقراطية كما أسستها تعاليم الإسلام الروحية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا تختلف في شيء عن جوهر الديمقراطية العصرية الصحيحة، على اعتبار أن “وأمرهم شورى بينهم” الواردة في القرآن الكريم – يقول الوزاني- تؤدي نفس المعنى الذي تعبر عنه كلمة الديمقراطية في معناها اليوناني “حكم الشعب بالشعب”[36].
إن توظيف الوزاني لمفهوم الديمقراطية وما يرتبط بها من مصطلحات (الدستور والحرية والعدالة والمساواة)، لم تمنعه من الإحالة على حقول مرجعية تراثية مستعيرا مصطلحات ذات صلة بالقانون الإسلامي وفقه الشريعة كالأمة والشورى وأهل الحل والعقد[37]، إذ ذهب في تعريفها نظريا، إلى كونها “حكومة الشعب بالشعب وللشعب”. وواقعا، اعتبرها “نظاما حكوميا يُمَارَسُ باسم الشعب من لَدُن قِلَّة من المتحكمين أوليغارشية عرفوا كيف يستغلون الوسائل الديمقراطية كحرية الصحافة وحرية الرأي والانتخابات..، في إطار تحقيق مسعى الاستيلاء على الحكم والتصرف فيه باسم الشعب”[38].
فالديمقراطية إذن، من منظور الوزاني تعني ضرورة الاهتمام بالجوهر دون الشكل، وإلزامية تلائم نتيجة تفكير واجتهاد وابتكار وإبداع بحقائق المجتمع وأوضاعه المعيشية، ومن ثَمَّ فقد ارتكزت منظومته الديمقراطية على:
- مفاهيم الحرية والديمقراطية ومبدأ فصل السلط،
- الملكية الدستورية،
- المشاركة السياسية كأداة لتجسيد السيادة الشعبية[39].
وإعمالا لمبدأ المساواة السياسية التي تعد من الأسس الداعمة لقيام نظام ديمقراطي بالمغرب، أكد بأن ذلك لا يستقيم إلا بتوفر شروط “في طليعتها التربية الوطنية والسياسية الملائمة لممارسة الديمقراطية، على أساس حق الانتخاب والنظام النيابي ومسؤولية الحكم والمعارضة على حد سواء إلى جانب رقابة الرأي العام”، إلا أنه اعتبر مبدأ الانتخاب عنصرا أساسيا في كل ديمقراطية[40] مؤكدا على ضرورته كإجراء قانوني وسياسي يسمح للشعب باختيار الحكام الذين يكلفهم بمسؤولية الحكم في إطار يوطد دعائم النظام التمثيلي الذي أصبح أساس نظام الحكم الحديث، وذلك دونما إهمال للقوانين الانتخابية التي اعتبر أن إصلاحها وسلامة تطبيقها تضمن التعبير الصحيح والسليم عن الإرادة العامة للشعب[41].
لقد طالب محمد حسن الوزاني بإرساء أسس النظام الديمقراطي موازاة مع مطالبته بالاستقلال، لأنه كان يرى في ذلك عدم مواجهته للمؤسسة الملكية أو معارضتها من حيث المبدأ، بل التأكيد على دعوته إلى رؤية سياسية محددة وعميقة[42]، سيما في ظل معاناة النظام الديمقراطي الذي تم إرساؤه في المغرب من مظاهر الارتجال المتأثرة بالثقافة المخزنية السائدة[43]، معبرا عن رغبته في إصلاحه تدرجيا، لكون الشعب المغربي -بالرغم من طبعه الديمقراطي-لا زال في حاجة إلى تنشئة سياسية تقوم بها النخبة[44].
- تأثير المسألة الدستورية على العملية الديمقراطية
اعتبر محمد حسن الوزاني أن أصلح ديمقراطية للمجتمع المغربي هي التي ترتكز على الشورى كما فرضها الإسلام وقننها تشريعه الدستوري[45]، بحيث قال بأن “الاستقلال لا يمكن أن يكون حقيقيا وليس في صالح الأمة جمعاء إلا إذا قام على أساس الشورى والديموقراطية الحديثة، في إطار ملكية قوامها الدستور وفصل السلطات العامة والحريات الديموقراطية، والعدالة الاجتماعية وما إلى ذلك من المبادئ التي تنص عليها كل الدساتير العصرية في الأمم الراقية”[46]. معتمدا في ذلك على تقسيم زمني عَدَّدَهُ لتبيان تطور نظام الحكم بالمغرب إزاء المسألة الديمقراطية بشكل عام والمسألة الانتخابية على وجه الخصوص، والذي شملته الفترة الممتدة ما بين نهاية الحماية وبداية السبعينيات عبر المراحل الخمس الآتية:
- مرحلة مستهل الاستقلال: وصفها بالخلو من أي صبغة ديمقراطية خاصة وأنها كادت تضع المغرب تحت حكم نظام الحزب الوحيد، منتقدا بشدة تجربة الحكومة المنسجمة وتجربة المجلس الوطني،
- مرحلة ما قبل الدستور: التي تم فيها تعيين مجلس الدستور لإعداد مشروعه،
- مرحلة الاستثناء: التي اعتبرها انقلاب دولة وعودة المغرب إلى وضع عهد الحماية وبداية الاستقلال، مما يجسد حالة من الجمود،
- مرحلة عودة الدستور ابتداءا من 1970[47].
وبذلك يعدُّ الدستور من بين الثوابت الأساسية لدى الوزاني[48] باعتباره آلية أساسية لتقييد السلطة الملكية[49]، فضلا عن كونه بمثابة اللبنة الرئيسية لتحقيق الإصلاح السياسي في المغرب[50]. فحظيت مسألة وضعه، بالرغم من طابعها الشكلي، بأهمية من حيث إعطاء الدستور مكانة خاصة على اعتبار أنه الكفيل بتحديد مضمون السلطة السياسية وتقييدها في إطار نظام ديمقراطي غير شمولي[51]، ليبلور على هذا الأساس تصورين قانونيين، يُعنى أولهما بضرورة انتخاب مجلس تأسيسي، في حين يرتكز ثانيهما على أهمية تشكيل مجلس وطني يمثل كافة اتجاهات الرأي السائدة[52]. في إشارة منه إلى الصراع الفكري والسياسي الذي كان قائما بينه وبين علال الفاسي.
من هنا يبرز سعي محمد حسن الوزاني الحثيث، إلى ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية تكون من صلاحياتها وضع الدستور[53] منذ الفترات الأولى لحصول المغرب على الاستقلال، سيما في ظل تأكيده على “أن الطريقة الطبيعية والوسيلة الديموقراطية، والأسلوب المألوف والمنشود هو المجلس التأسيسي المنتخب انتخابا حقيقيا عاما، وحرا نزيها”[54]، الأمر الذي أدى بموقفه إلى الاصطدام مع إرادة الملك محمد الخامس المتمثلة في تعيين مجلس تمثيلي يضع دستورا يحظى بموافقته قبل أن يُعرضَ على الاستفتاء الشعبي، اضطره في النهاية إلى تغيير موقفه الذي برره بكون عدم تحقيق الديمقراطية المنشودة المتمثلة في صيغة الجمعية التأسيسية المنتخبة “لا يعني بأن طريقة التعيين عيب وليست كلها شر، فلها محاسنها ولها عيوبها شأنها في ذلك شأن باقي السبل”، ما دامت الغاية تنكب صوب “توفر البلاد على دستور ديموقراطي حقيقي يحقق معاني الحرية والاستقلال لصالح البلاد والأمة”[55].
لكن مع تغير الأوضاع السياسية لفائدة احتكار المؤسسة الملكية للسلطة التأسيسية على إثر اعتلاء الحسن الثاني للعرش، ووضعه للدستور بيده بعد حل المجلس التأسيسي المعين الذي فشل في أداء مهمته*، وإن استمر وفاءه لموقفه بعد الإعلان عن الاستفتاء الدستوري سنة 1962 بالتأكيد على أن المواطنين أرادو ممارسة جميع حقوق المواطنة المقدسة التي اعترفت لهم بها القوانين المشروعة والعهود المؤكدة منذ الاستقلال وفي مقدمتها حق الأمة المتحررة السيدة الواعية الرشيدة في وضع دستورها القومي[56]، فقد عَبَّرَ، في خضم الصراع السياسي السائد حينها، عن صيغة متوازنة تضمن للملكية الدستورية مكانتها وتعطي للأمة حقها في السيادة، من خلال تمسكه “بالملكية الدستورية على النسق المتفق مع روح العصر الذي هو عصر الشعوب والثورات الفكرية والسياسية والاجتماعية الهادفة إلى تغيير المفاهيم القديمة، وتحويل الأوضاع التقليدية، وتجديد الأنظمة لتكون ملائمة لسُنَّة التطور والارتقاء لا فرق في هذا بين الفرد والمجتمع، نتمسك بحكم هذا كله بمفهوم السيادة للأمة وبكل ما ينبثق عنها من حقوق كاملة غير منقوصة، ومن اختصاصات تمارس بواسطة وكلاء الأمة الحقيقيين دون المفروضين والمزعومين، كما هو الشأن في الدساتير العليلة الفاسدة، وفي الديمقراطيات الشكلية الفاشلة”[57] التي تهمش من دور البرلمان نتيجة لتحكم السلطة التنفيذية المتعارض مع مبدأ السيادة للأمة والمرسخ لمبدأ السيادة الملكية على حساب السيادة الشعبية[58].
خــــلاصـــة
لم تكن الحركة الوطنية المغربية منذ تأسيسها راضية على تمتع الفرنسيين دون المغاربة بامتياز اختيار ممثلين عنهم في مجالس تمثيلية[59]، وبعد أن حصل المغرب على استقلاله رفعت فصائل الحركة شعار ضرورة إرساء دعائم حكم ديمقراطي دستوري قائم على الانتخابات، غير أن الانشغال بترجمة الاستقلال إلى واقع ملموس والأحداث المضطربة والصراعات التي عاشها مغرب الاستقلال في سنواته الأولى همشت شعار “الدمقرطة”.
وانقسمت بذلك النخبة المغربية إلى تيارين توزعت مرجعيتهما بين تجارب أوربا الغربية وتجارب بعض الديمقراطيات الشعبية، حيث رفع الأول شعار “الديمقراطية من الأعلى” ويمثله محمد حسن الوزاني الذي دعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي بالدرجة الأولى يعهد إليه وضع الدستور ويمهد السبيل إلى برلمان منبثق عن انتخابات تشريعية تفسح المجال لانتخابات محلية، في حين رفع التيار الثاني الذي يمثله علال الفاسي شعار “الديمقراطية من أسفل” بالتركيز على انتخاب المجالس البلدية والقروية أولا وقبل أي خطوة سياسية[60].
وبالعودة إلى مسار الرجلين (الزعيمين) الفكري والميداني، تَرَسَّخ أن حضورهما التاريخي ضمن النسق السياسي المغربي خلال مرحلتي الحماية والاستقلال، أدى إلى نتائج كانت حكرا على مجال صراعهما السياسي الضيق دون أن تلامس نسق تطلعات الشعب المغربي، وبخاصة منها ما يتعلق بتجسيد سيادته، الأمر الذي عَبَّرَ عنه تراجعهما عن أطروحتيهما المرتكزة على الإصلاح السياسي والدستوري وبالتالي خضوعهما لواقع النسق السياسي الذي حددت معالمه المؤسسة الملكية مع أول دستور عرفه المغرب سنة 1962.
إن الديمقراطية وهي تتيح المجال لمشاركة الجميع في الحياة السياسية وتنظم العلاقات بين مكونات المجتمع وتياراته المتباينة على أسس وقواعد متكافئة ومنصفة وتضمن تدبير الشأن العام بأسلوب متحضر، فهي غاية في حد ذاتها، ولأنها تعد ضرورية لتعبئة كل الطاقات التي تتوفر عليها البلدان لخلق الثروات وتحقيق التنمية وضمان التوزيع العادل للخيرات الوطنية في إطار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، فهي وسيلة.
وهذا ما يؤدي إلى اكتشاف عمق التباين والتنافر الفكري بين علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني بالرغم من فاعليتهما في المشهد السياسي العام الذي اجتهدا بشأن إصلاح نظام حكمه وتقييده دستوريا، ولو بشكل متفاوت، إذ أنه لم يتحقق لهما ما كانا قد يرجوانه من ديمقراطية تأسيسية، تكون بمثابة تعبير عن السير بالمغرب من مرحلة التحكم الانتقالي إلى مرحلة التحكيم الأبدي، ومن ثم السماح لباقي الفاعلين السياسيين العمل بمسؤولية في ظل دستور ديمقراطي تتمتع بموجبه الأمة بسيادتها، ذلك أن فكرهما اتسم بالصراع الأفقي في شقيه الجدالي والسجالي نتيجة لخلافاتهما السياسية التي تدعمت من خلال أطروحتيهما المتناقضتان من حيث الرؤية للإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب، وهو الأمر الذي لا زالت آثاره متجلية في ظل وجود كم هائل من الأحزاب السياسية التي عمقت رؤاها المختلفة من الجدل السياسي حول كيفية ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية بأسلوب تشاركي لا ينفصل عن تجسيد مبدأ فصل السلط بالشكل الذي يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة والتأسيس لحكامة جيدة.
وبالتالي، يمكن القول بأن الأسس الفكرية للعملية الديمقراطية بالمغرب، نتيجة لتعدد مصادر مشاربها التي تجاذبت الرؤى حول الوسائل والطرق الكفيلة بإصلاح نظام الحكم وتقييده دستوريا، ونتيجة لإشكالية التقليد والتحديث التي عمقت من الجدال الفكري والسياسي، لم تصل تلك الأسس الفكرية وتجلياتها السياسية إلى درجة التسليم بمبدأ التوافق حول إيجاد صيغة متقاربة او موحدة ترسي دعائم الديمقراطية السليمة بعيدا عن الانتماء السياسي، الأمر الذي قد يؤثر – كما حصل زمن رواد الحركة الوطنية المغربية بعد الاستقلال- على تفعيل دستور 2011، ومن ثَمَّ على العملية الديمقراطية ككل.
[1] علي حسني، القانون الدستوري وعلم السياسة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 2، 1992، ص 100.
[2] امحمد المالكي، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط1، 2001، ص ص 175-176.
[3] محمد شاكر الشريف، حقيقة الديمقراطية، نسخة إلكترونية.
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?491729-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
[4] إمام عبد الفتاح، مسيرة الديمقراطية.. رؤية فلسفية، عالم الفكر، المجلد 22، العدد 2، وزارة الإعلام، الكويت، 1993، ص 42.
[5] بشير زين العابدين، نقد الديمقراطية المعاصرة في الفكر الغربي، جامعة لندن، ربيع الأول 1422، ص 20.
[6] سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، جامعة القاهرة، 2007، ص ص 128-129.
[7] برهان غليون، حقوق الإنسان.. الرؤى العالمية والإسلامية والعربية، سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط1، أبريل 2005، ص 241.
[8] ميشيل حنا متياس، المجلد 22، العدد 2، وزارة الإعلام، الكويت، 1993، ص 215.
[9] امحمد المالكي، مرجع سابق، ص ص 46-47.
[10] نفس المرجع، ص 177 ص 196.
[11] الحاج قاسم محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية –المفاهيم الأساسية والنظم السياسية-، دار النشر المغربية، ط 4، الدار البيضاء، 2009، ص 84 ص 87.
[12] بوبكر شقير، الفكر السياسي المغربي بين الاتجاهات السلفية والليبرالية، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2009، ص 25.
[13] عبد الكريم غلاب، “البعد الاجتماعي في فكر علال الفاسي”، مجموعة مقالات، علال الفاسي ينبوع فكري متجدد، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2001، ص 59.
[14] علال الفاسي، الديمقراطية ثقافة وخلق، مقال نشر بمجلة البينة. السنة الاولى. العدد 08 رجب 1382 هـ موافق دجنبر 1962م
http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=526:allal-el-fassi-la-democratie-essai&catid=51:etude-et-essais&Itemid=153
[15] عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص 136.
[16] محمد بلبشير الحسني، قطوف دانية من فكر علال الفاسي، كتاب العلم الخامس، مطبعة الرسالة، المغرب، 1991، ص88.
[17] علال الفاسي، النقد الذاتي، دار الفكر المغربي، ص 48.
[18] محمد بلبشير الحسني، مرجع سابق، ص 92.
[19] نفس المرجع، ص 93.
[20] علال الفاسي، الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، مطبعة الرسالة، ط 2، أكتوبر 199، الرباط.
[21] عبد الكريم غلاب، مرجع سابق، ص 136.
[22] علال الفاسي، منهج الاستقلالية: نص التقرير الذهبي الذي قدمه رئيس حزب الاستقلال للمؤتمر السادس المنعقد في الدار البيضاء يناير 1962، مطبعة الرسالة، 1962، الرباط، ص 52.
[23] علال الفاسي، النقد الذاتي، مرجع سابق، ص 113.
[24] – نفس المرجع، ص69.
[25] – نفس المرجع، ص 152.
[26] أمحمد المالكي، مرجع سابق، ص 267.
[27] بوبكر شقير، الفكر السياسي المغربي بين الاتجاهات السلفية والليبرالية، افريقيا الشرق، 2009، الدار البيضاء، ص 28.
[28] علال الفاسي، منهج الاستقلالية: نص التقرير الذهبي الذي قدمه رئيس حزب الاستقلال للمؤتمر السادس المنعقد في الدار البيضاء يناير 1962، مرجع سابق، ص 57.
[29] علال الفاسي، الديموقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها، مرجع سابق، ص 79.
[30] محمد شقير، الفكر السياسي المغربي المعاصر، افريقيا الشرق، 2005، الدار البيضاء، ص 116.
[31] ويقول في هذا المقام: “…، كذلك يجب أن يكون الوزراء منفذين لشؤون الدولة باسم جلالته ولكن على شرط أن يتحملوا مسؤولية ما يمضونه من أعمال أمام جلالته بصفته ولي الأمر، وأمام المجالس النيابية يوم يتم تحقيق ما نصبو إليه من نظام دستوري متين، بعد الاستقلال طبعا. ونحن نعتقد أن المسؤولية الوزارية خير حل للمشاكل التي تعرض لأنظمة الحكم، وهي ضرورية لكل الحكومات سواء كانت ملكية كما هي بلادنا أو جمهورية مثل فرنسا وغيرها.” انظر علال الفاسي، النقد الذاتي، مرجع سابق، ص 111
[32] بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 34.
[33] نفس المرجع، ص 35.
[34] نجية بنيوسف، الأمة وممارسة السلطة في فكر محمد حسن الوزاني، الديمقراطية في المغرب العربي، ندوة دولية، فاس، 9- 12 شتنبر 1998.
[35] محمد شقير، مرجع سابق، ص 79.
[36] بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 91.
[37] امحمد المالكي، مرجع سابق، ص ص 273-274.
[38] بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 93.
[39]بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 81.
[40]محمد معروف الدفالي، مبدأ الانتخاب في خطاب محمد بن الحسن الوزاني، الديمقراطية في المغرب العربي، ندوة دولية، فاس 9-12 شتنبر 1998، مطبع النجاح الجديدة، 2000، ص-ص 55-56.
[41]بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 93.
[42]أحمد ارضاوني، قراءة جديدة في المسار السياسي لمحمد حسن الوزاني وأتباعه، وجهة نظر، عدد 46، صيف وخريف 2001، ص 34.
[43] محمد شقير، الفكر السياسي المغربي المعاصر، مرجع سابق، ص 93.
[44]نجية يوسف، مرجع سابق، ص 94.
[45]نفس المرجع ص 91
[46] – محمد حسن الوزاني، استقلال وديمقراطية، الرأي العام، عدد26 نوفمبر 1955، (حرب القلم) الجزء 6، طبعة 1986 ص184.
[47] محمد معروف الدفالي، مرجع سابق، ص59.
[48] بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 110
[49] نفس المرجع، ص 105
[50] نفس المرجع، ص 111.
[51] بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 79.
[52] نفس المرجع، ص 13.
[53] بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 28.
[54] عبد العالي حامي الدين، المسألة الدستورية في الفكر السياسي المغربي المعاصر، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس- أكدال، الرباط، 2001، ص 193
[55] نفس المرجع، ص 194.
* كتب محمد حسن الوزاني في صحيفة الدستور بتاريخ 12 نونبر 1962 مدافعا عن ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور للبلاد ما يلي:
“… قطعت الدولة بالمغرب المرحلة الأولى من معركة الدستور وهي مرحلة التسجيل الذي دعي إليه المواطنون البالغون إحدى وعشرين سنة، وقد تجلت بداية تلك المعركة من طرف الدولة فيما عبأته من وسائل وإمكانيات ورجال وإطارات خاض بها طور التسجيل من معركة الدستورية، غير مدخرة في هذا أي جهد وأي أسلوب في الدعاية،…، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على بعد هذه الحركة المدبرة والمغامرة المحبوكة عن حقيقة الحرية وأبسط مبادئ الديمقراطية.
…. ومرة أخرى نعيد الكرة ونسأل: لماذا تصر الدولة على وضع مشروع الدستور دون أن يكون هذا من حقها ولا من اختصاصها ودون أن تعهد الأمة إليها بذلك تنازلا منها عن حق هو أقدس الحقوق على الإطلاق في عصر الرقي والتحرر، والحرية، والديمقراطية؟
إن الدولة تجيب عن هذا بجعل الأمة أمام الأمر الواقع مستبدة عن طريقه بحق لا تملكه مطلقا، وهو عدوان صريح على أكبر حق من حقوق الأمة وانتهاك فظيع لكل حرية وديمقراطية روحا وجوهرا، وقانونا، ونظاما واخلاف شنيع لكل الوعود المقطوعة سابقا للأمة –في عهد استقلالها-بأن تتولى هي وضع الدستور بواسطة مجلس يمثل مختلف نزعاتها واتجاهاتها وفعلا أسس مجلس للدستور احتفظت به الدولة سنوات ولن نعد نسمع له حسا ولا ذكرا حتى فوجئنا بقرار استفتاء عام في مشروع دستور معد باسم الدولة نفسها”. انظر محمد شقير، الفكر السياسي المغربي المعاصر، مرجع سابق، ص ص 38-39.
[56] عبد العالي حامي الدين، مرجع سابق، ص 196
[57] محمد حسن الوزاني، مرجع سابق، ص ص 23-24.
[58] بوبكر شقير، مرجع سابق، ص 133.
[59] محمد معروف الدفالي، مرجع سابق، ص 57.
[60] محمد معروف الدفالي، مرجع سابق، ص 59.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية