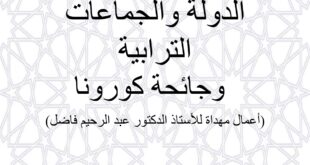إدارة الأزمات وتدبير المخاطر: أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ( قراءة في التجربة المغربية بين النص الدستوري والممارسة).
محمد أقريقز، دكتور في القانون العام، باحث في القانون الإداري وعلم الإدارة، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة. إطار بوزارة الداخلية.
يشهد عالمنا المعاصر أعداد كبيرة وأشكالا متنوعة من الأزمات، والتي تتفاوت مدى حدوثها بين تلك التي تحدث على المستوى الفردي وبين تلك التي تمس الجماعات على اختلاف تنظيماتها، سواء على المستوى الجهوي/ المحلي أو الوطني أو حتى على المستوى الدولي والعالمي.
ونظرا لأن البيئة والظروف المحيطة بنا غير مستقرة، وأن التغيرات متلاحقة وسريعة، ولأن العلاقات بين مختلف التنظيمات يسيرها منطق التحدي والتنافس بغية تحقيق أهدافها، الأمر الذي يسهم في تعقد الأزمات وتعدد أبعادها وامتداد أثارها إلى أطراف ليس لها يد أو سبب أو أي شأن في حدوثها.
فمجتمعاتنا اليوم، تواجه العديد من التحديات والإكراهات في ظل عالم تتغير أوضاعه باستمرار وبشكل متواصل جراء الثورة المعلوماتية والانفجار المعرفي ، والتنافسية الدولية والتكتلات الكونية العابرة للقارات، والتي ترفع من منسوب تزايد احتمالية تعرضها للكثير من الرجات والهزات العنيفة التي قد يرجع سببها لإهمال المؤسسات المجتمعية ومنظماتها لبعض الإشارات والإنذارات التي مرت بشكل سريع، بسبب تراكمات كانت كفيلة بأن تأخذ طابع أزمة مجتمعية قطاعية ذات تداعيات محدودة أو أزمة مجتمعية عميقة وشاملة قادرة على شل الاقتصاد الوطني في مجمله وحتى العالمي . ومسألة توالي الأزمات وإشكالية حدوثها ووقوعها وتجدد وقوعها، كانت ولا تزال بمثابة التهديد الذي يمكن أن يطال مختلف المجتمعات البشرية، بل لقد أضحت من بين العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند التفكير في وضع ورسم برامج ومخططات لها صلة بحياة الأفراد وحاجتهم التي يأملون تحقيقها أو الحصول عليها بشكل فردي أو داخل المنظمات والمؤسسات المجتمعية التي ينتمون لها. ولهذا، فديناميكية المجتمعات وقوة مؤسساتها ومنظماتها مرتبطة بمدى قدرة نظمها وهياكلها على رصد ومراقبة هاته المتغيرات في إطار العمل والاشتغال وفق أسس ومقتضيات اليقظة الاستراتيجية التي من شأنها تفادي مخاطر الأزمات والحد من تأثيراتها وانعكاساتها السلبية.
وفي هذا السياق؛ يمكن القول بأن التعامل مع الأزمات وتدبيرها، يعد أحد محاور اهتمام علم الإدارة. ويقتضي وجود نوع خاص من المدبرين يتمتعون بمهارات متميزة، من قبيل: القدرة على التفكير الإبداعي، ملكة التواصل والقدرة على الاتصال، القدرة على التخطيط ورسم الاستراتيجيات، الشجاعة في اتخاذ المواقف، ثم الثبات والاتزان الانفعالي في التعامل مع الأزمة.[1] بعبارة أخرى، يمكن التأكيد على أن من أهم مقومات التنمية والتطور المجتمعي هو وجود قيادة رشيدة متبصرة، ذات بعد استراتيجي في منهجها التدبيري، تتمتع بالقدرة على حماية مكونات المجتمع والحفاظ عليه من مختلف التداعيات السلبية للمحيط الداخلي والخارجي، وفق تصور وفكر يتطلع إلى الرقي والتقدم على كافة الأصعدة، مرتكزة في ذلك على أسس متينة تحمل معاني الكفاءة والقدرة على إدارة الحالات الطارئة والاستثنائية، وتتصف بالخبرة الفنية والتدبيرية التي تخدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب للتعاطي مع الأوضاع الحالية والمستقبلية بما يخدم تطلعاتها الاستراتيجية.
وسنركز في مداخلتنا هاته على نقطتين أساسيتين.
- النقطة الأولى: سنخصصها لماهية الأزمة ومقوماتها والتصورات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي لتدبير مخاطرها.
- على أن نعالج من خلال النقطة الثانية عبر قراءة تحليلية، التجربة المغربية في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19” وفق آليتين أساسيتين: استقراء النص الدستوري علاقة بتدبير المخاطر، وآلية رصد وتتبع التنزيل العملي لتدابير وإجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية.
المبحث الأول: ماهية الأزمة ومفهوم تدبير/ إدارة الأزمات.
قبل تناول مفهوم تدبير الأزمة والإحاطة به، لا بد من تحديد مفهوم الأزمة أولا.
المطلب الأول: تعريف الأزمة.
لقد تعددت وتباينت التعريفات التي تناولت مفهوم الأزمة بالدراسة تبعا لاختلاف وتباين المستويات والمجالات ووجهات نظر المهتمين والباحثين في دراستهم للأزمات، فضلا عن تعدد أنواع الأزمات وأسبابها وتصنيفاتها المتعددة. فوجه الصعوبة في تحديد مفهوم الأزمة يكمن في شمولية طبيعته واتساع نطاق استخدامه، لدرجة أنه من المتعذر إيجاد مصطلح يوازي ” الأزمة” في ثراء امكاناته واتساع مجالات استعماله.[2]
فالأزمة لغة، وحسب مختلف معاجم اللغة العربية تفيد: الشدة والقحط. و ” أزم” عن الشيء أي أمسك عنه، و ” أزم” على الشيء أي عض بالفم كله عضا شديدا.[3] وهي تشير إلى حالة طارئة وموقف استثنائي مخالف لمجريات الأمور الاعتيادية.[4]
وكلمة الأزمة Crisis)) مشتقة أصلا من الكلمة اليونانية (Kipvew) أي بمعنى لتقرر ( to decide ). أما اللغة الصينية فقد برعت إلى حد كبير في صياغة مصطلح الأزمة، إذ ينطقونه (Ji- Wet) وهي عبارة عن كلمتين الأولى تدل على (الخطر) والأخرى تدل على (الفرصة) التي يمكن اقتناصها واستثمارها،وتكمن البراعة هنا في تصور امكانية تحويل الأزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرصة لإطلاق القدرات الإبداعية التي تستثمر الأزمة كفرصة لإعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول السديدة.[5]
أما مفهوم الأزمة إصطلاحا، فيفيد أن الأزمة هي لحظة حرجة وحاسمة تهدد مصير المؤسسات المجتمعية التي تتعرض لها، وتضع صعوبات عميقة أمام صناع القرار في ظل وضع يطغى عليه عدم اليقين وانعدامه وعدم التأكد وغياب القدر الكافي من المعلومات والمعرفة اللازمة والمطلوبة لمسايرة مجريات واقع الأزمة وتداعياتها. كما تعرف أيضا من هذا الجانب باعتبارها حالة من عدم الاستقرار تتضمن إشارات وتنبؤات بحدوث تغييرات حاسمة.[6]
وتعود الأصول الأولى لاستخدام كلمة “أزمة” إلى علم الطب الإغريقي القديم، وكانت هذه الكلمة تستخدم للدلالة على وجود نقطة تحول مهمة، وحدوث لحظة مصيرية في تطور مرض ما، ويترتب عن هذه النقطة إما شفاء المريض خلال مدة قصيرة وإما موته.[7] وقد كثر استخدام كلمة أزمة في القرن السادس عشر في المعاجم الطبية، لتتطور استخدامات هذه الكلمة خلال القرن السابع عشر لتنصب كمفهوم يلامس ارتفاع درجة التوتر في العلاقات بين الكنيسة والدولة. أما خلال القرن التاسع عشر فاستخدمت الكلمة للإشارة إلى بروز مشكلات كبيرة وخطيرة ولحظات تحول مفصلية في واقع العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.[8] وخلال أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي عرف حقل العلوم الاجتماعية الأزمة بأنها: حدوث خلل خطير في العلاقات بين العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس الأموال. ومنذ ذلك التاريخ بدأ التوسع في استخدام مصطلح الأزمة في إطار علم النفس عند الحديث عن أزمة الهوية، وتناوله الديموغرافيون عند حديثهم عن أزمة الانفجار السكاني، إلى حد أن أسفر استخداماته المتعددة داخل مختلف الحقول العلمية والمعرفية إلى تداخل ولبس بين مفهوم الأزمة والمفاهيم الأخرى ذات الارتباط الحيوي والوثيق به.[9]
فالأزمة بمفهومها العلمي، يمكن الإقرار بأنها عبارة عن حالة وموقف تواجه متخذ القرار سواء داخل الدولة في عمومها أو مؤسسة بذاتها أو مشروع … حيث تتداخل وتتشابك الأسباب والمسببات بالنتائج وتتواصل الأحداث حتى تصل إلى درجة من التعقيد تجعل من متخذي القرار يعيشون حالة من الضبابية تفقده الرؤية الواضحة في حالة اصطدامه بالمشكلة، لتصيبه حالة من الارتباك وعدم السيطرة في محاولاته الإمساك بخيوطها أو توجيهها نحو المستقبل. وهو ما يجعل متخذي القرار في حالة من عدم التوازن نظرا لقلة المعلومات والبيانات حول الأمر، وبالتالي محدودية القدرة في وضع تصور سريع لما قد يحدث من احتمالات في المستقبل.[10]
المطلب الثاني: مفهوم إدارة الأزمات وتدبير المخاطر:
يعد مفهوم إدارة الأزمات وتدبير المخاطر من الاهتمامات الادارية الحقيقية في عصرنا الحاضر، نظرا للتطورات والمتغيرات المتلاحقة التي نعيشها على مختلف الأصعدة والمستويات، بحيث كلما تعددت المسؤوليات وتشعبت المهام والأعمال والوظائف إلا وتعقدت معها الأنظمة الإدارية التي تمس مختلف جوانب الحياة المجتمعية في مستوياتها الاقتصادية، السياسية ، الادارية، الصحية والاجتماعية… وغيرها، مما يسهم كنتيجة حتمية في خلق ونشوء أزمات تتطلب منا فهم طبيعتها وإدراك كنهها ودورة حياتها والتعرف على أنواعها قصد رسم سيناريوهات فعالة في التعامل معها والتصدي لتداعياتها. إذ يشير هذا المفهوم إلى كيفية التغلب على الأزمة عبر استخدام وتبني أسلوب إداري علمي من أجل تجنب وتلافي سلبياتها ما أمكن، وتغليب كفة حصد الإيجابيات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. بعبارة أخرى أن علم إدارة الأزمات وتدبير المخاطر نشأ في محاولة من المتخصصين لدعم متخذ القرار بمجموعة من النظم والوسائل والإجراءات التي تضعه في أتم الاستعداد للمواجهة الفورية للمواقف الاستثنائية والطارئة والتي تحدث خلخلة في كل الثوابت المتعارف عليها في مجال التدبير والتسيير وباقي جوانب الحياة العامة والحياة الاقتصادية والاجتماعية عموما، والتي بالموازاة تفرض تغييرا كليا في مسلسل صنع وبلورة السياسات العمومية عبر دعوة صناع القرار العمومي إلى استلهام نماذج التدبير المعتمدة في بعض وحدات القطاع الخاص والانفتاح على أنجح الممارسات والتجارب الدولية في هذا السياق.
فعلم إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، من العلوم الحديثة التي فرضت نفسها على واقع عالمنا المعاصر والذي تزايدت تعقيداته وتناقضت مصالحه مع التطور الهائل الذي عرفه قطاع التكنولوجيا ووسائل الاتصالات والذي ساهم بدوره في ردم الهوة وتحطيم الفاصل الزمني بين الفعل ورد الفعل، وبالتالي وضع متخذ القرار أمام خيار وحيد وأوحد وهو أن يكون دائما مستعدا للمواجهة الفورية للمواقف الطارئة والأزمات الفجائية واتخاذ بشأنها القرارات المناسبة،[11] وفق أسلوب ومعطى يحقق الأثر الفوري للعديد من الإشكالات الأساسية. أي ضرورة تبني علاقة واضحة بين التدبير الإستراتيجي والبعد الزمني للبرامج والسياسات العمومية. والتشخيص السليم للأزمات هو المفتاح السهل للتعامل معها، والذي من دونه يصبح التعامل ارتجاليا. كما أن أساس هذا التشخيص السليم يتمثل في وفرة المعلومات والمعرفة، فضلا عن رصيد من الخبرة والممارسة. ولهذا فإن مهمة التشخيص السليم والدقيق في مهمة الاشتغال على الإحاطة بالأزمة لا تقتصر فقط على معرفة الأسباب وبواعث حدوث الأزمة، والعوامل المساعدة لها، وإنما أيضا إلى تحديد كيفية معالجتها، ومتى وأين تتم هذه المعالجة، وكذلك من يتولى أمر التعامل معها، ومتطلبات المرحلة من عمليات ووسائل لإدارة الأزمة من خلال رسم سيناريوهات رئيسية وبديلة للتعامل مع الأحداث والتداعيات التي سببتها الأزمة قصد الحد من تصاعدها واحتوائها وامتصاص تأثيرات صدماتها وضغطها.[12]
ويرجع أحد الباحثين[13] أصل وأساس إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، إلى الإدارة العمومية ودور الدولة في مواجهة الكوارث العامة المفاجئة، والظروف الطارئة من زلازل وفيضانات وحرائق وأوبئة إن على المستوى الوطني أو الجهوي والمحلي. حيث أن تدبير الأزمات، مجموعة من الأعمال والأنشطة المتخذة من أجل البحث والحصول على المعلومات اللازمة والضرورية التي من شأنها أن تمكن إدارة الأزمة أو لجنة اليقظة والتتبع، من التنبؤ باتجاهات الأزمة وبؤرها الممكنة والمتوقعة، والعمل على استباقها وتهيئة المناخ المناسب للتعامل معها عن طريق اتخاذ التدابير الاحترازية، وتوفير الاحتياطات الضرورية للتحكم في فيها والقضاء عليها، أو تغيير مسارها لصالح ما يخدم الوطن وقطاعاته ومؤسساته ومواطنيه.[14]
ويذهب بعض الباحثين والمهتمين[15] إلى أن إدارة الأزمة وتدبيرها هي عملية إدارية متميزة يحكمها عنصر المفاجئة والمباغتة، والتي تحتاج معها لتصرفات وردود أفعال حاسمة، سريعة ومتزنة تتماشى وتطورات الأزمة. وبالتالي يكون لإدارة الأزمة أو للجنة اليقظة والتتبع لها، زمام رسم منحى قيادة الأحداث وتتبع الأمور ميدانيا أول بأول وتوجيهها والتأثير عليها وفقا لمقتضيات الأمور وللمعطى الميداني الذي لا يغيب عنه الحس التوقعي والتنبئي ، بغرض التحكم في النتائج أو الحد من آثارها السلبية والمدمرة.[16]
فإدارة الأزمات وتدبير المخاطر، هي إذن عملية رشيدة وعقلانية تبنى على العلم والمعرفة وتعمل على وقاية المؤسسات المجتمعية والارتقاء بأدائها من خلال التقليل من الآثار الضارة لحدث الأزمة الخطير باستخدام موارد محدودة في ظل قيود زمنية بالغة الصعوبة، وفق فلسفة يتجاوز جوهرها الحقيقي مجرد “إطفاء الحرائق” نحو جوهر أعمق يصب في زراعة النجاحات المحتملة والتي تتواجد بين العثرات من خلال التخطيط الاستراتيجي الدقيق والتنفيذ الحاسم.[17]
ومن خلال هذا التأطير المفاهيمي لإدارة الأزمة وتدبير مخاطرها، يمكننا الوقوف على عناصرها الأساسية ودعاماتها الرئيسة وتحديدها فيما يلي:
- أنها عملية ادارية خاصة، تتمثل في مجموعة من الاجراءات الإستثنائية المتخذة، والتي تتجاوز الوصف الوظيفي والمادي المعتاد والمألوف للمهام الإدارية.
- تدبر الأزمة وتدار عبر مجموعة من الكوادر الإدارية الكفأة، ذات إلمام وإطلاع على مبادئ، آليات واستراتيجيات مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة.
- تهدف وتسعى إدارة الأزمة ولجنة تتبعها إلى التقليل من الخسائر إلى أدنى حد ممكن.
- اتخاذ القرار وصناعته، من خلال تبني مقومات الأسلوب العلمي المعتمد في مثل هاته الأوضاع والظروف غير العادية.
وتجدر الاشارة، إلى أن إدارة الأزمات كممارسة موغلة في القدم وجدت منذ عصور قديمة، وكانت مظهرا من مظاهر التعامل الإنساني مع المواقف الطارئة والحرجة التي واجهها الإنسان منذ أن جوبه بتحدي الطبيعة أو غيره من بني جلدته. وإن لم تكن تعرف آنذاك بطبيعة الحال باسم تدبير الأزمات وإدارتها. وإنما تحت مسميات أخرى مثل: حسن الإدارة، الحنكة الديبلوماسية، البراعة في القيادة… وكانت هذه الممارسة محكا حقيقيا لاختبار قدرة الإنسان في مواجهة الأزمات وتعامله مع المواقف الصعبة، باعتبارها تستفز قدراته على الابتكار وتفجره طاقاته الإبداعية في التعامل مع الظرف وتجاوزه بما يضمن سلامته ويخدم مصالحه. بعبارة أخرى، يمكن القول أن إدارة الأزمات كانت ولا زالت إحدى الأساليب الجوهرية في إدارة العلاقات الإنسانية في مستوياتها المختلفة والمتباينة، والقدرة على النجاح فيها امتياز فطري وغريزي خص به الله تعالى البعض من البشر دون البعض الآخر. يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم: {{{يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولوا الألباب.}}} صدق الله العظيم.[18]
فما هي مقومات تدبير الأزمات وإدارتها؟
ان التعامل مع موقف الأزمة/ وضع الأزمة وتدبيره، يتطلب استخدام مجموعة من الأساليب الإدارية المتقدمة والتي من شأنها خلق وتحقيق المناخ المناسب للتعامل مع ظرفية الأزمة، وفي نفس الوقت تضمن للفريق الذي يتعامل مع الأزمة (لجنة اليقظة والتتبع، أو خلية التتبع والمراقبة … حسب المسميات التي تأخذها) مجال واسع لحرية الحركة وهامش المناورة.
ومن هنا كان لزاما على عناصر إدارة الأزمات وتدبيرها، أن تتوفر فيهم مهارات إدارية وقدرات خاصة ومتميزة، تسمح لهم بالتعامل مع الوضع الاستثنائي، وتمكنهم من أسس لتجاوز التعاطي مع الأوضاع العادية إلى مباشرة وممارسة ما يعرف ب ” الإدارة بالإستثناء“The management by exception. حيث تخرج القرارات الإدارية عن مسار ومنحى القرارات والتوجيهات العادية، وحتى بعيدا عن الهيكل التنظيمي القائم والمألوف في ظل الظروف العادية، لتصبح السلطات والصلاحيات مسندة إلى فريق عمل ذو اختصاصات واسعة ومسؤوليات فعلية للتعامل مع الأزمة.
ويمكن أن نحدد أبرز مقومات الفعالية والنجاعة في إدارة الأزمات وتدبيرها فيما يلي:
- تبسيط الإجراءات وتيسيرها:
حيث أن زمن الأزمة مختلف عن غيره من الظروف العادية، ومن تم لا يجوز إخضاعه لنفس الإجراءات الكلاسيكية. فظرف الأزمة ووقعها عادة ما يتسمان ببالغ الحدة والعنف. كما لا يمكن تجاهل عنصر الوقت داخل حيز زمن الأزمة، حيث أن التهاون بشأنه أو تجاهله والاستهتار في التعامل معه قد تكون نتائجه مدمرة للكيان المجتمعي والإداري لمجال حدوث الأزمة وحدوده. فالأمر يتطلب في مثل هكذا أوضاع، التدخل السريع والحاسم من خلال تبسيط المساطر وتسهيل الإجراءات بما يسمح بالتعامل مع كل تمظهرات الأزمة ومعالجتها.
- إخضاع مسلسل التعامل مع الأزمة لمنهجية علمية مدروسة:
فلا مجال للعشوائية والإرتجالية أو لسياسة الفعل ورد الفعل في التعامل مع الأزمة وتدبيرها. بل يجب أن يخضع التعامل مع الأزمة للمنهج الإداري السليم لتأكيد عوامل النجاح وحماية المجتمع من أي تطورات غير محسوبة قد يصعب عليه احتمال ضغطها.
ومهمة المنهج الإداري هنا هي الحرص على ضمان أربعة وظائف أساسية تتمثل في: التخطيط، التنظيم، التوجيه والتتبع.
- تقدير الوضع/ الأزمة:
وذلك من خلال تحليل كامل وشامل لأسباب الأزمة وتطوراتها، وتحديد دقيق للقوى الصانعة لها وللقوى المساعدة والمؤثرة فيها، ثم تحديد الإمكانيات والقدرات المتاحة لدى الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة عبر جمع المعلومات الدقيقة عن أبعاد الأزمة والتنبؤ باحتمالات تطور الأحداث وإمكانات السيطرة عليها.[19]
- تحديد الأولويات:
بناء على تقدير الوضع الحالي والمستقبلي لأحداث الأزمة وتداعياتها، توضع الخطط وتطرح البدائل التي يتم ترتيبها وفق أولويات محددة تبعا لمعايير معينة.
- تفويض السلطة:
يعد تفويض السلطة القلب النابض للعملية الإدارية وشريان مهم في إدارة الأزمات وتدبيرها. ومن تم فتفويض السلطة ينظر إليه باعتباره محور العملية الإدارية سواء في إدارة الأزمات، أو في نطاق المهام الموكولة لفريق العمل المكلف بإدارة الأزمة وتدبيرها، حيث يتطلب تفويض السلطات منح كل فرد من أفراد الفريق المناط به معالجة الأزمة، السلطة الضرورية لتحقيق عمله المحدد، بناء على فهم واضح للصلاحيات المناطة به والأنشطة التي يتوقع منه إنجازها.
- فتح قنوات الإتصال والإبقاء عليها مع الأطراف الأخرى:
تحتاج إدارة الأزمة إلى كم مناسب من المعلومات، وإلى متابعة فورية لتداعيات أحداث الأزمة ومناحي تطوراتها وسلوكيات أطرافها ونتائج هذه السلوكيات. ومن تم فإن فتح قنوات الإتصال مع الأطراف الأخرى يساعد على تحديد هذا الهدف وتحقيق مبتغاه.
- الإستفادة والإستعانة بالوفرة الإحتياطية:
إن الأزمة تحتاج إلى الفهم التام لأبعاد الموقف الناتج عن التواجد في عمق الأزمة، كما يحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي الذي يساعد على سرعة التصدي للأحداث. إضافة إلى الإستعانة بما يمتلكه القطاع الخاص من إمكانيات ومعدات يمكن توظيفها، والإستفادة من الموارد البشرية التي يمكن أن تساعد في عمليات إدارة الأزمة وإتاحة فرصة العمل التطوعي وفق أسس مدروسة ومعقلنة.
- إحداث فرق المهمات الخاصة:
وهذه تفيد بشكل أكثر دقة في الأبعاد الأمنية للأزمة، إذ مع تباين الأزمات واختلاف طبيعتها، تبرز ضرورة تشكيل فرق المهمات الخاصة من أجل التدخل السريع والفعال عند الحاجة.[20]
- توعية المواطنين:
في الحقيقة لا يمكن مواجهة أية أزمة بفاعلية دون إعلام وتوعية المواطنين والأشخاص المقيمين، بالدور المطلوب منهم القيام به عند وقوع الأزمة، بحيث أن وعيهم بالدور المطلوب منهم يساهم في المساعدة على مواجهة الأزمة. الأمر الذي يتطلب إعداد وتنفيذ خطط إعلامية وتوعوية في هذا الإتجاه. كما يجب السهر على تنظيم حملات توعوية وإعلامية على كافة المستويات تستخدم خلالها كافة وسائل وأساليب الإتصال الجماهيرية المتاحة من أجل تنوير الرأي العام وتوضيح الإجراءات والرؤى المستخدمة والمتبناة في مواجهة الأزمة، والمسؤوليات الملقاة على عاتق المواطنين، والمساعدة في تقديمها والإمتثال لها.[21]
فالخطة الإعلامية هي من أهم مقومات إدارة الأزمات، والضرورة تحتم وجود سياسة إعلامية قبل وأثناء وبعد الأزمة. نظرا لما للإعلام من أهمية كبرى في إدارة الأزمات، وفي تهميش دور الإعلام انعكاسات سلبية على عملية تدبير الأزمة وإدارتها. لذا يستحسن تعيين متحدث رسمي على قدر من الكفاءة والتأهيل والخبرة للتعاطي مع الوضع/ الأزمة، ويتولى الإدلاء بكافة التصريحات وتتبع كل مستجدات الأزمة وتداعياتها والإفصاح عنها.
إن إدارة الأزمة لا تتوقف بمجرد الخروج منها وتجاوز لحظات الذروة بها، وإنما تمتد إلى مرحلة ما بعد الأزمة، وهي المرحلة التي يتم خلالها علاج الآثار والتداعيات الآنية والمستقبلية للأزمة، والاشتغال على إعادة ترتيب الأوضاع ووضع ضوابط لعدم تكرار ما حدث والاستفادة من دروسها لتلافي ما قد يحدث من انتكاسات في المستقبل لا قدر الله.
المبحث الثاني: التجربة المغربية بين التأطير الدستوري ورهان التنزيل.( قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية).
كل المجتمعات مهددة بأن تختل أسس مقوماتها وتهتز دعائمها وأن تمر بظروف استثنائية وأن تعيش أوضاعا طارئة وخاصة، تتمثل في: أزمات اجتماعية، سياسية، اقتصادية… يمكن أن تشكل تهديدا للمؤسسات الدستورية للدولة، أو أن تمس حوزتها الترابية وتصبح خطرا على استقلالها وسيادتها. كما يمكن أن تكون ترويعا لأمن السكان وخطرا يتربص بسلامتهم الجسدية. وفي مثل هذه الظروف يتطلب الوضع نوعا مختلفا واستثنائيا من أساليب التعامل والتعاطي معه يتباين وتلك المعتمدة خلال الظروف العادية، حيث الحاجة ماسة في مثل هكذا أوضاع لإتخاذ تدابير من نوع خاص، غير مألوفة وتشكل استثناء على القواعد المطبقة والسارية المفعول خلال الظروف العادية. وتطبيقا لتلك القاعدة الرومانية القديمة والتي مفادها أن” سلامة الشعب فوق القانون”، أي أنه حينما تكون سلامة الشعب في خطر لا مجال للمحاججة بالقانون، بل هناك مبررات ومسوغات لإتخاذ وتبني إجراءات إستثنائية.
وكما يقول هنري كسنجر: ” إن التاريخ هو ذلك المنجم الزاخر بالحكمة الذي نجد فيه المفاتيح الذهبية لحل مشاكل عصرنا، شريطة أن نعرف وندرك أين نضرب بمعولنا”.
فإدارة الازمات كممارسة ضاربة في القدم، وباعتبارها مظهرا من مظاهر التعامل الإنساني مع المواقف الحرجة والطارئة. وتحسبا لمثل هذه الظروف وتطوراتها المستمرة وتهديداتها المحتملة والمقرونة بتطور المجتمعات الإنسانية وتمدنها وتحضرها، نجد الأنظمة الدستورية والقانونية لجل دول المعمور تتضمن أنظمة استثنائية تمنح السلطات العمومية هامشا للمناورة في مواجهة هذه المخاطر والأزمات، وتسمح لها بامكانية التحرر من التزاماتها الدستورية. إنه بعبارة أخرى ذلك التحرر الدستوري من الدستور والقانون. ففي الزمن الاستثنائي تجد السلطات العمومية نفسها مجبرة على الاشتغال بمنطق التدبير الاستثنائي في تعاملها مع المخاطر والأزمات. وفي هذا الإطار أعلنت السلطات المغربية عن مجموعة من التدابير الاحترازية رغبة في إبقاء فيروس كورونا المستجد متحكم فيه وتحت السيطرة، وقد اتسمت هذه الإجراءات بخاصية التدرج الحذر، حيث ابتدأت مع نقل الطلبة المغاربة العالقين في منطقة ووهان الصينية، مرورا بتعليق الدراسة والإغلاق المؤقت للمساجد، ثم الإعلان عن خلق صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وصولا الى مرحلة إعلان حالة للطوارئ الصحية لمدة شهر بدء من 20 مارس 2020. إذ أصدرت وزارة الداخلية بلاغا للرأي العام بتاريخ 19 مارس 2020 تقرر بموجبه الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من 20 مارس 2020. وهو البلاغ الذي كان أثار نقاشا واسعا حول قيمته القانونية وارتباطاته وامتداداته بالنص الدستوري. فبالرغم من أن كل التدخلات المعلن عنها والتدابير المتخذة كانت تهدف بالأساس إلى محاصرة الإنتشار السريع للعدوى، إلا أن الواقع العملي والممارسة أبانت عن حقيقة النص الدستوري الذي لا يسعف دائما في احتواء وتأطير كل التدابير لرفع تحديات واقع متأزم، فكانت النتيجة أن اتخذ جزء منها تحت غطاء المضمون الدستوري، فيما الجزء الآخر وفق ميكانيزمات من خارج التأطير الدستوري.
المطلب الأول: المعالجة الدستورية للظروف الإستثنائية.
ما تجدر الإشارة إليه بداية، هو ضرورة الإقرار بأن الظروف الاستثنائية داخل الإمتداد المفاهيمي للنص الدستوري ليست كتلة واحدة متجانسة، ومن نوع واحد. بل ذات أسس دستورية مختلفة ومتباينة، وهو ما يجعل حتى تدابير التعاطي والتعامل معها مختلفة ومتباينة تبعا لنوعية وحجم تلك المخاطر التي تطرحها كل حالة على حدة.
فعبر رحلة علمية تحليلية لأحكام الدستور المغربي ومقتضياته، ومن خلال الوقوف عند معجمه المفاهيمي يتضح بشكل جلي أن المشرع الدستوري يتحدث عن ثلاث محطات يمكن أن يصبح الوضع معها خارج الأمور العادية ويتجاوز الإجراءات والتدابير العادية ، إلى تبني تدابير استثنائية وغير مألوفة. وهذه المحطات هي:
فهذه الحالات التي هي بمثابة أنظمة استثنائية تضمنها النص الدستوري وتحدث عن بعضها وحدد مضمونها، وأعرض عن الأخرى، متكفيا بالإشارة إليها دون الحديث عن مضمونها[25]. وبالحلول المباغت لجائحة كوفيد 19 التي اتسمت أسبابها بالغموض، وشح في المعلومات بشأنها حدث نوع من الارتباك، جعل السلطات العمومية المعنية أمام تحدي اختيار وتبني النظام الإستثنائي الأنسب والأجدر للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة وغير المعتادة في سجل الأزمات العالمية بحكم خصوصياتها، ونظرا لكونها تخرج عن سياق الأزمات والمخاطر المعتادة من قبيل: الأحداث السياسية والاجتماعية، أو كوارث طبيعية، أو حروب وتمردات وانقلابات أو انفلاتات أمنية. فخصوصية الأزمة الراهنة أن المجتمع الدولي برمته عبر مختلف بقاع المعمور، يجد نفسه أمام الموت الجماعي في ظل غياب رؤية واضحة ومعلومات كافية حول الوضع الذي يطرح بشكل متسارع ومتواصل أسئلة مقلقة مرتبطة بطبيعة التدابير والوسائل التي من شأنها أن تكون ناجعة لمواجهة التداعيات الخطيرة لهاته الأزمة، وتحصين المجتمع مواطنين ومواطنات ومؤسسات انتاجية من جهة، ومن جهة ثانية الحرص على ضمان الحد الأدنى من دولة الحق والقانون.
وهو الوضع الذي أثار العديد من التساؤلات وطرح الكثير من التكهنات أمام السلطات العمومية المغربية بخصوص مواجهة الأزمة والتصدي لها. إذ هناك من تحدث عن الوسائل الضبطية المعهودة والجاري بها العمل وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية، وهناك من ذهب إلى إمكانية تفعيل حالة الحصار، بالرغم من أنها تثير الكثير من اللبس والغموض في ظل غياب نص قانوني منظم لها ويحدد جوهرها وكنهها، سيما وأن تاريخ المغرب لم يعرف من قبل أية سوابق تطبيقية وممارساتية لحالة الحصار في التجربة المغربية، خلافا لما هو عليه الوضع فيما يتعلق بحالة الإستثناء. ففي ظل هذا الوضع المرتبك عالميا، والذي فرض على السلطات العمومية المعنية، سؤال ما العمل؟ في ظل عدم احتواء المقتضيات الدستورية والأنظمة القانونية لما يكفي من التدابير قصد التعاطي والتعامل مع جائحة من هذا النوع، وبالتالي مواجهة تداعياتها والحد منها.
فأمام هذا الواقع الشاذ، فضلا عن البياضات الدستورية التي تمثلت في عدم اعتراف المشرع الدستوري بمفهوم حالة الطوارئ أو الإحالة عليه بواسطة قانون تنظيمي أو تشريع عادي ، بادرت الدولة المغربية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والمواطنات من هذا الوباء الفتاك، وتم اتخاذ قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، وإلغاء كل أنواع التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، وكذلك الإغلاق المؤقت للمساجد، وصولا إلى فرض الحجر الصحي على المواطنات والمواطنين وعزل المصابين بالوباء عبر بروتوكول علاجي خاص ونظام لتتبع المخالطين، وتم منع التنقل إلا للضرورة القصوى عبر رخص استثنائية تصدرها السلطات العمومية في محاولة للحد من الإنتشار السريع لهذا الوباء الفتاك. كما حاولت الحكومة تجاوز القصور التشريعي في مجال إقرار حالة الطوارئ الصحية ومواجهة تداعياتها من النواحي الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما تم من خلال التدخل لإصدار نصوص قانونية جاءت على الشكل التالي:
- مرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
- مرسوم رقم 293.20.2 بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.
وهو مرسوم بقانون الذي حدد مبررات اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية والإجراءات المتبعة من أجل الإعلان عنها وتمديدها. كما أنه حدد صلاحيات الشرطة الإدارية التي تم تأهيل السلطات العمومية لإتخاذها في سبيل مواجهة تفشي الوباء، فضلا عن تجريمه للمخالفات المتعلقة بحالة الطوارئ وتحديد العقوبات المخصصة لها، وأخيرا تضمن مقتضى بوقف سريان الآجال المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية خلال فترة الطوارئ الصحية على أساس احتسابها من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ مع مراعاة أجال الطعن بالإستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال ومدد الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
الفقرة الاولى: التنصيص الدستوري على حالتي: الحصار والإستثناء.
داخل هذا التمييز الدستوري، ندرج حالتا الحصار والإستثناء، ضمن الإختصاصات الدستورية التي تمارسها المؤسسة الملكية في الحالات والظروف غير العادية. إذ بموجب أحكام الفصل74 من الدستور، يمكن إعلان حالة الحصار l’état de siègeلمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل الا بقانون. وتعد مسألة اعلان حالة الحصار من بين القضايا التي يتداول بشأنها في المجلس الوزاري.
وما يجب الإنتباه إليه في هذا الإطار، هو أن الدستور المغربي من خلال مقتضيات الفصل 74 يتحدث فقط عن حالة الحصار دون الحديث عن مضمونها، وليس هناك لحد الساعة أي مقتضى قانوني ينظم نوعية التدابير المتخذة أثناء الإعلان عن هذه الحالة ويبين الإجراءات المرتبطة بها، خلافا لما هو عليه الوضع في القانون الدستوري المقارن حيث نجد حالة الحصار في فرنسا مثلا منظمة بقانون منذ سنة 1848، وما دسترتها في دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، إلا مسألة واقع قائم.
أما بخصوص حالة الإستثناء l’état d’exception فقد ربط إعلانها الفصل 59 من 2011 من طرف الملك بمقتضى ظهير شريف، وذلك بتحقق شرطين أساسين: أن تكون حوزة التراب الوطني مهددة، أو أن يقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، وذلك باستشارة كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية ، وتوجيه خطاب للأمة.
إلا أن الملك لم يعلن عن حالة الإستثناء في ظل الإنتشار السريع لهذا الوباء القاتل، الذي سبب في شلل شبه عام في حركة الجولان العمومية. الأمر الذي يفهم منه أن عبارة ” تهديد حوزة التراب الوطني” المتضمنة في الفصل 59 من الدستور تفيد ذلك التهديد العسكري بمعناه التقليدي. فالراجح أن دستور 2011 يستبطن فقط مفهوما كلاسيكيا للتهديد المحتمل أن يطال حوزة التراب الوطني، بعيدا عن الأشكال الجديدة من التهديدات المتنامية والتي تأخذ أبعادا تكنولوجية وسيبرانية أو وبائية كما هو الامر مع فيروس كورونا كوفيد 19.
وبالنظر إلى الشرط الثاني، المرتبط بعرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية، والذي هو شرطا واقفا لإعلان حالة الاستثناء، فالأزمة الصحية الراهنة أبانت عن تأثر مؤسستي الحكومة والبرلمان من جائحة فيروس كورونا، وخير دليل على ذلك هو عقد اجتماعات حكومية عن بعد وتسيير أعضاء الحكومة لقطاعاتهم من منازلهم. إلا أن هذا لم يمنع من استمرار مجلس الحكومة من الانعقاد بشكل متواصل عبر الاستفادة من مزايا الرقمنة. وهو الأمر نفسه الذي نهجه العمل البرلماني حيث البعد الرقمي لعب أدوارا ريادية ذهبت حد إقرار التصويت الرقمي.
الفقرة الثانية: حالة الطوارئ وإشكالية البياض الدستوري.
بالرجوع الى الدستور، لا نجد المشرع الدستوري قد خص بالذكر بأي صيغ من الصيغ، ما يشير لإعلان ” حالة الطوارئ “l’état d’urgence” ولا إلى إعلان ” حالة الطوارئ الصحيةL’état d’urgence sanitaires. ، لكن تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الدستور المغربي قد خص السلطات العمومية بأن تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، كما نص على ذلك الفصل 21 من الدستور. وفي هذا الباب يجب التمييز بين حالة الطوارئ كما هي متعارف عليها ضمن الأنظمة الدستورية والقانونية المقارنة، وبين حالة الطوارئ الصحية. فالأولى تثير نوعا من اللبس، حيث نجد مثلا النظام القانوني الفرنسي يميز بين حالة الإستثناء التي ينص عليها الفصل 16 من الدستور الفرنسي، وبين حالة الطوارئ المنظمة بمقتضى قانون يعود لسنة 1955. بخلاف الأنظمة الدستورية والقانونية لدول المشرق العربي، لا نجد هناك شيء تحت مسمى حالة الإستثناء، لكن نجد فقط حالة الطوارئ، والتي من خلال دراسة حيثياتها وشروطها ونظامها نجدها تكاد تنطبق والمقتضيات القانونية المطلوبة والمعتمدة في حالة الإستثناء التي يأخذ بها النظام الفرنسي. أما حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها المغرب فهي مختلفة عن حالة الطوارئ كما هي متعارف عليها في التشريعات الدولية المقارنة، بفارق أنها غير مرتبطة بالخطورة التي تهدد نظام الحكم واستقرار البلاد والسير العادي لمؤسساتها، بقدر ما هي مرتبطة بخطر يهدد الصحة العمومية نتيجة وباء فتاك سريع الانتشار ومعدي.
فهذا الفراغ الدستوري الذي صادف فترة إعلان حالة الطوارئ، هو ما يفسر الارتباك الذي حصل في التعاطي مع وضع هذه الأزمة الصحية، حيث لجأت السلطات العمومية في البداية إلى مباشرة حالة طوارئ غير معلنة من خلال الحد من حركة الناس وتنقلاتهم والتي حددها بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية الصحة ،صدر يوم 18 مارس 2020 في شأن العزلة الصحية، مع استثناءات محدودة وللضرورة القصوى كالتطبيب، الالتحاق بالعمل والتبضع، كما باشرت السلطات العمومية عمليا وميدانيا حث السكان على ملازمة بيوتهم. لتعلن بعد ذلك بيوم واحد، وبشكل رسمي وزارة الداخلية على أن البلاد ستعرف حالة طوارئ صحية ابتداء من 20 مارس 2020 إلى 20 أبريل 2020. إلا أن المرسوم بقانون المتعلق رقم 292.20.2 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لم يعرض على المجلس الحكومي حتى يوم 22 مارس 2020، وهو ما يفيد أن الشروع في تنفيذ حالة الطوارئ عمليا كان خارج الإطار القانوني، وأن النص القانوني جاء لاحقا للفعل ولتأكيد الأمر الواقع.
المطلب الثاني: لجنة اليقظة الاقتصادية: قراءة في التجربة المغربية ودروس المستقبل (السيادة أولا وأخيرا).
لقد أعادت جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 موضوع تدبير الأزمات للواجهة بشكل قوي، فالأمر يتعلق بوباء خطير أفرز حالة شاملة من الذعر والارتباك والذهول، ووضع المجتمعات والدول أمام محك حقيقي تطلب اتخاذ رزنامة من التدابير والقرارات المتسارعة والصارمة والتي اختلفت وتباينت في حدتها وأهميتها ونجاعتها من بلد لأخر. فالوضع مرتبط بأحد التهديدات العابرة للقارات والمتجاوزة للحدود والتي أدخلت العالم بتداعياتها في منحى يتسم بأوضاع اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة وذات انعكاسات صعبة علاقة بالمستقبل في مدييه القريب والمتوسط .
وأسلوب إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، يقوم على توظيف مجموعة من المقومات البشرية والمعلوماتية، التقنية والمالية للحد ما أمكن من تفشي الوضع وخروج تداعيات الأزمة عن نطاق السيطرة وعن الوضع المتحكم فيه. وهي مسألة تزاوج بين العلم والفن، وتتأسس على مقاربات وقائية وأخرى علاجية.
فإلى أي حد استطاعت السلطات العمومية المغربية رفع هذا التحدي؟ وكيف السبيل لذلك؟
ثمة مثل شائع يقول: “الشدائد تصنع الرجال”. وبالفعل، جعلت جائحة فيروس كورونا الكثير من قادة الدول عبر مختلف ربوع المعمور يواجهون وقتا حرجا وتحديات ثقيلة تهدد أرواح ملايين البشر ما لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة ومنسقة لمواجهتها. فالأزمة العالمية لا طريق سهل يكفل الخروج منها إلا من خلال تبني استراتيجية مثلى للتعامل مع الوباء من جهة، وكذا الحرص على بث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمواطنات واقناعهم باتباع أوامر السلطات المعنية. لذلك فالأمر في غاية الحساسية وقد تقود أية خطوة غير محسوبة وخاطئة إلى تقويض الثقة في السلطات، وإطلاق العنان لاضطرابات من شأنها تعميق المخاطر القائمة بفعل الوباء.
وفي كتاب لخبير العلوم السياسية الهولندي” أرين بوين” تحت عنوان:” سياسة إدارة الأزمات” حدد هذا الخبير مجموعة من الخطوات التي اعتبر أنه من الضروري أن تتضمنها أي استجابة فعالة للمخاطر والأزمات، والمتمثلة في:
- الإدراك السريع للخطر الذي يتهدد المجتمع، والوضع المثالي في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف ووضعها موضع التطبيق على وجه السرعة وبدون تأخير.
- وعند مرحلة اتخاذ الإجراءات العملية، يصبح القائد بحاجة إلى أن يحدد بدقة إلى أي حد يستطيع الاعتماد على تعاون المواطنين عبر الإقناع، ومتى يتوجب عليه المضي إلى ما هو أبعد، والانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة يطلق عليها اسم “القيادة والتحكم”، والتي يسعى من خلالها لتوظيف كل ما هو متاح من موارد للتعامل مع الأزمة.
فالمغرب، وفي إطار المجهودات الاستباقية لمواجهة الإنعكاسات والتداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على الاقتصاد الوطني، تم إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية CVE والتي أنيطت بها مهمة تتبع انعكاسات هاته الجائحة والإجراءات المواكبة لذلك. فهي اللجنة التي تشتغل من جهة على رصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن هذه الأزمة الصحية العالمية.
وقبل التفصيل بشكل أكثر في أشغال ومنجزات لجنة اليقظة الاقتصادية كقراءة في التجربة المغربية لإدارة الأزمات وتدبير المخاطر، نعرج لتوضيح مفهوم اليقظة وسيماته الأساسية.
الفقرة الأولى: مفهوم اليقظة.
اليقظة كلمة مشتقة من اللفظ اللاتيني (Vigilia) والذي يفيد القيام بالحراسة والمراقبة حفاظا وحرصا على منطقة ما أو قطاع معين.[26] وهو مفهوم عرف سجال فكري بسبب تعدد تعاريفه واختلاف دلالاته، الأمر الذي أفضى لاختلاطه بغيره من المصطلحات ذات الحمولة الدلالية قريبة المعنى، وبالتالي عدم استقلالية حدوده المعرفية، ولعل أبرز مظاهر هذا التداخل جعل مفهوم هذا المصطلح مرادفا لمضمونه تارة، ومفسرا لغايته تارة أخرى.[27]
وبرز مصطلح اليقظة بشكل عام خلال العشر سنوات الأخيرة، ضمن مختلف الحقول المعرفية والعلمية التي تعنى بعمليات البحث ومعالجة ونشر المعلومات التي تغطي مجالات عديدة كالمنافسة والتكنولوجيا والاقتصاد، فشكلت اليقظة كمفهوم محور تقاطع العديد من المجالات العلمية والتخصصات المختلفة.[28]
فاليقظة لغة، انتباه وصحوة وهي عكس الغفلة، وتعني أن الشخص تيقظ وأخذ حذره.[29] واليقظة أو التيقظ تطابق حالة الوعي أين تكون حواسنا منفتحة على العالم من حولنا، أي الانتباه لكل ما يحيط بنا وأخذ الحيطة منه.[30] أما اليقظة اصطلاحا فتعرف بأنها ” كل الأفعال الهادفة للرصد المستمر أو غير المستمر للإشارات ،مهما كانت درجة قوتها أو ضعفها القابلة لأن تجعل المؤسسة أو مؤسسات المجتمع وقطاعاته في رمتها قادرة على متابعة التجديد ومواكبة وخلق ميزة تنافسية تسمح لها أو للدولة بالتكيف مع تحولات المحيط. أي بعبارة أخرى هي نشاط ذو بعد استراتيجي يسعى إلى البحث بشكل استباقي لمواكبة التغيرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية من أجل خلق الفرص والحد من المخاطر.[31]
فاليقظة المتوخاة بالنهاية هي تلك المصحوبة ضمنيا بالطابع الاستراتيجي ذو الخاصية الإبداعية التي تسعى لدراسة وتفسير الإشارات المبكرة للخطر أو لوقوع أزمة بمختلف أصنافها وأنواعها، هدفا في معالجتها عبر صياغة وخلق رؤية إبداعية وليس وصف للأحداث السابقة. أي أن اليقظة الاستراتيجية بعبارة أخرى استشعار وتنبؤ زمني لاحتمالية الأثر الذي يمكن أن تحدثه المتغيرات والعوامل البيئية في منظمات المجتمع ومؤسساته.[32]
كما أنها تتميز بكونها نظرة مستقبلية متوسطة وبعيدة المديين، حيث أن المجال الحقيقي لتنزيل اليقظة الاستراتيجية وتطبيقها هو المستقبل، أي أنها تنفذ عبر خط زمني تصاعدي يبدأ من الآن ويمتد مستقبلا لسنوات طويلة. فالأمر يتطلب الإدراك بأننا نتعامل مع ظاهرة مستقبلية تبدأ من الوقت الحاضر وتتحقق نتائجها في المستقبل البعيد.[33]
الفقرة الثانية: لجنة اليقظة الاقتصادية: من الأزمة إلى الفرصة.
تجدر الإشارة بداية إلى أهمية ونجاعة المقاربة التي اعتمدتها الدولة المغربية لمواجهة وباء كورونا كوفيد 19، إذ بتعليمات ملكية واشراف ملكي مباشر اتخذت حزمة من التدابير التي كانت في غاية الأهمية والتي ساهمت في تجنيب البلاد الكثير من المخاطر والأوضاع السيئة لتداعيات هاته الجائحة والتي عاشتها العديد من بلدان المعمور ودول الجوار.
فالمغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أولت العناية الخاصة وبأولوية بالغة لسلامة الأشخاص ولضمان الأمن الصحي. وهو ما تجسده مجموع المبادرات والتدخلات المتخذة، والتي اتسمت بالانسجام والتكامل في إطار يوازي بين الحرص على الحفاظ على مبدأي الشرعية والمشروعية في كل الخطوات المتخذة. فضمانا لمبدأ الشرعية، سهرت الحكومة على إعداد مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية [34]، وإجراءات الإعلان عنها اعتمادا على مقتضيات الدستور وأحكامه.[35] واعتمادا على مقتضيات مرسوم القانون هذا، صدر مرسوم متعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني.[36]
وقد اتخذت السلطات العمومية أيضا مجموعة من الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية في تقديم خدماتها للمرتفقين، إلى جانب التدابير المتعلقة بتنقل الأشخاص والبضائع قصد تأمين الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية الضرورية والأساسية للحياة اليومية للأفراد والمؤسسات.
وتنفيذا للتعليمات الملكية تم إحداث صندوق خاص لمواجهة جائحة كورونا، وبادرت مجموعة من المؤسسات العمومية والمقاولات والجمعيات والأشخاص الذاتيين والاعتباريين للمساهمة في تمويله، تعبيرا عن قيم التضامن وروح التكافل بين مختلف مكونات المجتمع المغربي. وهي مبادرات وطنية مسؤولة ومواطنة، إذ فضلا عن كونها واجب شرعي وأخلاقي، فإنها واجب دستوري طبقا لمقتضيات الفصل 40 من دستور المملكة.
فالمواطنة الحقة تفترض الالتزام بالواجبات بالموازاة مع التمتع بالحقوق، وهو الأمر الذي يتطلب انخراط جميع مكونات المجتمع إلى جانب السلطات العمومية في مواجهة تداعيات هذه الأزمة الصحية ومعالجة آثارها ونتائجها السلبية. وطبقا للمقتضيات الدستورية، يقع على عاتق جميع المواطنين والمواطنات واجب المساهمة في تحمل التكاليف التي تتطلبها مسألة التصدي لآثار الجائحة والحد من مخلفاتها، والتكاليف التي تفرضها تنمية البلاد والتي تختلف مستويات المساهمة فيها تبعا لاختلاف الوسائل التي تتوفر عليها كل جهة أو شخص. فالأشخاص والجهات التي تتوفر على وسائل وإمكانيات أكبر، يجب أن تكون مساهمتها متناسبة مع ما تتوفر عليه وتمتلكه، كما بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على إمكانيات متوسطة يجب أن يساهموا بما يتماشى وما لديهم من وسائل وإمكانيات. وفيما يخص الأشخاص الذين لا يتوفرون على إمكانيات تسمح لهم بالمساهمة المادية في تمويل التدابير المالية في مواجهة هذه الجائحة الصحية، فيجب عليهم المساهمة على الأقل بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية واحترام التدابير الاحترازية من تباعد اجتماعي وغيرها والتي من شأنها الحد من الانتشار السريع للعدوى والوباء. فالتزام المنازل خلال فترة الحجر الصحي، وكذا اتباع نصائح السلطات الصحية العمومية بعد تخفيف اجراءات الحجر الصحي من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات بالشكل الصحيح وغيرها من باقي التدابير الاحترازية هو في حد ذاته مساهمة إيجابية، تنم عن مسؤولة ومواطنة تخدم الأمن الصحي للمجتمع. والدولة مسؤولة بطبيعة الحال عن اتخاذ القرارات اللازمة لضمان دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية التي تسعى آنيا من أجل محاصرة الوباء والحفاظ على السلامة الصحية والجسدية للمواطنين، والتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على بعض القطاعات الاقتصادية. إلا أن رهانات المستقبل على المدي المتوسط والبعيد، تفرض علينا جميعا وعلى صناع القرار والسياسات العمومية بشكل خاص، التفكير في حلول إبداعية وابتكارات ذكية من اجل إعادة النظر في أولويات السياسات العمومية ورد الاعتبار للقطاعات الاجتماعية. وفي هذا السياق، من الضروري التنويه بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية علاقة بدعم الأشخاص الذين توفقوا عن العمل جراء الجائحة بفئاتهم المختلفة من منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا المسجلين في نظام التغطية الصحية “رميد” وأيضا حتى الأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة “رميد”. هذا فضلا عن باقي التدابير والإجراءات الأخرى التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الآثار السلبية لحالة الطوارئ الصحية، والتي جاءت تباعا عبر اجتماعاتها المتعددة التي ناهزت ثمان اجتماعات وفق خطة عمل مسطرة إلى حدود نهاية يونيو 2020 والتي همت بالأساس:
- تعليق أداء المساهمات الاجتماعية (مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.)
- تأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات.
- تدابير لفائدة المأجورين من خلال استفادة المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوفقون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة من تعويض شهري ثابت وصافي قدره ٢٠٠٠ درهم.
- تدابير لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات.
- تدابير ضريبية. (يمكن الرجوع بشأن هذه التدابير لبلاغات اجتماعات لجنة اليقظة الاقتصادية).
- وضع رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة كوفيد 19 قرض بدون فائدة في حدود 15000 درهم.
- توسيع الاستفادة من آلية ضمان أكسجين لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تراجعت أنشطتها.
فهذه بعض من الإجراءات والقرارات والترتيبات المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية على المدى القصير للتصدي للآثار المستعجلة الناجمة عن الأزمة الصحية. إلا أن هذه الاجراءات وكيفما كانت طبيعتها، فهي لا تعفي من ضرورة الإبداع في أشكال تضامنية مجتمعية بين مختلف مكونات المجتمع وهيئاته، حيث في مثل هكذا ظروف من الضروري استحضار المصلحة العامة ومصلحة الوطن وجعلها فوق كل الاعتبارات في ظل الاشتغال وفق نكران تام للذات، وبعيدا عن كل الحسابات الضيقة. فعبر الالتزام بالتدابير الصحية ورفع منسوب التضامن المجتمعي يمكننا الخروج منتصرين من هذه الأزمة العالمية المتربصة بنا، غير مسبوقة والمباغتة.
فالعالم اليوم يعيش على وقع مواجهة أزمة كورونا وما بعدها، وعيونه مركزة على المنحى السلبي الذي تسجله المؤشرات الاقتصادية والتدهور الذي تسير في اتجاهه الأوضاع الاجتماعية في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخل الفردي وانحساره. وفي سياق هذه البيئة الدولية المطبوعة بعولمة المخاطر وكونيتها ومضاعفة التهديدات، يجد المغرب نفسه مقبل على مواجهة تداعيات هذه الأزمة العالمية عبر مجابهة تداعيات اقتصادية واجتماعية، تفرض عليه إعادة رسم اختيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترتيب أولويات استراتيجية جديدة عنوانها العريض والمركزي السيادة أولا وأخيرا. إنها السيادة الاقتصادية في قطاعات حيوية مختلفة من أجل تكريس وتعزيز الجاهزية والاستعداد اليقظ لمجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة. رغم الظروف القاسية التي تخلفها الأزمات والمخاطر، فإنها تشكل مع ذلك محطة أساسية ومحكا حقيقيا لاستنباط العبر والدروس وإعادة ترتيب سلم الأولويات وبناء الخطط والاستراتيجيات الكفيلين بتحصين المستقبل. وفي سياق مواجهة تداعيات الأزمة الصحية الراهنة على المستوى الوطني وفي أفق إعداد وبلورة نموذج تنموي جديد، تدعو الضرورة إلى ترسيم تحولات نوعية في هيكل الاقتصاد المغربي، سيما وأن الأزمة كشفت يشكل جلي على أن أهم سلاح يمكن للدول والمجتمعات أن تراهن عليه في التصدي لمختلف المخاطر والأزمات المستجدة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية… تتجسد في التعليم والبحث العلمي، باعتبارهما كفيلان بترسيخ العقلنة داخل المجتمع وبناء مواطن محصن قادر على المساهمة في تحقيق التنمية بمفهومها الاستراتيجي والشامل. تلك التنمية التي قوامها تحقيق السيادة الغذائية عبر وضع نصب أعيننا أهداف ملموسة لرفع رهان تحقيق الأمن الغذائي عبر التوجه تدريجيا نحو الاكتفاء الذاتي في الحبوب، فضلا لما تقتضيه السيادة الغذائية من توجيه الانتاج الفلاحي المغربي نحو احتياجات الطلب المغربي والعمل على تطوير القيمة المضافة لصادرات الصناعة الغذائية.
وعلى مستوى السيادة الصناعية، فالأولوية يجب أن تنصب نحو تطوير البنيات الطبية وجعلها في مستوى تحديات الأزمات والأوبئة الخطيرة عبر اعتماد وتبني بنية صناعية منسجمة باعتبارها كأرضية ودعامة حقيقية لإرساء مقومات السيادة الصناعية في المجالات الحيوية التي ترتبط بالحفاظ على الحياة وعلى البيئة وحقوق الأجيال المقبلة. ومن ضمن أسسها الداعمة التأصيل لسيادة صحية قادرة على التكيف من أجل الظفر بصنع مغربي للمعدات الطبية والسلاسل الدوائية، في إطار تنزيل برامج طموحة للذكاءين الاقتصادي والصناعي وتأهيل الإمكانات البشرية والقدرات العلمية والتكنولوجية لخدمة القيمة الصناعية المضافة من خلال مقاربة مندمجة للإقلاع الاقتصادي عوض المقاربات القطاعية المنغلقة.
فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية ليست مرتبطة فقط بالأزمة الصحية الراهنة بل هذه الأخيرة فقط عرت الوضع وشكلت لحظة مكاشفة بشكل عميق للوضع العادي داخل إطار زمني استثنائي وطارئ. أما أصل المشكل فإنه متجذر وذو روافد متعددة ومتباينة تصب في طبيعة النموذج المغربي المعتمد واختلالاته. وما الأزمة الصحية الراهنة إلا لحظة مفصلية وناقوس إندار يوحي بالحاجة الملحة لاعتماد مراجعات كبرى وعميقة داخل حقل الإقتصاد السياسي من أجل فتح المجال أمام فرص جديدة عنوانها استخلاص الدروس والعبر والاستفادة من التجارب والفواجع المؤلمة وتحويلها لفرص حقيقية.
بعبارة أخرى يمكن القول وكختام لهذه المساهمة العلمية المتواضعة، أنه إذا كانت أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 مجرد ظرف عابر وطارئ، سيمضي وتعود الحياة لمجراها الطبيعي والعادي، فإن تداعياته تشكل معالم مغرب آخر سيما على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. فإذا كان الوباء قد استطاع أن يشل مقومات الاقتصاد العالمي، ومعه أن كبد الاقتصاد الوطني خسائر مهمة ذات تأثيرات جمة ومكلفة اجتماعيا، إلا أن هذه الأزمة الصحية الراهنة وضعت بالموازاة مفهوم الدولة على محك المساءلة أمام الاكراهات والتحديات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية، وأعادت إلى واجهة الأحداث ضرورة الاهتمام بالدولة ليس كمفهوم فلسفي مرن، بل كفاعل حيوي ذو التأثيرات الفعلية والمحورية في قطاعات حيوية وأساسية من متطلبات العيش الكريم للمواطنين. وهو ما يطرح العنان للتفكير بمنطق إبداعي في مفهوم الدولة وفعلها على ضوء المعطى الاجتماعي وفق تشكيلاته الجديدة التي ساهمت الجائحة في الكشف عنها، بعيدا عن فلسفة تهميش القطاع العام وتأزيمه والتمادي في سياسة الخوصصة وما أفرزته من تفقير للدولة وتقديمها قربانا للمؤسسات المالية الدولية عبر التخلي عن منشآت القطاع العام ومؤسساته، والتي تشمل اسس ودعامات الدولة في لحظة الأزمات والمخاطر. فبالرغم من الصدى الإيجابي للعديد من الإجراءات المتخذة من أجل التصدي لتفشي الوباء، إلا أن ذلك يمنع من تمظهرات اتسمت بارتجالية الحكومة في التعاطي مع هذه الظرفية الصحية الصعبة، وهو ما يزكي غياب رؤية واضحة مكتملة الجوانب والمقومات للتعامل مع هكذا نوع من الأزمات والمخاطر. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى ضرورة إحداث وكالة وطنية لتدبير المخاطر تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وذات الصلاحيات الواسعة في مجابهة الكوارث ذات الطابع وليست الطابع الخاص كما هو عليه الأمر بالنسبة لصندوق الكوارث الطبيعية الذي أنشئ أواخر السنة الماضية، والذي جاء يخص كوارث طبيعية محدودة في الزمان والمكان، وغير مؤهل لتغطية أزمات صحية بحجم جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، الذي يبقى الصندوق الوحيد الذي بمقدوره تتبع تأثيرات وتداغيات الأزمة الصحية ، هو الصندوق المعلن عنه من قبل جلالة الملك نصره الله الخاص بتدبير جائحة كورونا ، والموضوع تحت إشارة وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
[1] أحمد ابراهيم أحمد: إدارة الأزمات: الأسباب والعلاج، القاهرة، دار الفكر العربي،2002، ص: 35.
2 زينب موسى مسك: واقع ادارة الأزمات واستراتيجيات التعامل معها، مذكرة ماجستير في ادارة الأعمال، كلية التمويل والإدارة، جامعة الخليل، 2011 ص: 13.
[3] بسعود بشير: أثر تطبيق المناجمنت على نجاعة ادارة الأزمات من خلال نشاط الحماية المدنية، مذكرة ماستر قسم علوم سياسية / تخصص إدارة الموارد البشرية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،2016 -2017، ص: 14.
[4] د. يوسف أحمد أبو فارة: إدارة الأزمات مدخل متكامل، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، جامعة القدس المفتوحة، فلسطين، 2009، ص 21
[5] ربحي عبد القادر الجديلي: إدارة الأزمات، عبر الموقع الإلكتروني HRDISCUSSION.COM_189059808 ص 2و3.
[6] د. يوسف احمد أبو فارة: مرجع سابق، ص: 22و23.
[7] نفس المرجع، ص: 21.
[8] نفس المرجع.
[9] فيصل بغدادي: دور القيادة في إدارة الأزمات في المنظمة، مذكرة ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية/ تخصص إدارة وحكامة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 2013- 2014، ص: 41.
[10] حامد عبد حمد الدليمي: إدارة الأزمات في بيئة العولمة، أطروحة دكتوراه في إدارة المشاريع، جامعة العراق 2007-2008، ص: 68.
[11] لواء دكتور محمد صالح سالم: إدارة الأزمات والكوارث (بين المفهوم النظري والتطبيق العملي)، الطبعة الأولى، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، مصر 2005، ص: 43.
[12] د. محمود جاد الله: إدارة الازمات، دار أسامة للنشر والتوزيع، طبعة 2010، الأردن، عمان، ص: 16.
[13] عليوة السيد: صنع القرار السياسي في منظمات الإدارة العامة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1997، ص: 251.
[14] أحمدا براهيم أحمد: مرجع سابق، ص: 32و 33.
[15] عشماوي سعد الدين: إدارة الأزمة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد الخامس، العدد الثاني، الإمارات، 1996، ص: 199.
[16] الأعرجي عاصم محمد و د. قاسمة مأمون محمد: إدارة الأزمات: دراسة ميدانية لمدى توافر عناصر ادارة الأزمات من وجهة نظر العاملين في الوظائف الإشرافية في أمانة عمان الكبرى الرياض، معهد الإدارة العامة مجلد 39، العدد الرابع، 2000 ص: 777.
[17] Maryanne A. Waryjas :Effictive Crisis Management, Katten Muchin Zavis Rosenman, May 1999, p : 1.
[18] سورة البقرة، الآية 269.
[19] أبو شامة عباس: إدارة الأزمة في المجال الأمني، الإمارات، شرطة الشارقة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد الرابع، العدد الثالث، 1995، ص: 300.
[20] الحملاوي محمد رشاد: إدارة الأزمات: تجارب محلية وعالمية، مكتبة عين شمس، القاهرة، الطبعة الثانية، 1995ص: 62- 63.
[21] انظر الفقرة التاسعة من الفصل 49 من الدستور.
[22] أنظر الفصل 59 من الدستور.
[23] انظر الفقرة الثامنة من الفصل 49 من الدستور.
[24] مريم بالحاح: اليقظة الاستراتيجية ضرورة حتمية للاستمرار في البيئة المعاصرة، جامعة تلمسان، مجلة اقتصاديات المال والاعمال، 2017، ص: 196.
[25] فالتة اليمين: اليقظة وأهميتها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مذكرة دكتوراه في تسيير المؤسسات، قسم علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013، ص: 48.
[26] أحمد بوربالة: دور اليقظة التكنولوجية في تحسين تنافسية المؤسسة، مذكرة ماستر في التسيير الاستراتيجي للمنظمات، فرع تسيير المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2015، ص: 3.
[27] نصيرة علاوي: اليقظة الاستراتيجية كعامل للتغيير في المؤسسة، مذكرة ماجستير في تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2011، ص: 82.
[28] د.عبد الباري ابراهيم درة، و د.ناصر محمد سعود جرادات: الإدارة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين (النظرية والتطبيق)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان، 2014، ص: 307.
[29] Lesca. H et Blanco. S : Contribution à la capacité d’anticipation des entreprises par la sensibilisation aux signaux faibles, 6 congrès international francophone sur la PME, université Pierre Mendès, France, Octobre 2002, HEC, Montréal, p : 1.
(30) LESCA,H. Veille stratégique, concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise. Guides pour la pratique de l’information scientifique et technique. Ministère de l’Éducation Nationale, de la recherche et de la technologie, Université de Grenoble 2, p :1.
[30] LESCA, H. Veille stratégique, concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise. Guides pour la pratique de l’information scientifique et technique. Ministère de l’Éducation Nationale, de la recherche et de la technologie, Université de Grenoble 2, p :1.
[31] أحمد بوربالة: مرجع سابق، ص: 5.
[32] د. هاني أحمد الضمور، و د. أحمد عطا الله القطامين: الإدارة الاستراتيجية، الطبعة الأولى، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات للنشر والتوزيع، القاهرة، 2013، ص: 13.
[33] مرسوم بقانون رقم 296.20.2. الصادر في 28 من رجب 1441(23 مارس 2020)، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الإعلان عنها. الجريدة الرسمية، عدد 6867 مكرر، بتاريخ 24مارس 2020، ص: 1782.
[34] أنظر الفصول 21والفصل 24 الفقرة الرابعة، والفصل 81 من الدستور.
[35] مرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 24 مارس 2020، ص: 1783.
[36] انظر اجتماعات لجنة اليقظة الاقتصادية.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية