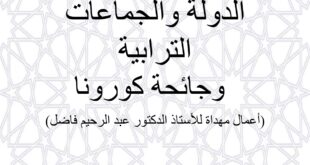ضمانات استقلالية للمجلس الوطني لحقوق الانسان على ضوء القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ــ
المهدي بوكيو
باحث في سلك الدكتوراه
بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا
المقدمــــة:
تستوجب مبادئ باريس توفر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على موارد كافية تكفل لها الاستقلالية التامة عن باقي الهيئات والمؤسسات الأخرى، والاستقلال هو ما يميز هذه المؤسسات عن مختلف الهيئات الحكومية، إلا أنه لا يعني انعدام أي رابط أو صلة بينها وبين الدولة وهذا ما يميزها عن باقي هيئات المجتمع المدني. والاستقلالية معيار أساسي لنجاح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلا أنه الأصعب في التحقيق، إذ أن ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتلقاها من طرف الدولة ما يطرح عدة إشكالات، فكيف لها أن تكون مستقلة خصوصا في البلدان التي تنتهك فيها حكومتها حقوق الإنسان، إلا أن هذه الحكومات نجدها تمول مؤسسات أخرى مستقلة منها المحاكم والمراجعون العامون للحسابات، وبما أن هذه المؤسسات مستقلة في معظم الدول فإن مسألة تمويل الدولة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا تتنافى مع استقلالية هذه الأخيرة.[1]
ومما لا شك فيه أن المؤسسة الوطنية الناجعة هي التي تتمتع بحرية التحرك، بعيدا عن ضغوطات الحكومة، دون أن يعني ذلك غيابا كاملا للعلاقات مع الدولة، فالقانون هو الذي ينظم عمل المؤسسة الوطنية، ونطاق عملها وعلاقاتها مع الدولة، بل ويمنحها الحصول على مساعدة الشركاء، ولا سيما السلطات العمومية، وحتى تتسم المؤسسة الوطنية بالاستقلال المالي فإنه يستلزم عليها أن تكون ميزانيتها متميزة عن ميزانية باقي فروع السلطات والأجهزة الأخرى، وعلاوة على ذلك فإن من عناصر الاستقلالية تحديد المؤسسة الوطنية لنظام طريقة تعيين الأعضاء، ومميزات الاختيار، ومدة التعيين واحتمال تجديدها، والاقالة، والامتيازات والحصانة،[2] فكل هذه العناصر وغيرها يمكن أن تشكل ضمانات ضرورية لاستقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتطلب في المؤسسة الوطنية أن تكون منشأة بموجب القانون، ويحدد القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية صلتها بالدولة كما يحدد الحدود التي تمارس المؤسسة الوطنية عملها في إطارها وجميع المؤسسات هي مفيدة بالضرورة بروابطها مع الدولة وباختصاصاتها التشريعية، وتتجلى فعالية المؤسسة الوطنية في أن تستطيع التصرف مستقلة عن الحكومة وجميع الهيئات والكيانات الأخرى، التي قد تكون في وضع تستطيع من خلال أن تؤثر على عمل المؤسسة، وحصول المؤسسة الوطنية على قدر من الاستقلال في العمل هو أمر يميزها بحد ذاته عن الآليات الحكومية المعنية بموضوع حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى فإن استقلال المؤسسة الوطنية لا يعني أبدا عدم وجود أي رابط لها بالدولة، كما سبق الذكر. ويمكن اعتبار أن هناك حقائق أخرى تمنع الاستقلال التام منها الالتزامات بتقديم التقارير وعدم التمتع باستقلال مالي كامل، وفي الواقع فإن هذه الأسس التشريعية المنظمة للمؤسسة الوطنية وكذا القيود المصاحبة لها، هي التي تجعلها في وضع يميزها عن المنظمات غير الحكومية، ومن تم فإن الصلة بين الاستقلال المالي والاستقلال القانوني هي صلة قوية، فالمؤسسة الوطنية التي لا تتمتع بالاستقلال المالي ستكون تابعة لأحد القطاعات الحكومية مما يفقدها الاستقلالية. وينبغي حيثما أمكن، تحديد مصادر وطبيعة تمويل المؤسسة الوطنية في قانونها المنظم، وينبغي لدى صياغة هذه الأحكام ضمان قدرة المؤسسة ماليا على أداء وظائفها الأساسية. ومن تم ستتمتع المؤسسة الوطنية في أحسن الأحوال، بقدر معين من الاستقلال الذي ينبغي دراسة آثاره من خلال السياق العام القائم.
المطلب الأول: الاستقلال القانوني.
نصت مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية على أن تكون المؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها. وبالنسبة للمجلس الوطني فقد تم إحداثه بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 ربيع الأول 1432 الموافق لفاتح مارس 2011، كما تم التنصيص عليه في الدستور في الفصل 161 باعتباره كمؤسسة دستورية مهمتها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ونجد هنا أن النص الدستوري والقانوني المحدث للمجلس يعتبره شخصية اعتبارية يسمح له باتخاذ قراراته بشكل مستقل، ويقوم بأداء وظائفه بدون أي تدخل من أي فرع من الحكومة أو أي هيئة عامة أو خاصة، وبوضعه كمؤسسة دستورية مستقلة فهي ليست تابعة إداريا لأي قطاع وزاري أو حكومي، ولها الاستقلال الإداري في تدبير شؤونها اليومية باستقلال تام عن أي جهة أخرى وكذا القدرة على وضع أنظمتها الداخلية وإصدار التقارير والتوصيات بشكل مستقل كما سنرى:
أولا: الطبيعة الدستورية والقانونية.
نص الفصل 161 من الدستور، وكذلك المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى مهمة النظر في جميع القضايا التي تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها، والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في حرص تام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
كما نصت المادة 3 من نفس القانون على أن المجلس يعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي، وتسري عليه أحكام القانون المنشأ له، والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا للدستور والمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لا سيما مبادئ باريس، ومبادئ بلغراد المتعلقة بالعلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.
وبهذا نجد القانون المنشئ والمنظم للمجلس يعتبر عنصرا حاسما في تأمين استقلاله القانوني، لا سيما استقلاله عن الحكومة، ويضع المجلس في الوضع الأمثل، بمنح المجلس شخصية قانونية منفصلة وميزة ذات طبيعة تسمح له بممارسة سلطته صنع القرارات على نحو مستقل. وهذا المركز القانوني المستقل للمجلس يكفي لتمكينه من أداء وظيفته بدون تدخل من أي جهاز حكومي أو من أي هيئة كيفما كانت، ويمكن تحقيق ذلك الاستقلال بأن يكون المجلس مسؤولا مباشرا أمام البرلمان والملك كما سنرى لاحقا.
ثانيا: الاستقلال الإداري.
يتجلى الاستقلال الإداري في قدرة المؤسسة الوطنية على إدارة شؤونها اليومية على نحو مستقل عن أي فرد أو منظمة أو إدارة أو سلطة. والمؤسسة الوطنية الفعالة تضع نظمها الداخلية الخاصة، ولا تخضع هذه النظم لأي تعديل خارجي، كما لا تخضع توصياتها أو تقاريرها أو قراراتها للمراجعة من قبل سلطة أو هيئة أخرى باستثناء ما يكون منصوص عليه في قانون الانشاء. وبالنسبة للمجلس الوطني فقد حدد القانون المتعلق بإعادة تنظيمه(2018)، صلاحية إعداد النظام الداخلي للمجلس وأعطاها حصرا لرئيس المجلس الذي يعد النظام الداخلي ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه، وذلك عكس ما كان عليه القانون السابق المحدث للمجلس الذي نص في المادة 45 على ربط مسألة نفاذ مشروع النظام الداخلي، وكذا تعديله بمصادقة الملك عليه، وهو ما اعتبره البعض تضييق على حرية المجلس في وضع نظامه الداخلي.[3]
وتشير إلى امتلاك السلطة القانونية لإجبار الأخرين على التعاون، وعلى وجه خاص الإدارات الحكومية، هو شرط أساسي آخر للاستقلال الإداري الكامل للمؤسسة الوطنية التي تمتلك سلطة التحقيق في الشكايات، ويكون في هذه الحالة القانون التأسيسي للمؤسسة الوطنية مفيدا لتحديد الظروف التي يمكن فيها اجبار الهيئات الحكومية على التعاون مع المؤسسة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن ينص القانون على أنه ينبغي لجميع الموظفين والمسؤولين والسلطات العمومية تسهيل عمل المؤسسة، بما في ذلك الرد على طلباتها للحصول على معلومات ومساعدتها في التحقيقات.
وتمثل هذه السلطة القانونية في قدرة المؤسسة الوطنية على أداء عمل معين أو على تكليف فرد أو هيئة أخرى بأدائه وينبغي أن تكون السلطة قابلة للتنفيذ، ومن تم فإن سلطات المؤسسة الوطنية ينبغي أن تكون محددة بموجب قانون وتتضمن فرض عقوبات قانونية أو إدارية في حالات المس باستقلالية المؤسسات الوطنية في ممارسة سلطتها، هذا ما نراه بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، الذي تضمن في المادة 5 على أن تكون كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيامه بأعماله، من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة، دون مراعاة للمقتضيات القانونية الجاري العمل بها، موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.
ثالثا: طبيعة وحدود مسؤولية المجلس الوطني.
إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ليست غاية في حد ذاتها، وستكون قوية أو متواضعة وفقا لإنجازاتها فقط. وتتطلب الفاعلية المؤسسية وضع نظام المساءلة على أساس أهداف محددة يمكن التحقق منها. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لأساسها التشريعي، مسؤولة قانونيا وماليا أمام الدولة أو البرلمان، ونجد أنه عادة ما ينفذ الجانب المتعلق بالمساءلة من خلال التقارير الإلزامية. فالمؤسسات الوطنية يطلب منها على وجه عام تقديم تقارير تفصيلية عن أنشطتها على البرلمان للنظر فيها. وينبغي للمؤسسة الوطنية أن تكون مسؤولة أيضا بصفة مباشرة أمام العملاء، أي الجماهير المستفيدة منها والتي أنشئت من أجل مساعدتهم وحمايتهم. ويمكن تحقيق المساءلة أمام الجمهور بعدد من الطرق منها على سبيل المثال، إلزام المؤسسة الوطنية بإجراء تقييمات علنية لأنشطتها وتقديم تقارير عن نتائج التي أنجزتها. وينبغي بالطبع إخضاع جميع التقارير الرسمية للمؤسسة للتدقيق والتعليق على نحو علني، وعندما تشجع المؤسسة الوطنية على إجراء مناقشة علنية فإنها، تخلق باعثا على التفوق الداخلي كما تضمن أن يكون الجمهور على علم بأنشطة المؤسسة وبمعايير الإنجاز الموضوعة، والشفافية من خلال تعميم المنشورات والتقارير، وكل هذا سيؤدي لا محال إلى تعزيز المصداقية الخارجية للمؤسسة، ونظرا للصلة الأساسية لكل هذه الالتزامات بالمساءلة فإنه ينبغي أن ينص عليها صراحة في القانون التأسيسي للمؤسسة الذي ينبغي أن ينص بأكبر قدر ممكن من التفصيل على النقط التالية:
- تواتر إعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان.
بالنسبة للمجلس الوطني فإن المادة 5 من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.18.17،[4] الخاص باختصاص المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان قد نصت على أن المجلس ينجز تقارير تضم خلاصات ونتائج، الرصد أو التحقيقات أو الحريات التي يقوم بها ويرفعها إلى الجهات المختصة مشفوعة بتوصيات.
أما المادة 11 من نفس الظهير فقد مكنت المجلس من اختصاص نوعي وهو مراقبة أماكن الاعتقال والمؤسسات الحبسية ومراكز الطفولة ومراكز الأمراض العقلية، وعليه يتوجب إعداد تقارير دقيقة بهذا الشأن تتضمن ملاحظات وتوصيات يتم رفعها إلى الجهة المختصة.
أما المادة 35 فقد نصت على أن المجلس يرفع اقتراحات وتقارير خاصة وموضوعاتية إلى جلالة الملك في كل ما يمكن أن يسهم في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذلك يرفع تقريرا سنويا إلى جلالة الملك عن حالة حقوق الإنسان، وأصبح يتم إطلاع الرأي العام على هذه التقارير عن طريقة نشرها في الجريدة الرسمية، كما أن رئيس المجلس يقدم عرضا تركيبيا أمام البرلمان يتضمن تقريرا عن أعماله وكذلك طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور. والجدير بالذكر أن الظهير الشريف لم يربط مسألة إطلاع الرأي العام على مضمون التقرير بموافقة الملك كما كان عليه الحال بالنسبة للظهير المغير لنظام المجلس الاستشاري في مادته العاشرة.
- إمكانية تقديم التقارير في مواضيع محددة وتقارير خاصة.
بالنسبة لهذه الامكانية فقد وردت في المادة 35 الفقرة الأولى من الظهير الشريف 1.18.17، حيث أن المجلس يرفع لجلالة الملك تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يساهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل، إضافة إلى أن المادتين 5 و 11 منه أتاحتا إمكانية إصدار تقارير موضوعاتية عن حالة حقوق الإنسان الخاصة بفئة معنية (السجون، الصحة العقلية…).
- حق مخاطبة الرأي العام مباشرة.
نصت مبادئ باريس 1993 المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في الفقرة (ج) بشأن طرق العمل، أنه ينبغي للمؤسسة الوطنية في إطار عملها أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحفي لا سيما لنشر آرائها وتوصياتها على الكافة.
بالنسبة للمجلس فإنه وكما كان عليه الأمر في الظهير المحدث أو في الظهير الخاص بإعادة هيكلة المجلس الاستشاري، إنه لا يوجد نص صريح يعطي الحق للمجلس في مخاطبة الرأي العام مباشرة أو من خلال أي جهاز صحافي.
- حق نشر آرائه وتوصياته على العموم.
وفي هذا الشأن فقد أتاحت المادة 35 من الظهير الشريف 1.18.17 للمجلس إمكانية نشر آرائه وتوصياته المتضمنة في التقارير السنوية أو الموضوعاتية في الجريدة الرسمية وإطلاع الرأي العام عليها من دون أن يقترن الامر بموافقة الملك على ذلك، كما كان عليه الحال بالنسبة للمادة 10 في الظهير الخاص بإعادة هيكلة المجلس الاستشاري غير أنه من الناحية التراتبية تأتي مسألة النشر في الجريدة الرسمية وإطلاع الرأي العام على مضمونها يأتي بعد إطلاع الملك عليها مما يمكن فهمه أو تأويله على أنه تقييد لهذه الحرية.
المطلب الثاني: الاستقلال المالي
تنص مبادئ باريس على أن تتكفل الدولة بتوفير الموارد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكي يكون لها موظفوها الخاصون ومبانيها الخاصة.[5]
وتعتبر الاستقلالية المالية أمرا حاسما، فأية مؤسسة ليس لها السيطرة على مواردها أو على كيفية استخدامها لا يمكن أن تكون مستقلة، وتحدد الملاحظات العامة للجنة الفرعية[6] على أن يتوفر التمويل الكافي من جانب الدولة، وينبغي أن يشمل كحد أدنى ما يلي:
- تخصيص أموال لأماكن الإيواء الكافية، على الأقل لمكتبها الرئيسي؛
- المرتبات والاستحقاقات الممنوحة لموظفيها، المماثلة لمرتبات وشروط الخدمة العامة؛
- أجر الموظفين (حسب الاقتضاء)؛
- إنشاء نظم اتصالات، بما في ذلك الهاتف والانترنت.
وينبغي أن يكفل التمويل الكافي، بدرجة معقولة، إعمال الأداء التدريجي والتقدمي لتحسين عمل المؤسسة والوفاء بولايتها. ولا ينبغي التمويل من مصادر خارجية مثل “الشركاء في التنمية”، أن يشكل التمويل الأساسي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نظرا لأنه من مسؤولية الدولة تأمين ميزانية دنيا للأنشطة بغية السماح لها بالعمل في سبيل الوفاء بولايتها. وينبغي أن تكون النظم المالية من النوع بحيث تتمتع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستقلال المالي الكامل. وهذا ينبغي أن يكون بندا مستقلا في الميزانية وتوفر للمؤسسة إدارة وسيطرة مطلقة عليه.[7]
أولا: الميزانية المستقلة.
بحسب المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.18.17،[8] فإن المجلس يعتبر شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. وكذلك بحسب المادة 58 من نفس الظهير، فإن رئيس المجلس هو من يعد ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو خلاف لما كان عليه الأمر بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كانت ميزانيته ترتبط بميزانية البلاط الملكي. وهو ما يعتبر أنداك نوعا من الاستقلالية إذ أنشئ المجلس الاستشاري قبل وجود مبادئ باريس، وهنا لابد من ابراز أن الرغبة الملكية في وجود استقلالية للمجلس جعلته يصر من خلال خطابه: “وحتى لا يكون عليكم أي ضغط مادي فقد قررنا أن تكون مصاريفكم وتعويضاتكم… مرتبطة من الآن بمصالح القصر الملكي وليس بوزارة من الوزارات، حتى تبقى هذه الآصرة ولو كانت إدارية، صلة من وصل أخرى بيني وبينكم”.[9]
1-فصل ميزانية المجلس عن ميزانية الدولة:
لا يمكن القبول بربط ميزانية أية مؤسسة وطنية بميزانية وزارة حكومية، وحتى لو لم يكن هناك تداخل فعلي، فإنه قد يعطى انطباع بعدم وجود استقلالية، وهذا ما ينطبق بصفة خاصة إذا استمع المجلس إلى الشكاوى، نظرا لأن الصلة المالية قد تثير شكلا حقيقيا أو ظاهريا لتضارب المصلحة، وهذا ما دفع المشرع إلى تخصيص فصل خاص بالمجلس في الميزانية العامة للدولة،[10] وحدد تفاصيل هذه الميزانية الخاصة بالمجلس في كل ما يتعلق بالموارد والنفقات.
2-القدرة المالية للمجلس.
من الضروري للمؤسسات الوطنية بصرف النظر عن المهام المحددة لها، أن تحتاج إلى بعض المتطلبات الأساسية مثل الموظفين والمباني التي ينبغي توفرها حتى قبل أن تبدأ عملها، وبالتالي فإن الموارد الكافية والتمويل الملائم شرطان أساسيان لفعاليات المؤسسة، وعدم كفاية التمويل يهدد الفعالية ويضر حتى بمصداقية المؤسسة، بل يمكن أن يدفع بالتساؤل عن سبب دفع الدولة إلى إنشاء هذه المؤسسة ثم لا توفر لها قدرا ملائما من التمويل والموظفين، وهذا يمكن أن يضر بصورة المؤسسة كهيئة مستقلة وفعالة. كما أنه ليس من المرجح أن تعمل المؤسسة بعدد زائد عن الحد من الموظفين أو بميزانية مريحة ذات فائض. ولهذه الأسباب ينبغي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استحداث طرق لإدارة الموارد المالية. ثم إن الإدارة الفعالة للموارد تتطلب تحديدا دقيقا للأولويات والامتثال لخطة ثابتة ومعتمدة في الميزانية، بحيث تستطيع المؤسسات الوطنية تنمية اتصالات وعلاقات مفيدة للحصول على الدعم والإعانات المالية.[11] وقد أتاح القانون،[12] للمجلس إمكانية الحصول على الامدادات المالية من مصادر غير الدولة كالحصول على الهبات والوصايا والإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، شريطة ألا يؤثر ذلك في عمل المجلس، وبهذا يكون قد نص القانون بشكل صريح على استقلال المجلس في تدبير شؤونه المالية وبناء قدراته المالية من المداخيل المتأتية من ممتلكاته والعائدات المتأتية من نشاطه.
ثانيا: أثر استقلالية مقر المستقل.
تعتبر الدولة مسؤولة عن كفالة توافر مباني مناسبة للمجلس ولجانه الجهوية وقد أقر الظهير الشريف 1.18.17 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المادة الثالثة بوجود مقر المجلس بالرباط، رغم أنه لم يرد في الظهير الشريف 1.11.19 المحدث المجلس الوطني، ما يفيد بأن الهدف من توفير الإمكانات المالية للمجلس هو تمكينه من مقر مستقل عن الدولة، وهذا يمكن تفسيره بكون المجلس الوطني لم ينشئ لأول مرة بل هو وريث المجلس الاستشاري بمعنى أن مسألة المقر لا تطرح مشكلة لدرجة التنصيص عليه في الظهير الشريف 1.11.19، حيث أنه وبحسب المادة 58 فإن المجلس الوطني يحل محل المجلس الاستشاري في جميع حقوقه والتزاماته وفي ذلك إشارة ضمنية إلى المقر الذي يملكه المجلس الاستشاري.[13] ونجد نفس الحالة بالنسبة لهيئة حقوق الإنسان التونسية التي حلت محل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 29 أكتوبر 2018، وأقرت في المادة 57 من القانون الأساسي[14] بإحالة المقر والممتلكات إلى هيئة حقوق الإنسان وتتولى وزارة أملاك الدولة ترميم المقر وتسجيله في السجل الخاص بالهيئة.
كما نجد حتى في البلدان التي تعاني من قيود مالية شديدة توفر فيها الحكومة إما مباني مكتبية أو أرض لأجل بناء مقر مناسب ومن الناحية المثالية سوف تمتلك المؤسسات الوطنية مبانيها رغم أن كثير من المؤسسات تشتغل مباني بالإيجار، وهي الوضعية الحالية للمقر المركزي للمجلس الوطني إذ يشغل مبنى الإيجار بعد تغيير مقره السابق، الذي ورثه عن المجلس الاستشاري بدعوى أن المقر لا يتسع لجميع الموظفين، والرغبة أيضا في تجميع العديد من المصالح الإدارية للمجلس والمديريات التي كانت موزعة على مكاتب وبنايات بعيدة عن المقر، وتجدر الإشارة إلى أن المقر في الأصل كان قد قرر بخصوصه الملك الحسن الثاني أن يكون ذلك المقر الذي كان مخصصا من قبل لمجلس وزراء العدل العرب، وهو مقر كما وضعه أحد الأعضاء السابقين، (جمع بين جمال الصورة ورقة العبارة، أنه روعة الفن الإسلامي تتجلى للناظرين منذ أن تطأ أقدامهم المدخل، وتتابع الأقواس والعقود الجصية في رواق عريض يؤدي إلى قاعة المؤتمرات، فيض من زخارف الجص، تحفة من تحف التكوين الفني التقليدي المغربي، إنه مكان للعمل وعقد اللقاءات، لكنه يبعث أيضا على الألفة، فكان المقر في أعلى مستوى هندسة وتخطيطا، وتناسقا بين الحداثة والأصالة).[15] وقد أكدت التعليقات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في أكتوبر 2008، لتحقيق الاستقلالية على النحو الموضح في مبادئ باريس، ينبغي أن تتصف مباني المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يلي:
- تقع بعيدا عن مباني الحكومة؛
- يسهل الوصول إليها، أي من اليسير الدخول إليها وأنها توجد في موقع مركزي؛
- تكون قريبة من النقل العام؛
- يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.
ونجد هذه الشروط متوفرة بالنسبة لمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون الموقع في أملاك تثير الشكوك بشأن مصداقية المؤسسة وشاغلي مناصبها، وخصوصا إذا كانت التكاليف عالية وإذا كان من المتصور أنها نخبوية وبعيدة عن المنال وبالنسبة للوقائع الاجتماعية.[16]وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصبح له مقرا جديدا بحي الرياض بالرباط.
ثالثا: المراقبة المالية:
بالرجوع إلى الباب السابع المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس من الظهير 1.18.17، فإننا نستنتج أن المشرع بقدر حرصه على استقلال المجلس الوطني في تدبير موارده المالية وتسييرها بقدر حرصه على أن تخضع ميزانيته لقواعد المحاسبة التي أشار لها فب المادة 60 بأن تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. كما يتولى محاسب عمومي يعين لدى المجلس بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.[17] كما أخضع المشرع في نفس المادة 60 من الظهير الشريف 1.18.17، ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأشار إلى أن تعرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة الإفتحاص تتألف من ثلاث خبراء متخصصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي وهم مفتش عام للمالية معين بقرار من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وقاض بالمجلس الأعلى للحسابات معين بقرار الرئيس الأول للمجلس، وخبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين معين بقرار من الرئيس.[18]
وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس فإن المادة 70 نصت على أن المجلس يتولى في نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير مالي ويمكن لرئيس المجلس أن يطلب إجراء افتحاص مالي من الجهة المختصة وذلك حسب القوانين الجاري بها العمل.[19]
والجدير بالذكر أن خضوع المجلس لقواعد المحاسبة الخاصة به ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات، لا يشكل أي إعاقة بالنسبة للاستقلال المالي للمجلس بقدر ما يساعد المجلس على حسن تدبيره تسيير موارده المالية.
[1] مكتب الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التاريخ والمبادئ والأدوار والمسؤوليات، سلسلة التمرين المهني، العدد 4، نيويورك وجنيف، 2010، ص 47.
[2] Institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme, manuel sur la création et le renforcement d’institutions nationales efficaces pour les droits de l’homme, Genève, 1993, page 26.
[3] عبد العالي حامي الدين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومبادئ باريس، 9 أكتوبر 2011، موقع جريدة هسبريس.
[4] أنظر الظهير الشريف رقم 1.18.17 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 6652 بتاريخ 1 مارس 2018.
[5] مبادئ باريس، الفقرة الثانية الواردة ضمن التكوين والضمانات الاستقلالية: ينبغي أن تتوفر لذا المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلامة سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تمكينها من تدبير موظفيها وأماكن عملها لتكون مستقلة عن الحكومة وغير خاضعة لمراقبة مالية قد تمس استقلالها.
[6] اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد تعني اللجنة الفرعية المنشأة بموجب النظام الداخلي ” للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حماية حقوق الإنسان”، المشار إليها باللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية في قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2005/74 باعتبارها السلطة لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت أشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتمنح ولايتها لها بموجب النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيقية الدولية ووفقا له.
[7] الفقرة 2-6 من الملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.
[8] الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 22 فبراير 2018.
[9] الخطاب الملكي بمناسبة إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 8 ماي 1990.
[10] المادة 58 من الظهير الشريف رقم 1.18.17.
[11] مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، مركز حقوق الإنسان بجنيف، العدد رقم 4 من سلسلة التدريب المهني، الأمم المتحدة، 1995، ص 52-53.
[12] القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2018.
[13] المادة 58 من الظهير الشريف 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
[14] قانون أساسي عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 متعلق بهيئة حقوق الإنسان.
[15] محمد سعيد بناني، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولغته، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، 1996، ص 106.
[16] تعليقات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في أكتوبر 2008، المنشورة بالموقع الإلكتروني www.nhri.net.
[17] الفقرة 1 و2 من المادة 60 من الظهير الشريف 1.18.17 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
[18] الفقرة الخامسة من المادة 60 من الظهير الشريف 1.18.17 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
[19] المادة 70 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية