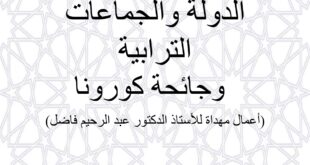سيادة الدولة في مقاومة العولمة
State Sovereignty in Resisting Globalization
Rachid Benbaba رشيد بنبابا
دكتوراه في فلسفة القانون
جامعة الحسن الثاني كلية الآداب و العلوم الانسانية المحمدية
مختبر” تكامل العلوم المعرفية و الاجتماعية”
ملخص
يمكن القول، بدءاً، إن العلاقة بين السيادة والدولة هي علاقة تلازم؛ ذلك أن وجود الدَّولة يرتبط، جوهرياً، بضمانةٍ أساسيةٍ هي السيادة، الدولة موجودة لكونها تتأسَّس على مبدأ السِّيادة؛ إذ مع غياب هذا المبدأ تتعرض الدولة، لا محالة، للانهيار. المقصود بسيادة الدولة، ها هنا، وجود كيانٍ أو مؤسسةٍ فوق حدودٍ جغرافيةٍ معينةٍ تُنظمها قوانين وضوابط وضعية وأخلاقية. يصعب الحديث، إذن، عن كيانٍ سياسيٍّ وأخلاقيٍّ وقانونيٍّ هو الدولة في غياب السيادة، غير أن الإشكال الذي يفرض نفسه في عصرنا الحالي؛ العصر الذي يعرف تقدما اقتصاديا، وعلميا وتكنولوجيا، لاسيما و مع ظهور الشركات متعددة الجنسية والعلاقات الاقتصادية العابرة للقارات وظهور نمط جديد من المعاملات التجارية وتغير بنية التواصل وظهور أنماط جديدة قوامها التقدم التكنولوجي، مما يهديد سيادة الدولة. بهذا المعنى نقول إن النمط الاقتصادي المعاصر والمتمثل في العولمة والقوانين الدولية جعلت سيادة الدول الوطنية واستقلاليتها تحت رحمتها. وعليه، سنحاول في هذا المقال الوقوف عند مميزات السيادة الوطنية ودور العولمة في تغيير ملامح هذه السيادة، كما سنعرج على الضَّوابط والشُّروط التي تفرضها العولمة على سيادة الدَّولة، في هذا السياق يمكننا طرح الأسئلة التالية: ما علاقة السِّيادة بالدولة؟ ما علاقة السِّيادة الوطنية بالعولمة؟ بأي معنى يمكننا اعتبار العولمة تهديداً مباشراً للسِّيادة الوطنية؟ هل يمكن ضمان نوعٍ من الاستقلالية في ظلِّ وجود هذه الهيمنة العلمية والاقتصادية والسِّياسية؟ ما علاقة العولمة بالقانون الدَّولي؟
Abstract
The relationship between sovereignty and the state is inseparable. The existence of the state is fundamentally linked to the basic guarantee of sovereignty. The state exists because it is founded on the principle of sovereignty; in the absence of this principle, the state inevitably collapses. Sovereignty means the existence of an entity or institution above certain geographical borders that is governed by laws and moral and ethical rules. In the absence of sovereignty, it is difficult to talk about a political, moral, and legal entity that is the state. However, in our current era, which is characterized by economic, scientific, and technological progress, with the emergence of multinational corporations, intercontinental economic relations, a new pattern of business transactions, changing communication structures, and new patterns based on technological progress, the sovereignty of the state is threatened by the emergence of a new pattern of business transactions. In this sense, we say that the contemporary economic pattern represented by globalization and international laws have put the sovereignty and independence of national states at its mercy. In this article, we will try to identify the characteristics of national sovereignty and the role of globalization in changing the features of this sovereignty. We will also address the controls and conditions imposed by globalization on state sovereignty, in this context we can ask the following questions: What is the relationship of sovereignty to the state? What is the relationship of national sovereignty to globalization? In what sense can we consider globalization a direct threat to national sovereignty? Can a kind of independence be guaranteed in the presence of this scientific, economic and political hegemony.
مقدمة
يمكن القول، بدءاً، إن العلاقة بين السيادة والدولة هي علاقة تلازم؛ ذلك أن وجود الدَّولة يرتبط، جوهرياً، بضمانةٍ أساسيةٍ هي السيادة، الدولة موجودة لكونها تتأسَّس على مبدأ السِّيادة؛ إذ مع غياب هذا المبدأ تتعرض الدولة، لا محالة، للانهيار. المقصود بسيادة الدولة، ها هنا، وجود كيانٍ أو مؤسسةٍ فوق حدودٍ جغرافيةٍ معينةٍ تُنظمها قوانين وضوابط وضعية وأخلاقية. يصعب الحديث، إذن، عن كيانٍ سياسيٍّ وأخلاقيٍّ وقانونيٍّ هو الدولة في غياب السيادة، غير أن الإشكال الذي يفرض نفسه في عصرنا الحالي؛ العصر الذي يعرف تقدما اقتصاديا، وعلميا وتكنولوجيا، مع ظهور الشركات متعددة الجنسية والعلاقات الاقتصادية العابرة للقارات وظهور نمط جديد من المعاملات التجارية وتغير بنية التواصل وظهور أنماط جديدة قوامها التقدم التكنولوجي، مما يهدد سيادة الدولة. بهذا المعنى نقول إن النمط الاقتصادي المعاصر والمتمثل في العولمة والقوانين الدولية جعلت سيادة الدول الوطنية واستقلاليتها تحت رحمتها. وعليه، سنحاول في هذا المقال الوقوف عند مميزات السيادة الوطنية ودور العولمة في تغيير ملامح هذه السيادة، كما سنعرج على الضَّوابط والشُّروط التي تفرضها العولمة على سيادة الدَّولة، في هذا السياق يمكننا طرح الأسئلة التالية: ما علاقة السِّيادة بالدولة؟ ما علاقة السِّيادة الوطنية بالعولمة؟ بأي معنى يمكننا اعتبار العولمة تهديداً مباشراً للسِّيادة الوطنية؟ هل يمكن ضمان نوعٍ من الاستقلالية في ظلِّ وجود هذه الهيمنة العلمية والاقتصادية والسِّياسية؟ ما علاقة العولمة بالقانون الدَّولي؟
إن الناظر في مجال القانون سيجد تردد عباراتالسِّيادة الوطنية والدولة القومية، والدولة السائدة، وهي عبارات تستعمل للتعبير عن العلاقة الوطيدة بين السيادة والدولة. وهي المسألة التي أشار إليها هيغل في كتابه “مبادئ فلسفة الحق“؛ بحيث اعتبر أن وجود الدولة يرتبط بمبدأ السيادة[1]؛ بعبارة أخرى يشير هيغل إلى التَّلازم الموجود بين السِّيادة والدولة، مؤكداً أن للدولة جذوراً تاريخيةً تمتد إلى عصور قديمة، جذور امتدت إلى العصر الإقطاعي بحيث انحصرت السيادة في شخص الحاكم، هذا وكانت الدولة عبارة عن ملكيات منقسمة على مجموعة من الأفراد يسيرونها وفقاً لآرائهم الخاصة وميولاتهم الذاتية. أما في الفترة الحديثة فقد أصبحنا نتحدث عن الدولة التي تتمتع بالسيادة، منتقلين من صلاحيات تمنح للأفراد إلى صلاحيات تمنح للمؤسسات، بحيث صار التَّلازم بين السِّيادة والدولة يظهر في كل المجالات خاصةً في تسيير الشأن العام. ومن ثم يمكن القول إن الدولة صاحبة السيادة تتمتع بمظهرين: المظهر الدَّاخلي مُمثلاً في الهيمنة على المجتمع والمظهر الخارجي ويظهر من خلال إمكانية مواجهة دول أخرى تهدد السيادة الداخلية. بعبارة أخرى يظهر التلازم بين الدولة والسيادة من خلال استعمال مفهومي السلم والحرب؛ إذ في حالة السلم ينصب اهتمام الدولة على الجانب الداخلي المتَّصل بشؤون المواطن، أما في حالة الحرب فنجد اهتمام الدولة بإمكانية فرض هيمنتها تحقيقاً لرهانات خارجية تخدم، في نهاية المطاف، مصلحة الدولة وتواجدها على المستوى الإقليمي، أضف إلى ذلك سعي الدولة من خلال هذا المظهر إلى الإشارة إلى قيم التضحية التي يجب أن تظهر لدى أفراد الدولة، فَهُم مواطنون يجب أن يقدموا التضحية الكافية لحماية سيادة الدولة[2]. بهذا المعنى حصل، في الفترة الحديثة، نوع من الانتقال التدريجي من سيادة الشخص الواحد الحاكم إلى سيادة الشعب؛ لذلك تجدنا قد ميزنا بين السِّيادة الشعبية وسيادة الحاكم. هكذا، نتحدث عن تعابير مثل: الإجماع، والإرادة العامة، وسيادة الشعب والمؤسسات، هذا وقد صارت المسألة أكثر تعقيدا في الفترة المعاصرة حينما سنتحدث عن وجود كيانات أخرى تحدد السيادة الوطنية[3].
يرى هيغل أن الدولة تعبير عن الوجود الفعلي وتجسيد للروح المطلق من حيث هي إرادة داخلية تظهر وتفكر في ذاتها وتنجز كل ما تراه صائبا[4]، هكذا أشار هيغل إلى أن المجتمع المدني هو ما يضمن التلاحم بين الأفراد داخل الدولة، ويعبر عن الروح الجماعية التي تسعى إلى المصلحة المشتركة. وحينما نقول المجتمع المدني، فنحن نتحدث عن فكرة عقلية تسمو على الكل، لكن لا بد للأفراد أن يضحوا بأنفسهم من أجل ضمان وجود المجتمع المدني الذي يعبر عن الإرادة الكلية للدولة. بهذا المعنى، يبين هيغل أن السُّلطة تتجاوز مسألة الأهواء الخاصة والأفكار الفردية؛ حيث تعبر عن المصلحة العامة. ومن ثم هنا يمكن الإشارة إلى أن السلطة تأخذ دور السِّيادة قصدَ منع كل إمكانية للفوضى، إمكانية تضعف الإرادة العامة للدولة[5].
إن الحديث عن السلطة كمعيار فوق الجميع الغاية منه تنظيم المجتمع، والحفاظ على الدولة ككيان يجسد، بلغة هيغل، الدولة العقلية التي توجد بشكل مطلق وهي تعبير أيضا عن الإرادة الجوهرية التي تعي ذاتها. وبمجرد ما يرقى هذا الوعي، نعني وعي الدولة بذاتها، نلمس وحدتها الجوهرية، وهي الوحدة المقرونة بالحرية؛ فالحرية الحقيقية هي حرية الدولة في أن تتصرف في شؤونها باعتبارها صاحبة السيادة، وهي الغاية الأسمى من وجود الدولة[6]. تبقى الدولة بالنسبة لهيغل ذات سيادة مطلقة؛ إذ لا وجود لأي كيان أقوى وأسمى منها، ومن السيادة تنبثق جميع المؤسسات والهيئات وهي مصدر المشروعية. وقد نذهب مع هيغل إلى القول إن السيادة هي العامل الحاسم في استمرار الدولة وتطورها وخروجها من حالة الفوضى.
ليست ضمانات الدولة مسألة خارجية إنما هي إمكانية تحقيق مجتمع مدني يمثل سيادة الدولة واستقرارها، والمسألة الحاسمة بالنسبة لهيغل، ها هنا، هي صدور قرارات الدولة بمعزل عن أي تدخل خارجي؛ فحينما أكد هيغل على وعي الدولة بذاتها، فالمقصود أن القرارات التي تعتمدها الدولة لتنظيم شؤونها الداخلية نابعة من سيادتها الخاصة وقوتها وسلطتها. بعبارة أخرى وظف هيغل السيادة للحديث عن استقلالية الدولة عن كل ما يمكن أن يهدد وجودها، فهي التي تقرر وتشرع الأحكام وتضع القوانين وذلك بفضل سيادتها. في هذا السياق، إن مسألة المواطنة مسألةٌ واقعيةٌ تبين أن الفرد مواطن داخل الدولة، مع الإشارة إلى أولوية هذه الأخيرة على الفرد؛ ذلك أن كل من يريد الخروج عن سلطة الدولة محاولاً معارضتها فهو يعترض على الدولة ككل. إن قيم المواطنة بالنسبة له هي الانتماء إلى الدولة مع محاولة الدفاع عن مؤسساتها واحترام سيادتها[7].
الظَّاهر، بناءً على مبادئ فلسفة القانون، أهمية الأطروحة الهيغيلية التي تعتبر أن الدولة والسلطة غير قابلتين للتجزيء. بهذا المعنى، فالسيادة تعبير، بلغة رجل القانون، عن الدولة التي تتمتع باستقلالية عن أية هيئة أو سلطة أخرى أعلى منها. أضف إلى ذلك أن سيادة الدولة تعني وجود مبدأ سامٍ للتَّشريع أو لنقل وجود مشرعين لا يعترفون بمن هو أسمى من الدولة، ومنه يستطيع هؤلاء سن تشريعات نعبر عنها بالدستور النافذ، وللتمثيل على ذلك نجد نموذج بريطانيا كدولة تمنح بموجب دستورها لهيئة التشريع الحرية لسن المبادئ العامة لضمان هيمنة ووجود الدولة، من دون أن يتعارض ذلك مع الإرادة العامة للدولة التي هي تعبير عن وجود مجتمع مدني سياسي غايته حماية الدولة نفسها.
خلافاً لما سبق نجد أن السِّيادة القومية أو الوطنية ستشهد نوعاً من الاهتزاز والتَّغير وذلك بسبب ظهور قانونٍ دوليٍّ ينظم العلاقات بين سيادات متعددة، زد على ذلك ظهور العولمة باعتبارها مجموعة من الآليات التي تحكم الاقتصاد من جهة والسياسة الدولية من جهة أخرى. هكذا، كيف ساهمت العولمة في تفكيك مفهوم السيادة الوطنية مع زعزعة الاستقلالية التَّامة للدولة؟ إجابة عن هذا السؤال سنحاول التوقف، أولاً، عند مفهوم العولمة.
نقول في اللفظ العربي عولمةٌ يعولمُ عولمةً، ويدل في المعاجم الأجنبية على العالمية (Mondialisation)، واستُعمل بدايةً في مجال الاقتصاد ليعبر إلى مجالات أخرى من الأنشطة الإنسانية[8]. وعليه، يظهر أن مصدر العولمة يعود إلى عبارة la Mondialisation والتي تعني الشمولية والكلية والعالمية، وللمفهوم مرادفات هي: Universel بمعنى شمولي، وPlanétaire التي تحيل على المستوى الجغرافي الموسع، كما نجد في اللغة الإنجليزية عبارة Globalisation والمقصود بها الاستراتيجيات الموسعة والاقتصادات الممتدة، كما تعني انتشار مظاهر الحضارة في العالم ككل. والحاصل أن العولمة في اشتقاقها اللغوي الفرنسي أو الإنجليزي تدل على التوسع والشمولية والكونية.
يرى المفكر محمد عابد الجابري أن العولمة ترجمة لعبارة Mondialisation والمقصود بها العالمية، أي نقل الشيء من مجال محدود إلى مجال عام[9]. ومنه، إن العولمة، بالنسبة للجابري، ترجمة لعبارة mondialisation La الفرنسية ومعناها جعل الشَّيء يتَّسم بصبغة عالمية من خلال إخراجه من مجال الخاص إلى مجال العام؛ أي نقله من المحدود إلى اللامحدود. من هنا يمكن الإشارة إلى أن اللغة تحدد الدلالة الأولية لعبارة عولمة رغما أن هذه الدلالات المستوحاة من مجال اللغة لا تفيد بشكلٍ كبيرٍ في ما تقصده العولمة وتأثيراتها الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية. فحينما نتحدث عن جعل الشيء عالمياً معناه الحديث عن العولمة بشكلٍ سطحيٍّ؛ إذ تدل على بنيةٍ تضم مجموع الآراء والتَّمثلات والخطط والاستراتيجيات لجعل الأفكار والمنتوجات أكثر انتشاراً في العالم. وعليه، ليست العولمة مجرد الانتقال من المحدود إلى العام، بل تعبيرٌ عن نمطٍ اقتصاديٍّ، واجتماعيٍّ وسياسيٍّ ينتشر ضمن مدىً واسعٍ، بهذا المعنى يفترض الحديث عن العولمة الوقوف على خلفيتها الاصطلاحية.
يمكن الإقرار، أولاً، بصعوبة منح العولمة تحديداً دقيقاً نظراً للتَّحولات العالمية الحاصلة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تداخل العولمة مع مفاهيم أخرى مثل النظام الدولي الجديد والعالمية. وعليه، يظل مفهوم العولمة في حاجة إلى مزيد من التدقيق والضَّبط . ولأن موضوع البحث الرئيس ليس التَّدقيق اللغوي أو نحتاً لمفهوم العولمة، سنكتفي، ها هنا، بالنَّظر إليها باعتبارها انتشاراً عالمياً لأفكارٍ، وتمثلاتٍ، وقيمٍ وقوانين، أضف إلى ذلك أن العولمة، اليوم، هي سيرورة لم تكتمل، بل لا زلنا نتحدَّث عن قطائع مع وجود تغيرات على مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية، هذا مع الإشارة إلى اقتران العولمة بالتقدم التكنولوجي.
عطفا على ما سبق، يمكن القول إن العولمة مفهوم يتغير لونه بناءً على الخلفية التي ينطلق منها المفكر والناظر في موضوعها، بهذا المعنى قد لا يحصل إجماع عام على معنى واحد ووحيد، في هذا السياق يقول صادق جلال العظم إن العولمة في حقيقتها تدل على التحول الرأسمالي العميق للإنسانية، في ظل هيمنة دول مركزية، وبقيادتها وتحت سيطرتها في ظل سيادة نظام عالمي للتبادل لا يتميز بالتكافؤ[10]، إننا أمام تعريف ينطلق من منطلقاتٍ تاريخيةٍ وإيديولوجيةٍ ترتبط بمجال الاقتصاد وتحيل على السيطرة والتحكم في الفضاءات الإنسانية الأخرى. يقول عبد المنعم حنفي في موضع آخر: “وفي العولمة رسملة عالمية، وقد تم السيطرة عليه في ظل هيمنة دول المركز وسيادة فكرة السيادة الوطنية، وسيطرة الثقافة العالمية، وهذا نمط العولمة الأمريكية الذي يجعل الشيء في مستوى عالمي؛ أي انتقاله من المجال الضيق إلى المجال العام حيث يتم تعميمه من الشكل الفكري والسياسي والاقتصادي الذي يميز جماعةً ما إلى الشَّكل العالمي، أي من المحدود إلى اللاَّمحدود”[11]. هكذا، فإن المقصود بالعولمة تجاوز الحدود الجغرافية مع الاتصاف بالشمولية سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو المجالات الأخرى، مع التأكيد على أن العولمة تتميز بطابع الشمولية والهيمنة الممارسة من طرف دول مركزية غربية كهيمنة النموذج الأمريكي على الدول الأخرى. يمكن القول، لمزيدٍ من الإيضاح، إن المقصود بالعولمة العمليات التي تغطي جانباً متسعاً وعالمياً كما تتخذ بعداً سياسياً أكثر منه اقتصادياً؛ ذلك أن التَّحكم والهيمنة والتَّخطيط الاستراتيجي يحمل خلفيةً سياسيةً أكثر مما هي اقتصادية أو اجتماعية، أو لنقل إن الحدود بين السياسي والاقتصادي، في ظل عولمة متسارعة، هي حدود غير واضحة.
يتأتى مما سبق أن العولمة أفرزت نتيجة أساس وهي تذويب الاختلافات الثقافية مع تجاوز الحدود الجغرافية بمعناها التقليدي؛ من هنا يمكن القول مع عبد المنعم حنفي: “إن هدف العولمة هو تذويب الحواجز والقضاء على الخصوصيات”[12]. في السياق ذاته نجد حسن حنفي قد اعتبر العولمة المفهوم الأكثر أهمية في مجال الاقتصاد، خاصةً بعد انهيار النِّظام الاشتراكي في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي، فبدلا من الحديث عن قطبين متصارعين أصبحنا نتحدث عن إدارة القطب الواحد. هكذا صار الحديث، حسب حسن حنفي، عن مرحلةٍ تاريخيةٍ جديدةٍ قوامها: الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتجاوز صراع الحضارات.[13]
يمكن القول، بناءً عليه، إن العولمة مسألة معقَّدة إذ تحمل بين طياتها معاني ودلالات متعدِّدة، بيد أن المسألة الحاسمة، ها هنا، سعيها إلى القضاء على كل أشكال الخصوصيات؛ ذلك لارتباط العولمة بوسائل تكنولوجية وعلمية ومعرفية غايتها تقليص المسافات في العالم مع توحيد السياسات والذهنيات. تجدر الإشارة هنا إلى أهمية البحث عن الآليات التي تمكن من مقاومة هذا التوسع الجارف والانتشار المهول للعولمة قصدَ حماية الخصوصيات الثقافية والعلمية مع حماية الدولة الوطنية من كل أشكال التَّسلط باسم المصالح الاقتصادية.
يمكن التمييز في العولمة، باعتبارها ظاهرةً دوليةً كغيرها من الظواهر، بين مجموعة من الخصائص والسِّمات: أولاً، التَّقدم الهائل على مستوى النِّظام المعلوماتي، وشبكة الاتصال والتواصل؛ ثانياً وضع سياسات للتكتل الاقتصادي خدمة لمصالح الدَّولة المركزية والدُّول التي تشاركها المعاملات الاقتصادية نفسها، ثالثاً نمو وتقدم الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية العالمية؛ رابعاً: تنامي الثروة الصناعية وتمركز النِّظام الاقتصادي العالمي ضمن دولٍ دون أخرى؛ خامساً التَّفكك الحاصل على مستوى البنية الاجتماعية مع التراجع البَيِّن للفضاء الخاص. وأخيراً تهديد صريحٌ للسِّيادة الوطنية. على الرغم من المظاهر السلبية للعولمة يمكن الوقوف على بعض الجوانب الإيجابية المتمثلة في محاولة القضاء على الحروب والصراعات، بالإضافة إلى إنجاز تكتلات اقتصادية من شأنها تعزيز المبادلات التِّجارية، فما يوجد من مواردٍ طبيعيةٍ في بلد ما لا يتحقق في بلدٍ آخر، مما يستدعى تضافر الجهود على المستوى الكوني. بناءً عليه، سنحاول في الأسطر القادمة الإجابة عن السؤال الآتي: ما هي انعكاسات العولمة على الدولة الوطنية؟
العولمة تهديد للسيادة الوطنية
شاع مفهوم العولمة، منذ تسعينيات القرن الماضي، في كتابات العديد من السياسيين ورجال الاقتصاد والمفكرين، ليكتسب بذلك المفهوم مضموناً ثقافياً وفكرياً خاصةً بعد تفكيك النِّظام الشيوعي وانهيار الاتحاد السوفياتي مع هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية في الساحة الدولية. بهذا المعنى عرفت العولمة استعمالاً موسعاً على مستوى وسائل الإعلام، استعمالا ساهم في الدفع بالجميع إلى ضرورة الانقياد إليها؛ هكذا أصبحنا أمام مؤثر كبير على سياسات الدول والعلاقات الدولية؛ إذ صرنا نتحدث عن مبادئ جديدة في المعاملات وإبرام الصفقات بالإضافة إلى القوانين الناظمة للعلاقات الاستراتيجية.
يظهر في الآونة الأخيرة الأثر الكبير الذي تمارسه العولمة على سيادة الدول حيث ارتفع منسوبها في البناء الداخلي للدولة وذلك من خلال البنية الفوقية للدولة، نعني الثقافة والفن والأخلاق، زد على ذلك المدونة القانونية التي أُجبرت على ضم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان. يمكن القول، إذن، إنَّ القوانين الدَّولية التي ترعاها الأمم المتحدة أصبحت بمثابة شروطٍ اعتماد بين الدول لإظهار مدى صلاحية القوانين المعمول بها داخل كل دولة، مما قد يُضعف سيادة هذه الدَّولة على نفسها ويعرضها لنوع من الترهل في علاقتها مع المكونات الداخلية؛ هكذا تراجع المفهوم التقليدي للسيادة لصالح نوعٍ جديدٍ من السِّيادة، سيادةُ الدَّولة في ظل القوانين الدولية. لم يعد من الممكن في ظل السرعة الفائقة للعولمة على المستوى الاقتصادي بناء جدارٍ عازلٍ باسم السِّيادة الوطنية حيث فُرض على الدَّولة البحثُ عن السُّبل الكفيلة للـتَّأقلم مع الوضع الرَّاهن، لننظر إلى التَّطور الحاصل في الشركات العابرة للقارات بالإضافة إلى هيمنة المؤسسات المالية العالمية خاصةً صندوق النَّقد الدّولي والبنك العالمي، لقد عملت كل هذه الهيئات على فرض قيودٍ وشروطٍ تُهدِّدُ السِّيادة الوطنية للدولة.
بتعريجنا، في الفترة المعاصرة، على الشَّركات المتعدِّدة الجنسية، نجدها تنسج علاقات اقتصادية ومبادلات تجارية تسهر عليها هيئات عالمية مع انخراط مجموعة من الدول في إنتاج واستهلاك وتصدير مجموعة من المنتوجات الفلاحية والصناعية والطاقية. ساهم، هذا الفضاء الاقتصادي والجيوسياسي، إذن في ظهور شركات متعددة الجنسية؛ إذ صارت اليوم بمثابة عصبٍ اقتصاديٍّ حيويٍّ، فهي الوسيلة التي تمول الإنتاج وتجعله أكثر انتشاراً، بل تمثل هذه الشَّركات الوجه الجديد للنّْظام الاقتصادي العالمي، كما أصبحت أداة تخطيط وتنظيم دقيقين، مما سمح لها بالتَّمدد خارج الحدود الوطنية، وبالتالي وضع السيادة الوطنية تحت رحمتها. يمكن القول، إذن، إن الشركات المتعددة الجنسية بمثابة مشاريع تسيطر على وحدات في دول متعددة ضمن استراتيجية إنتاج واحدة، إننا أمام تكتل هام لمجموعةٍ من المؤسسات الاقتصادية المتعدِّدة الجنسية ترتبط بعضها ببعض حيث تخضع لقوانين ومبادئ إدارة مشتركة. أضف إلى ذلك أن الشركات المتعددة الجنسية هي شكلٌ جديدٌ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات رأسمال كبير جدا والتي تنطلق من مبادئ وأفكار الشركة الأم حيث يكون لهذه الأخيرة الحق في إدارة الفروع التابعة لها[14]. أما البدايات الأولى لهذه الشركات فتعود إلى القرنين السابع والثامن عشر الميلادي؛ إذ عرفت توسعاً تجارياً كبيراً اتخذت معه طابعاً استعمارياً وذلك برعاية من الشركة الأم؛ حيث اقتصرت في البداية على عملياتٍ تجاريةٍ بسيطةٍ إلاَّ أن ظهور الثروة الصناعية مع الانفتاح على التطور التكنولوجي جعلها تشهد تحولاً عميقاً على مستوى هياكلها وشركاتها، وتطورت تدريجياً إلى أن أصبحت بمثابة قوة اقتصادية ومالية تساهم في التحكم في سياسات الدول.
هكذا يمكن القول إن الشركات المتعددة الجنسية، في ظل انتشار العولمة، لعبت دوراً أساسياً في التحكم في السياسات الداخلية للدول وتوجيهها مما أثر، بشكلٍ مباشرٍ، على السيادة الوطنية. قد لا تكون لهذه الشركات سلطةٌ مباشرةٌ غير أنها تمتلكُ قوةً اقتصاديةً وماليةً تجعل الدولة المرتبطة بها تابعة لها على مستوى السياسة المالية، لذلك يمكننا أن نتساءل: هل بإمكاننا الحديث عن السِّيادة الوطنية في ظل وجود هذه الشركات العالمية المهيمنة مع قدرتها الكبيرة على التَّحكم في السِّياسات الاقتصادية لمجموعةٍ من الدُّول؟
تتركز هذه الشركات خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية بالإضافة إلى اليابان، وتتحكم في ثلثي التِّجارة العالمية والخدمات العالمية، هكذا أصبحت هذه الشركات فاعلاً أساسياً في التجارة الدولية ومحوراً رئيسيا لكونها تؤثر، بشكلٍ مباشرٍ، في الاقتصاد العالمي من جهة، واقتصاد الدول من جهة أخرى[15]، أما عن أهم الخصائص التي تميز هذه الشركات فنجد: أولا، اعتماد الكفاءات مع رصد موارد مالية مهمة لاستقطابها من جميع الدول؛ ثانياً: الإدارة والتخطيط حيث تعتبر هذه الشركات بمثابة مؤسسات منظمة تعتمد استراتيجيات وخطط محددة في الزمان للزيادة في الأرباح وتوسيع الاستثمارات مع توسيع القاعدة الجغرافية لها بحيث تنتشر تدريجيا في جميع البلدان، أما غرضها الأساسي فهو وضع مخططٍ شاملٍ لتحقيق معدلات مهمَّة من الأرباح؛ ثالثاً: الرأسمال العالمي، إذ تُعَدُّ هذه الشركات من أكبر رؤوس الأموال لكونها تتحكم في مؤسسات مالية بالإضافة إلى استنادها على مبدأ الاحتكار؛ رابعاً: تنوع النَّشاط الاقتصادي ذلك أن الشركات المتعددة الجنسية تنوع أنشطتها بهدف تقليل احتمال الخسارة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية المدرة للربح.
الظاهر من خلال ما سبق أن الشركات المتعددة الجنسية تحولت في ظل العولمة إلى دولٍ موازيةٍ تمارس تأثيراً فعلياً على الدول التقليدية وتؤثر في إعادة تشكيلها مع جعلها تتنازل عن مجموعة من الخصوصيات الاقتصادية والرأسمالية. يبدو أن الشركات المتعددة الجنسية تسعى، ضمنياً، إلى إقامة دولة عالمية قادتها رجال أعمال برؤوس أموال عابرة للقارات. هكذا أثرت العولمة، بشكلٍ مباشرٍ، على سيادة الدولة الوطنية؛ حيث تتحكم في الاقتصاد مع التدخل في السياسات الداخلية الخاصة بالدولة الوطنية؛ لذلك نشهد، اليوم، مجموعة من الدول عاجزة عن بسط سلطتها على أراضيها والتحكم في اقتصادها؛[16] فالشركة في بعض الأحيان يمكن أن تتعارض استثماراتها مع الدولة الوطنية فتضع خططاً واستراتيجيات بديلة لإقناع الدولة الوطنية بهذا المنتوج أو بهذه السلعة، لذلك يصبح التَّحكم مزدوجاً: تحكم اقتصادي وآخر سياسي، كما حدث ذلك في المكسيك سنة 1994 وبعض دول جنوب شرق آسيا سنة 1990م، مما يذكرنا بأن الليبرالية الجديدة تعتمد الشركات المتعددة الجنسية لإضعاف الدولة الوطنية وتحويلها إلى أداة تحت نفوذها، في هذا السياق يظهر أن الشركات المتعددة الجنسية تعمل على إضعاف سيادة الدولة وعرقلة نموها الديمقراطي لاسيما في الدول النَّامية حيث تدفع الشَّركات المتعددة الجنسية بعض الدول إلى الخصخصة مما ينعكس سلباً على الخدمات ويؤثر على قطاعاتٍ حيويةٍ أهمها التَّعليم والصِّحة العموميان.
.3العولمة والسياق الدولي
سبقت الإشارة، ضمن مجال القانون، إلى أن الدولة ذات السيادة بإمكانها أن تعتبر مصدرا للقانون وهي في نفس الآن سلطة عليا قد تمثلها الدساتير وقد تمثلها هيئات. ينضاف إلى ذلك أن السيادة تعني وجود مشرع سام لا يعترف بوجود ما هو أسمى منه ويستطيع إقرار وتشريع القوانين. وقد اعتمدت بعض الدول مثل بريطانيا على هذا النوع من السيادة التي تستمد قوتها من كون الدولة ذات سيادة؛ بمعنى أن القوانين الصادرة عن الدولة بمثابة أوامر عليا. وجدير بالذكر هنا بأن قوة التشريع العليا هي السلطة نفسها التي تفرض على الجميع، وهي في نفس الآن إرادة الدولة.
لقد ذهب الفقهاء، في الفترة المعاصرة، إلى الحديث عن الطَّابع غير المقيد للسيادة القومية رغم صعوبة الحديث عن مثل هذا التحديد؛ فالسياق الدَّولي يشهد تجاذبات وأقطاب وتقاطعات اقتصادية ومجالية وثقافية وهو ما يؤدي إلى استقلالية الدولة القومية. هذا ويعني ظهور القانون الدولي وجود قواسم مشتركة وتقاطعات ومصالح وأهداف استراتيجية قد تكون في صالح هذا التنسيق وهذا التشارك، ولا يمكننا الحديث عن استقلالٍ تامٍّ للدَّولة في ظل هذه العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية. هكذا اعتبر الفقهاء أن محاولة الحديث عن الدولة وسيادتها بعيداً عن السياق الدولي أمر صعب جدا.
تفيدنا هذه المسألة في التَّمييز بين القانون في إطار التَّشريع القومي والقانون في إطار التزامات الدولة. وثمة فرضيات تعتمد التَّعارض بين التشريع القومي والقوانين الدولية، فبعض المحاكم البريطانية اعتمدت مبدأ طاعة القوانين القومية ودافعت عن قدسيتها، هذا ويجب أن يكون التشريع القومي في المرتبة الأولى ولو تعارض مع القانون الدولي. اجتهدت، في هذا السياق، المحكمة البريطانية في تفسير التشريع البريطاني مع محاولتها القيام بنوع من التوفيق بين قانون الدولة القومية والقانون الدولي. لكن إذا افترضنا جدلا، ضمن هذا التصور، أن الدولة القومية ذات السيادة يجب أن تكون لها الأولوية فكيف يمكننا أن نحدث هذا التقاطع والتوافق الجديد مع القانون الدولي خاصةً وأنه لا يمكننا فصل الدولة القومية عن السياق الدولي؟
ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة أن يكون القانون الدولي جزءا من قانون الدولة القومية، بحيث يترتب على ذلك أن يصبح القانون الدولي سلطةً مهيمنةً قادرةً، في بعض الأحيان، على إلغاء نصوص القانون القومي. نستحضر، ضمن هذاا المجال، مسألة أخرى وهي أن القانون الدولي قانون أجنبي لا يمكن أن يعتد به في حال تعارض مع القانون القومي. تبقى المصلحة، إذن، هي المحدد الأساسي؛ إذا كان القانون الدولي في مصلحة القانون القومي، يمكننا آنذاك قبول التشريع واعتماده كاستراتيجية وكخطة وفي حالة ما إذا وقع العكس وتعارض القانون القومي مع القانون الدولي يمكننا الانتصار للقانون القومي وهذا ما أثبتته المحكمة البريطانية.
فضلت العديد من الدول الطريقة الأولى وهي الانتصار لسيادة الدولة والقانون القومي، لكن مع ذلك بحث فقهاء هذا التصور عن آليات جديدة لوضع مبادئ التشريع واجتهدوا في تحقيق توافق بين القانون القومي والقانون الدولي؛ ذلك أن أي موقف قد تتبناه المحكمة الوطنية يظل معلقا ما لم يتوافق مع التزامات الدولة وهي مسؤولية ملقاة على عاتق المشرع داخل الدولة القومية؛ لأن الدولة، في نهاية المطاف، لا توجد بمعزلٍ عن السياق الدولي. ومن ثمة يجب أن تكون سيادة الدولة هي سيادة القوانين القومية التي لا تتعارض مع القوانين الدولية، سواء كانت القوانين الدولية جزءاً من القوانين القومية أو العكس. إن القانون الدولي وبالرغم من أنه يعبر عن الأجهزة والمؤسسات العالمية كالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة العمل الدولي، ما يزال يشتغل، إلى حدود اللحظة، لكي يشكل هيئة عالمية فوق جميع الدول. هكذا، يمكن القول إن الخضوع للقانون الدولي لا يعني دمج سياسة الدولة في السياق الدولي أو ربط سيادة بسيادة أعم، بل لابد من الاعتراف بالنِّظام التَّشريعي العام الذي تكون أحكامه ملزمة لجميع الدول[17].
هذا التداخل بين سيادة الدولة القومية وسيادة القانون الدولي يلزمنا بالتمييز بين السيادة الداخلية والسيادة الخارجية. تعني السيادة الداخلية أن الدولة حرة في تنظيم شؤونها الداخلية ولا تعلو عليها سلطة أخرى، إذ تفرض سلطتها، إقليميًا، على الأشياء والأشخاص الموجودة والتي تنتمي إليها إلاَّ في حالة القانون الدولي حيث يشكل حالة استثناء. لذلك، للدولة حق التمتع بالاختصاصات المتعلقة بوجودها كدولة فهي تتولى طريقة الحكم وتختار ما يناسب أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتنظم عمليات التشريع والقضاء. وبالتالي، فالدولة هي صاحبة السيادة ولها القرار النِّهائي للحكم على كل المسائل المتعلقة بشؤونها دون حاجة إلى مشاركة سلطة أخرى، والسلطة ذات السيادة هي القوة التي تقرر بنفسها كل ما يرتبط بمصلحتها بغض النظر عن التأثيرات الخارجية، ولا يمكن للأفراد أن يفرضوا آراءهم عليها، فهي حرة في تنظيم شؤونها الاقتصادية واستغلال ثرواتها، وهذا ما أكده ميثاق الأمم المتحدة في كثير من فقراته ومواده.
أما السِّيادة الخارجية فتعني أن الدَّولة لا تخضع لأية سلطةٍ عليا خارجية وأن سمات السيادة الخارجية للدولة يجب أن تعتمد على مبدأ الاستقلالية؛ أي إنه يمكن للدولة أن تمارس شؤونها الخارجية بشكلٍ مستقلٍ وأن لا تخضع لأية سلطةٍ أخرى أو رقابةٍ تمارسها دولة أخرى، ولا يمكن أن تسمح لدول أن تتدخل في شؤونها، كما تتمتع بحق إقامة علاقات مع دول أخرى سواء كانت علاقات دبلوماسية سياسية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو في مجالات أخرى، شرط أن تتوافق هذه العلاقات مع قواعد القانون الدولي الذي ينص على احترام سيادة الدول الأخرى. إضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة، ها هنا، إلى أن السيادة الخارجية يجب أن تحترم مبدأ المساواة للسيادة؛ لأن كل دولة تتمتع بالحقوق وتتحمل الالتزامات الدولية. ومنه، فالسِّيادة هي المعيار الذي يعتمد عليه القانون الدَّولي لتحقيق مبدأ المساواة؛ فكل دولة سواءً كانت كبيرةً أو صغيرةً، قويةً أو ضعيفةً لابد أن تحترم سيادتها[18].
يمكن القول، مما سبق، أن ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً في الفقرة الأولى من المادَّة الثانية، يدعو إلى ضرورة احترام سيادة الدولة القومية وذلك بناء على المبادئ الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة. ومنه، فإن دلالة السيادة، على الرغم من التغيرات التي لحقتها بسبب تطورات المجتمع الدولي وظهور معايير جديدة، لا زالت مقدسةً ولابد أن تُحترم، هذا على الرغم من أن السيادة ليست مطلقةً وإنما مقيدة بقواعد القانون الدولي، وأي إخلال بها من قبل الدول الأخرى دون مبرر قانوني يُعد خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة.
يمكن الإشارة، هنا، إلى أن السيادة المطلقة للدولة فقدت، حقاًّ، من قوتها وفعاليتها وفاعليتها في الفترة المعاصرة، ولا يمكن لأي دولة أن تتمسك بها في العلاقات الدولية؛ لأنها لا تنسجم مع جميع التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي من النواحي الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والعسكرية، بل تمثل تهديدا لما اكتسبه المجتمع الدولي. لا تعني هذه التطورات، على الاطلاق، فقدان السيادة، لكن هناك تغيرات تصبح معها السيادة معياراً لتنظيم العلاقات بين الدول، وبالأخص عندما تتوافق مبادئها وقوانينها مع ميثاق الأمم المتحدة بشكل واضح في ما يدعو إليه.
لا يخفى أن التغيرات التي ظهرت على المجتمع الدولي كانت بسبب ظهور العولمة، بحيث كثرت القيود الواردة على السيادة، وهذه القيود يفرضها الواقع على الدول لذلك فهي تتخلى طوعاً أو كرهاً عن جزءٍ من سيادتها بهدف إحداث نوعٍ من التوافق والتوازن مع السيادات الأخرى وذلك بفضل الانتشار الكبير للعولمة وهيمنتها؛ إذ إن عدم انخراط الدولة في العولمة يبقيها خارج التطورات الحاصلة في عالمنا.
يمكن القول إن الخضوع للقانون الدولي لا يعني دمج سياسة الدولة في السياق الدولي أو ربط سيادةٍ بسيادةٍ أعم، بل لابد من الاعتراف بالنِّظام التَّشريعي العام الذي تكون أحكامه ملزمةً لجميع الدول. هذا على الرغم من أن القانون الدولي، من خلال الأجهزة والمؤسسات العالمية كالأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة العمل الدولية، ما يزال يشتغل، إلى حدود اللحظة، لكي يشكِّل هيئةً عالميةً تفوق جميع الدول، تهيمن وتكون أقوى من الدولة القومية المستقلة. يعني ظهور القانون الدولي وجود قوى مشتركة وتقاطعات ومصالح وأهداف استراتيجية قد تكون في صالح هذا التنسيق وهذا التشارك، ولا يمكننا الحديث عن استقلالٍ تامٍّ للدولة في ظل هذه العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية، وكل محاولة للحديث عن الدولة وسيادتها بعيداً عن هذا السِّياق الدولي يظل مستعصياً. هذا وقد ذهب الفقهاء، خاصةً في الفترة المعاصرة، إلى الحديث عن الطابع غير المقيد للسيادة القومية رغم صعوبة الحديث عن مثل هذا التَّحديد في سياقٍ دوليٍّ يشهد تجاذبات وأقطاب وتقاطعات اقتصادية ومجالية وثقافية، وهذا ما يهدد استقلالية الدولة القومية.
تدفعنا هذه القضية إلى التمييز بين القانون، ضمن التشريع القومي، والقانون، ضمن مجال الالتزامات الدولية. وهناك فرضيات تعتمد التعارض بين التَّشريع القومي والقوانين الدولية؛ إذ اعتمدت بعض المحاكم البريطانية مبدأ طاعة القوانين القومية ودافعت عن قدسيتها، بحيث يجب أن تكون في مرتبة أولى ولو تعارضت مع القانون الدولي، واجتهدت المحكمة البريطانية في تفسير التشريع البريطاني وحاولت أن تقوم بنوعٍ من التَّوفيق بين قانون الدولة القومية والقانون الدولي. لكن إذا كنا نفترض، جدلاً، ضمن هذا التصور، أن الدولة القومية ذات السيادة يجب أن تكون لها الأولوية، فكيف يمكننا أن نحدث هذا التقاطع والتوافق الجديد مع القانون الدولي خاصةً وأنه لا يمكننا فصل الدولة القومية عن السياق الدولي؟
فضَّلت العديد من الدُّول الطريقة الأولى ألا وهي الانتصار لسيادة الدولة والقانون القومي، لكن بالرغم من ذلك بحث فقهاء هذا التصور عن آلياتٍ جديدةٍ لوضع مبادئ التَّشريع واجتهدوا في تحقيق التوافق بين القانون القومي والقانون الدولي، ذلك أن أي موقف قد تتبناه المحكمة الوطنية يظل معلقاً ما لم يتوافق مع الالتزامات الدولية، وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق المشرع داخل الدولة القومية؛ لأن الدول، في نهاية المطاف، لا توجد بمعزٍل عن السياق الدولي؛ ومن ثمة يجب أن تكون سيادة الدولة هي سيادة القوانين القومية التي لا تتعارض مع القوانين الدولية سواء كانت القوانين الدولية جزءا من القوانين القومية أو العكس.
لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار أن القانون الدولي يجب أن يكون جزءا من قانون الدولة القومية بحيث يصير القانون الدولي سلطةً مهيمنةً قادرةً في بعض الأحيان على إلغاء القانون القومي. في المقابل يمكن اعتبار القانون الدولي قانوناً أجنبياً لا يمكن الاعتداد به، فإذا تعارض مع القانون القومي يمكننا إلغاؤه. والحاصل أنه يمكن النظر إلى القانونين معا من زاوية المصلحة، فإذا صبَّ القانون الدولي في مصلحة القانون القومي، يمكن لحظتذاك قبول التشريع باعتباره خيارا استراتيجيا، أما إذا تعارض القانون القومي مع القانون الدولي، فيمكننا آنذاك أن ننتصر للقانون القومي وهذا ما أثبتته المحكمة البريطانية.
يمكن القول، بناء على ما سبق، أن ميثاق الأمم المتحدة أكد، خصوصا في الفقرة الأولى من المادة الثانية، على ضرورة احترام سيادة الدولة القومية وذلك بناء على المبادئ الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة. ومنه فإن دلالة السيادة، على الرغم من التغيرات التي لحقتها بسبب تطورات المجتمع الدولي وظهور معايير أخرى، ما زالت تحظى بأهمية كبرى. وعلى الرغم من أن السيادة ليست مطلقة وإنما مقيدة بقواعد القانون الدولي، فإن كل إخلال بها، من قبل الدول الأخرى دون مبرر قانوني، يعد خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة.
تعني السيادة أن الدَّولة حرَّة في تنظيم شؤونها الداخلية ولا تعلو عليها أي سلطة أخرى، وتفرض سلطتها إقليمياً على الأشياء والأشخاص الموجودة التي تنتمي إليها؛ لذلك للدولة حق التمتع بالاختصاصات المتعلقة بوجودها كدولة فهي تتولى طريقة الحكم وتختار ما يناسب أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وتنظم عمليات التشريع والقضاء. وبالتالي، فالدولة هي صاحبة السيادة ولها القرار النهائي للحكم على كل المسائل المتعلقة بشؤونها دون حاجة إلى مشاركة سلطة أخرى. والسلطة ذات السيادة هي القوة التي تقرر بنفسها كل ما يرتبط بمصلحتها دون أية تأثيرات خارجية ولا يمكن للأفراد أن يفرضوا آراءهم عليها فهي حرة في تنظيم شؤونها الاقتصادية واستغلال ثرواتها وهذا ما أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة في كثير من الفقرات والمواد.
يجعلنا هذا العنوان أمام مسألة قانونية ذات بعد آخر، فحينما نتحدث، اليوم، عن السوق الأوروبية المشتركة، والسوق العالمية، والشركات المتعددة الجنسيات، وتجارة الأسلحة، والمصالح العامة، نتحدث عن مرجعيةٍ أخرى لتحديد القوانين الدولية؛ فالقانون الدولي يراعي المصالح المشتركة للدول ويحتفظ بخلفيات قد تمثلها القوة العسكرية وقد تمثلها الثروات، وفي بعض الأحيان تمثلها المصالح السياسية المشتركة.
تتدخل العولمة، بشكلٍ كبيرٍ، في تحديد دلالة السيادة ضمن القانون الدولي. يمكننا الحديث، هنا، عن المصالح المشتركة التي تكون مرجعية لتحديد القوانين الدولية. ومنه فالتشريع ضمن سياق العولمة يأخذ بعين الاعتبار القواسم المشتركة بين الدول والمصالح الاستراتيجية التي تصبح بمثابة خلفية لوضع القانون الدولي.
لقد كان لظهور النظام العالمي الجديد الذي سمي بعد انتهاء الحرب الباردة بالعولمة آثار كبيرة، قد تكون سلبية أو إيجابية، على مفهوم السيادة الداخلية والخارجية؛ لأن العولمة أتاحت فرصة اتساع أسباب التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأصبحت سبباً في تهديد الأمن والسلم الدوليين، وهذا يظهر، بشكلٍ واضحٍ، أثناء صدور مجموعة من القرارات من قبل الأمم المتحدة حول مجموعة من الأحداث نخص بالذكر العراق وأفغانستان، بمعنى أن العولمة هي سياقٌ مهم لفهم السيادة المعاصرة من منظورٍ عامٍّ، كما تساهم في فهم القوانين الدولية وطريقة أجرأتها. ومنه، لا يمكننا الحديث عن السيادة المعاصرة دون الحديث عن المتغيرات الدولية والسياق الدولي الذي أثرت فيه العولمة بشكل كبير. هذا النظام الجديد الذي ظهر نتيجة للتطورات التي صاحبت العولمة هو نظام أحادية القطبية.
أدت الأحداث الجديدة إلى انحصار أهمية مفهوم سيادة الدول، وبالأخص بعد تطور العلاقات في الميادين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية بين الدول؛ فالاتحاد السوفياتي دافع بشكل قوي، في زمن ثنائية القطبية، عن السيادة بمعناها التقليدي. وبالرغم من ذلك فإن احترام السيادة تم التأكيد عليه ضمن ميثاق الأمم المتحدة لاسيما في الفقرة الأولى من المادة الثانية؛ على اعتبار أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة هي حماية مفهوم السيادة.
ورغم التغيير الذي طرأ على المجتمع الدولي تبقى له خصوصيته وأهميته المتمثلة في تبرير ما يحدث اليوم على الصعيد العالمي؛ بحيث إنه في العديد من المناسبات، تعتمد السيادة لتنظيم العلاقات بين الدول. وقد سبقت الإشارة أن السيادة لم تفقد أهميتها حتى داخل المجتمع الدولي؛ فالسيادة ليست مطلقة وإنما مقيدة بقواعد القانون الدولي نفسه، ولا زالت تتأسس على المعايير التي تحقق المساواة والعدالة بين الدول، وأي إخلال بهذه المعايير يكون بمثابة إخلال بشروط السيادة؛ بعبارة أخرى فإن أي إخلال بالقانون الدولي يعد خرقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ إذ يعد هذا الأخير حجةً قانونيةً للدفاع عن السيادة المقيدة.
لا ريب أن التطور الحاصل اليوم في القانون الدولي كان نتيجة لتطورات في العلاقات الدولية بهدف الإبقاء على سيطرة الدول المتقدمة على الدول المتخلفة رغم أن هذا التدافع كان نتيجة لفهم سيئ للسيادة وسوء تأويل للقانون الدولي، وهو الأمر الذي انتقده بعض المتتبعين والمهتمين بالسيادة الدولية، واعتبروا أن الأصل في السيادة هو حماية الحقوق والواجبات المرتبطة بالأفراد وبالدول وليس إخضاع الدول الضعيفة ومحو كل الحقوق التي تتمتع بها[19]
فقدت السيادة المطلقة للدول، في عصر العولمة، فعاليتها؛ بحيث لا يمكن لأية دولةٍ أن تتمسَّك بها في العلاقات الدولية؛ لأنها لا تنسجم مع التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي سواء من الناحية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو السياسية أو العسكرية، بل لقد أصبحت السيادة وسيلةً للاستغلال والتحكم في القوانين الدولية. ورغم ذلك، لا يمكن التخلي، كلياً، عن مفهوم السيادة لتنظيم العلاقات بين الدول، ولكن يجب اعتماد هذا المفهوم في سياقه دون أن تكون هناك خلفيات ومرجعيات تخدم مصلحة دولةٍ دون أخرى. زد على ذلك ضرورة اشتغال المجتمع الدولي على مفهوم السيادة بما يخدم مبدأ المساواة والعدالة بين الدول؛ ويعني هذا الكلام أن الدولة تحتفظ بسيادتها المقيدة لكن لابد أن تراعي في نفس الآن مصلحة المجتمع الدولي. هكذا ونتيجة للتطورات التي طرأت على المجتمع الدولي، في ظل عولمة متسارعة، تغير مفهوم السيادة وتعددت القيود الواردة عليه، وهي القيود التي فرضتها الوقائع السياسية والاقتصادية داخل المجتمع الدولي؛ هكذا لا يمكن الاستيعاب الحقيقي لمفهوم السيادة من دون النظر إلى العولمة التي غيرت ملامح المصالح بحيث أصبحت للسيادة دلالة تتجاوز التصور التقليدي لها. ظلت السيادة ضمن سياق العولمة مرجعاً أساسياً لتفسير وفهم الكثير من الأحداث العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وأخيرا، يمكن القول مع هذه المتغيرات التي أحدثتها العولمة أنه يمكن لأي دولة بهدف تحقيق مصالحها أن تهاجم مبدأ السيادة أو توافق عليه؛ لأن المصلحة الخاصة تبقى مرجعاً وخلفيةً لاعتماد السيادة أو تغييرها. إضافة إلى ذلك فإن استمرار التغير الذي يلحق مفهوم السيادة هو أمر بديهيٌّ نظراً للسياقات المتغيرة والأحداث الدولية المتنامية بشكلٍ مستمرٍ. ورغم كل هذه التغيرات تبقى المعايير ثابتةً؛ ذلك أنَّ الهدف الأساسي من السيادة خدمة المصلحة الخاصة ثم المصلحة العامة مع مراعاة المساواة والعدالة ضمن جميع الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يمكن القول بوجود مجموعةٍ من القيود التي تُفرض على السِّيادة الوطنية وذلك بفعل التطورات الحاصلة داخل النِّظام الرأسمالي الذي يشدِّدُ على الجانب الاقتصادي. وعليه، حينما نتحدث عن الإصلاح الاقتصادي والتكيف الاستراتيجي وَجَبَ القَبول بمجموعة من الشروط الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، بهذا المعنى يصعب الحديث عن السيادة الاقتصادية للدولة في ظل هذه الشروط؛ إذ لم تنج حتى الدول الكبرى من هذا التأثير الذي مارسته منظمة التجارة العالمية خاصَّةً حينما تحررت المعاملات وفرضت مجموعة من البرامج الاجتماعية لتدعيم الصحة، والبطالة، والتعليم. إننا أمام قيود وضوابط تفرضها هاته المنظمات الاقتصادية والمؤسسات المالية العالمية على الدول لكي تتكيف مع النمط الجديد للتجارة ولكي تنخرط في البنية الاقتصادية الجديدة ذات البعد الرأسمالي، أما بالنسبة للدول الكبرى، فقد استطاعت إلى حدٍّ ما حماية نفسها لكونها رفعت من مستوى الناتج الداخلي مع توفيرها إمكانيات تكنولوجية وتقنية لمسايرة هذا التقدم الهائل ذي البنية الرأسمالية في مجال التجارة والتسيير والأعمال، غير أن الدول الصغرى، أو النَّامية حسب التَّعبير الدَّارج، لم تستطع التَّخلص من هذه السُّلطة حيث خضعت، في نهاية المطاف، إلى بنية هاته المنظمة، فأصبحت خاضعة لضوابطها وشروطها، الشيء الذي يبرز التَّهديد المباشر للسِّيادة الوطنية، فحينما تَحدُث مثل هذه التَّبعية يُصبح من الصَّعب الحديث عن حرية القرار داخل الدولة الوطنية. وعليه، إنَّ الدُّول النَّامية هي الأكثر تضرراً لكونها صارت، بشكلٍ أو بآخر، تابعةً للدُّول المركزية.
المراجع
- هيغل، فريديريك. أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، بيروت: دار التنوير، 2007، ص 542.
- نشير في هذا السياق إلى أن مفهوم السلطة pouvoir يختلف عن السيادة souveraineté لكن في هذا السياق نجد هيغل في بعض الأحيان يستعمل السلطة باعتبارها القوة وفي نفس الآن يعتمد السيادة باعتبارها قوة لذلك لا نريد الخلط بين
- السلطة والسيادة لكن مع هيغل كلاهما تمثلان القوة ونجد هذه المسألة تتردد في الكثير من الفقرات والعبارات التي يستعملها خاصة في كتابه “فلسفة الحق”.
- هيغل، فريديريك. أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، بيروت: دار التنوير، 2007، ص 496.
- نفسه، ص 494.
- فؤاد، عبد الكريم، «الأسرة والعولمة»، مجلة البيان، 2006، ص 366، 367.
- الجابري، محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص 136.
- العظم، صادق جلال، ما العولمة؟، دمشق: دار الفكر المعاصر، 1999، ص 125.
- حنفي، عبد المنعم، المعجم الشمال للاصطلاحات الفلسفية، القاهرة: مكتبة ميداوي، 2000، ص 268، 269.
- العظم، صادق جلال، ما العولمة؟، دمشق: دار الفكر المعاصر، 1999، ص 4.
- نفس المرجع والصفحة.
- صديق، محمد رشيق، المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة الجنسية لحقوق الإنسان، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2009، ص 22.
- المراكبي، عبد المنعم، التجارة الدولية وسيادة الدولة: دراسة لأهم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2005، ص: 266.
- نفسه، ص 272.
- سيروان، حامد أحمد. اتفاقيات وضع القوات (SOFA) وتأثيراتها في سيادة الدول واستقلالها، حالة العراق نموذجا، دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي المعاصر، السليمانية: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، 2011، ص 75.
[1] هيغل، فريديريك. أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، بيروت: دار التنوير، 2007، ص 542.
[2] نفسه، ص497.
[3] نفسه، ص 542.
[4] نفسه، ص 497.
[5] نشير في هذا السياق إلى أن مفهوم السلطة pouvoir يختلف عن السيادة souveraineté لكن في هذا السياق نجد هيغل في بعض الأحيان يستعمل السلطة باعتبارها القوة وفي نفس الآن يعتمد السيادة باعتبارها قوة لذلك لا نريد الخلط بين السلطة والسيادة لكن مع هيغل كلاهما تمثلان القوة ونجد هذه المسألة تتردد في الكثير من الفقرات والعبارات التي يستعملها خاصة في كتابه “فلسفة الحق“.
[6] هيغل، فريديريك. أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، بيروت: دار التنوير، 2007، ص 496.
[8] فؤاد، عبد الكريم، «الأسرة والعولمة»، مجلة البيان، 2006، ص 366، 367.
[9] الجابري، محمد عابد، قضايا في الفكر المعاصر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003، ص 136.
[10] العظم، صادق جلال، ما العولمة؟، دمشق: دار الفكر المعاصر، 1999، ص 125.
[11] حنفي، عبد المنعم، المعجم الشمال للاصطلاحات الفلسفية، القاهرة: مكتبة ميداوي، 2000، ص 268، 269.
[12] العظم، صادق جلال، ما العولمة؟، دمشق: دار الفكر المعاصر، 1999، ص 4.
[13] نفس المرجع والصفحة.
[14] صديق، محمد رشيق، المسؤولية الدولية عن انتهاكات الشركات المتعددة الجنسية لحقوق الإنسان، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2009، ص 22.
[15] المراكبي، عبد المنعم، التجارة الدولية وسيادة الدولة: دراسة لأهم التغيرات التي لحقت سيادة الدولة في ظل تنامي التجارة الدولية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2005، ص: 266.
[16] نفسه، ص 272.
[17] سيروان، حامد أحمد. اتفاقيات وضع القوات (SOFA) وتأثيراتها في سيادة الدول واستقلالها، حالة العراق نموذجا، دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي المعاصر، السليمانية: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، 2011، ص 75.
[18] نفسه، ص 85.
[19] نفسه، ص 76، 77.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية