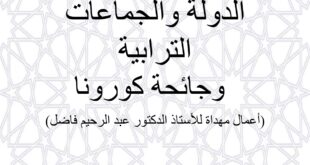مسؤولية الدولة في إطار علم الضحايا
من اعداد: علاء الدين تكتري
باحث في صف الدكتوراه في العلوم القانونية
واستاد محاضر في الدروس التطبيقية بكلية الحقوق طنجة
إن الحديث عن مسؤولية الدولة، لم يكن بالأمر السهل، فقبل الاعتراف بها مرت المسؤولية الإدارية بتطورات تاريخية، ابتدأت بنفي مسؤولية الدولة بكيفية مطلقة، وانتهت بإقرارها كمبدأ عام، اعتبارا لحقوق المواطنين، وضمان لحسن سير الإدارة، مع الاحتفاظ ببعض الاستثناءات التي تبقى فيها الدولة غير مسؤولة عن بعض الأنشطة في ميادين محدودة، نظرا لطبيعتها الخاصة، أو الأهداف المتوخاة منها.
وقبل التطرق في الموضوع وجب وضع السادة القراء الى تفسير مفاهيم الموضوع
وتحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية، على اعتبار أن تحديد المفاهيم هو أحد الطرق المنهجية الهامة في أي بحث علمي وخاصة في أي دراسة قانونية، فالتحديد الدقيق لمصطلحات الرسالة يبدد الغموض ويمنع اللبس ويساعد على الفهم الصحيح لموضوعها، وانطلاقا من ذلك سوف يتم التعرض إلى تحديد المقصود بالكلمات الرئيسية المكونة لعنوان المقال.
1:مسؤولية الدولة:
يقصد بالمسؤولية في اللغة هي مشتقة من فعل “سأله” أو “ساءله” ويقال سأله عن كذا، أي استخبره عنه وجاء في القرآن الكريم ” بأنها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نبدلكم نسؤكم كما جاء فيه” فاسأل به خيرا .
ويقصد بمسؤولية الدولة، التزامها بدفع تعويض لمن يصيبه أضرار، نتيجة ممارسة، النشاط الإداري للدولة، وذلك في إطار أوضاع وأحكام المسؤولية المعمول بها.
ودعوى التعويض هي الوسيلة القانونية القضائية الممنوحة للأفراد والتي يهدفوا من ورائها الحصول على تعويض عن ضرر أصابهم من جراء نشاط إداري للدولة .
ويعتبر مبدأ “مسؤولية الدولة” مبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل السادس من الدستور والذي يقضي بكون السلطات العمومية متساوية أمام القانون، وملزمة بالامتثال إليه، وهذا يعني خضوع الدولة للقانون، وإمكان مقاضاتها أمام القضاء، ونزولها على أحكامه، وهي مسؤولية مرتبطة من جهة بواجب السلطة العامة ويعبئها، ومن جهة أخرى لصيقة بما يطرأ على الحياة العامة من تقدم تكنولوجي، وجريمة منظمة، مما يستدعي مسايرة هذه المسؤولية للتطورات الطارئة .
الدولة لقد وسع بعض الفقهاء من الألفاظ المتصرفة في تعريف الدولة، وضيق الآخر منها، وإن كان المعنى واحد، حيث جاءت تعريفاتهم متضمنة الأركان الدولة وهي الشعب والإقليم والسلطة والاستقرار، فعرفها بعض الفقه، بأنها عبارة عن جماعة من الأفراد، تقطن على وجه الدوام والاستقرار إقليما جغرافيا معينا وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية تستقل من أساسها عن أشخاص من يمارسها .
والبعض الآخر عرفها بأنها جماعة من الناس يقطنون على وجه الاستقرار أرضا معينة ومستقرة، ويخضعون لنظام سياسي وحكومة منظمة مهمتها الحفاظ على كيان هذه الجماعة وإدارة شؤونها ومصالحها العامة .
ذلك أن المسؤولية تعني تحمل التبعات، أي تحمل تبعات الفعل أو الخطأ أو الإهمال والتقصير، وهي إما أن تكون مسؤولية سياسية أو أخلاقية أو مسؤولية قانونية.
فالمسؤولية القانونية إما أن تكون جنائية أو مدنية، حيث أن المسؤولية الجنائية يتولى بحثها التشريع الجنائي، في حين يتولى التشريع المدني تناول المسؤولية المدنية، التي تنقسم بدورها إلى نوعين:” مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بالتزام تعاقدي أو مسؤولية تقصيرية أساسها الإخلال بالتزام قانوني كمبدأ إما بتحقيق نتيجة أو بدل عناية .
والمسؤولية التقصيرية من جهة أخرى إما أن تكون مبنية على خطأ واجب الإثبات ، أو خطأ مفترض أو على أساس نظرية المخاطر .
2:تعريف علم الضحية:
يعتبر علم الضحية فرع من العلم الجنائي، الذي يعنى بدراسة الصفات البيولوجية والنفسية والإجتماعية بل وحتى الثقافية كما يدرس دور الضحية في الفعل الإجرامي سواء في خلق الجريمة أو تسهيلها أو التشجيع عليها، كما إمتد هذا العلم إلى دراسة حقوق الضحية من خلال الإجراءات التي يجب أن يسلكها لضمان حقه في تعويض عادل عن الأضرار الناجمة عن الجريمة سواء من الأفراد أو من الدولة.
فإذا كان مولد علم الإجرام سنة 1876 بظهور كتاب “الإنسان المجرم” للمبروزو lombroso، فإن علم الضحية يعتبر قد بدأ بكتاب « Hansvon Hentig » عن الجاني وضحيته « The criminal and his victime » وذلك سنة 1948 ، حيث بين أن الدراسة النظرية لمكافحة الجريمة ليست لها أهمية دون المعرفة الحقيقية لضحية
ففي الربع الأخير من القرن الماضي- تم الإهتمام أكتر بعلم الضحايا، لإزاحة الستار عن معاناة ضحايا الجريمة بقصد التخفيف عنهم، وضمان حقوقهم التي أهدرتها الجريمة، فانتقل بذلك علم الضحية من العلم الذي يهتم ببيان دور الضحية في الظاهرة الاجرامية إلى العلم الدي يهتم بالدفاع عن حقوق الضحية.
فوضحت أبحاث العلماء ما يجب توفيره لهؤلاء الضحايا من عدالة و إنصاف و رعاية بعد ارتكاب الجريمة و ضرورة اشراكهم في الدعوى الجنائية، و توفير المساعدة لهم في جميع مراحل الاجراءات الجنائية، و اعلامهم بحقوقهم و سبل اقتضائها و تيسير هذه السبل لهم، وتنمية روح التصالح بين الضحية و الجاني، و ضرورة تعويض ضحايا الجريمة عما لحقهم من أضرار، إلى غير ذلك من الحقوق التي ظلت حتى وقت قريب لا تحظى بغير القدر اليسير من الرعاية و الحماية .
ولم يقتصر مجال الإهتمام بدراسة علم الضحية وفق تلك الخطوات ، بل لقد توجت الجهود بإصدار أول مجلــة علمية متخصصة في علــــم الضحية وذلك فــي سنة 1976 تحت عنوان ” المجلة الدولية لدراسة علم الضحية ” .
وبعد كل هذه المجهودات التي قام بها هؤلاء الباحثين في سبيل بروز علم الضحية كعلم مستقل بذاته ، تم تأسيس الجمعية العالمية لعلم الضحية في سنة 1979 ، و نظمت عدة لقاءات دولية لدراسة الضحية، كما عقدت عدة مؤتمرات متخصصة في هذا المجال منها المؤتمرالأول لدراسة الضحايا الذي عقد بواشنطن، والمؤتمر الثاني الذي عقد في روما سنة 1985 و المؤتمر الثالث الذي عقد في طوكيو سنة 1990.
كما بدأت الأمم المتحدة تهتم بهذا العلم حيث عمدت في سنة 1985 إلى إعلان حقوق ضحايا الجريمة وسوء إستخدام السلطة ، ليعقبه بعد ذلك صدور مرشد العدل للضحايا ودليل صناع السياسات بشأن تطبيق إعلان الأمم المتحدة للمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة وذلك في سنة 1999 .
فقد عرف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة رقم 34/40 المؤرخ في 29 نونبر 1985 الضحايا بأنهم ” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو التمتع بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الإنسانية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكات للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء، بما في ذلك القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة ” .
كما نصت المادة 18 من نفس الإعلان على أن ” يقصد بمصطلح “الضحايا” الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.”
ويلاحظ بأن تعريف الأمم المتحدة لضحية قد حدد فئات مختلفة كضحايا الجريمة وضحايا استعمال السلطة.
بالّرجوع إلى النصوص القانونية وبصفة خا ّصة قانون العقوبات الفرنسي نجد أن الضحيّة تعرف على أنها ” كل شخص تعّرض إلى ضرر” أو هي “كل شخص تحمل ضررا ناجما عن جريمة Ayant personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.”
وفي المغرب فقد أوصت ندوة السياسة الجنائية بالمغرب، واقع وآفاق التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام 9 و 10و11 دجنبر 2004 بتوفير الحماية للفئات المستضعفة، ولاسيما إنصاف الضحايا ومساعدتهم.
إلا أن هنالك بعض الفقهاء أمثال الفقيه ” بنيامين مندلسون ” لا يوافق على هذا الاتجاه ذاهبا إلى أنه من الضروري إعطاء مفهوم واسع لعلم الضحية مفاده أن هذا العلم يهتم بدراسة جميع أنواع الضحايا بشكل عام سواء كانوا ضحايا الإجرام أم ضحايا الكوارث الطبيعية أوغير ذلك من الأسباب والعوامل التي تقف وراء تضرر الضحية. لذلك يفضل أنصار هذا الاتجاه تسمية هذا العلم ” بعلم الضحية ” حتى يشمل دراسة ضحية الجريمة وضحية غيرها من الضحايا بشكل مطلق.
وبعلاقة علم الضحية بعلم الإجرام،فهناك من يعتبر أن العلاقة بينهما مترابطة، فإذا كان علم الاجرام يهتم بدراسة الجريمة في مفهوما القانوني باعتبارها واقعة مادية في محيط الجماعات والفرد، ويهتم أيضا بالمجرم من حيث الأسباب الدافعة للإجرام وجوانبه العضوية والنفسية والاجتماعية. اما علم المجني عليه فإنه يهتم بنفس الجوانب لكن لدى المجني عليه وايضا علاقته بالجاني.
بينما يرى الأستاذB.Mendelson أنه يجب الفصل التام بينهما، لأنه من غير الوجيه إقتصار علم المجني عليه على دراسة الجريمة فقط، بل يجب أن تشمل جميع الضحايا.
وهكذا, فإنه مهما تعددت أراء الفقهاء في إعطاء مفهوم موحد لعلم الضحية ، فإن ذلك يظل عمل نسبي لا يخضع لتقنيات محددة ومضبوطة ، وذلك راجع كما أسلفنا سابقا لكونه علم مركب يستحيل جمع عناصر ثابتة وشاملة تسمح بإعطاء تعريف موحد .
و من خلال ماسبق، و إختلاف التحديد الدقيق لمفهوم علم الضحايا، بين من حصره في ضحايا الجريمة ، ومن وسعه إلى كل ضحايا حقوق الإنسان، سوف نعمل نحن في بحثنا هدا على تحديد حدود الموضوع على المفهوم الكلاسيكي، الذي خلق به علم الضحية وكذلك المنصوص عليه في تعريف الأمم المتحدة لضحية والدي يعترف به غالبية الفقهاء والمفكرين، ألاوهو ضحايا الجريمة.
وهكذا بعد تحديدنا للمصطلاحات نتجه لتحديد مدى تحمل الدولة مسؤوليتها في تعويض الضحايا؟
الفكرة التي كانت تقضي بأن يحكم على السلطة العامة، بدفع تعويضات للخواص عن الأضرار التي تلحقها بهم، ليست من الأفكار التي ارتكزت على عرف ثابت، حيث كان مبدأ عدم مسؤولية الدولة هو الراجح، وكان يبدو أمرا غير عاديا أن تثار مسؤولية الحاكم بذريعة أنه ليس بوسع هذا الأخير فعل سوء . غير أن التطور المستمر لتدخل الدولة والتوسع في اختصاصاته في جميع المجالات الحيوية داخل المجتمع، جعل من الجهاز الإداري جهازا ضخما يتدخل في جميع القطاعات، ولا يمكن بالتالي استثناؤه من الرقابة القضائية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انهيار المشروعية.
وقد أدى هذا التدخل إلى ارتفاع عدد الضحايا وانعدام مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة الناتجة عن مختلف أنشطة المرافق العمومية، مع ضرورة أن يتلقى الضحايا تعويضات عن الأضرار التي أصابتهم جراء ذلك.
لذلك سرعان ما تمت مهاجمة مبدأ عدم مسؤولية الدولة بالنقد العنيف من طرف الفقهاء الفرنسيين الذين نادوا بضرورة خضوع الدولة لقواعد المسؤولية، وهكذا ظهر في فرنسا بقلم أحد مستشاري مجلس الدولة الفرنسي “جورج تيسي” كتاب خصصه لمسؤولية السلطة العامة، أثار فيه على وجه التحديد مبادئ التكافل والإنصاف، لدحض المبدأ عدم مسؤولية الدولة، لذلك نشأت قواعد المسؤولية الإدارية أول مرة في فرنسا ـ مهد القانون الإداري ـ ولقد ساعد على ذلك الأخذ بنظام القضاء المزدوج، حيث كان السبب الرئيسي لنشأته في فرنسا هو تعسف المحاكم القضائية وإسرافها في التدخل في شؤون الإدارة، وبعد الثورة الفرنسية، ظهرت الرغبة في نشأة قضاء يتولى فحص المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها .
وهكذا، فقد ظلت الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة ولحقبة طويلة من الزمن غير مسؤولة عن أعمالها المختلفة وكذا عن أخطاء موظفيها، ويعود ذلك إلى الفكرة التي كانت سائدة أنذاك وهي أن الدولة شخص معنوي مجسد في شخص الملك الذي لا يخطئ أبدا The The King can do no worng وأنه امتداد لإرادة وظل الله في أرضه، وهو ما جعله يتمتع بسلطة مطلقة في تسيير شؤون الدولة وعدم خضوعه للرقابة بما فيها الرقابة القضائية.
وأمام هذا التطور الذي عرفته المسؤولية، لم يكن أمام القضاء والمشرع في مختلف الدول، إلا أن يقروا مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية.
ففي فرنسا ساهمت أحكام ومجلس الدولة ومحكمة التنازع في إرساء أسس وقواعد المسؤولية الإدارية، حيث أنه منتصف القرن 19، أخذت المحاكم الإدارية الفرنسية في الأخذ بالمسؤولية الإدارية عن أعمال موظفيها التي تسبب أضرارا للغير من الأفراد أثناء قيامهم بأعمالها الوظيفية، فهكذا جاء حكم “بلانكو” عام 1873، ليعطي للقضاء الإداري الفرنسي، إشارة الضوء الأخر، لشق طريقه بكل جرأة وإقدام في مواجهة السلطة العامة وإيقاع المسؤولية على عاتق الإدارة لتعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد بفعل الأشخاص الذي يستخدمهم المرفق العام، وإن هذه المسؤولية ليست مسؤولية عامة ولا مطلقة بل إن لها قواعدها الخاصة التي تختلف تبعا لحاجات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد.
كما أن المشرع الفرنسي تدخل لإقرار هذه المسؤولية في مجموعة من المواضع والحالات ومن ذلك قانون 8 يونيو 1895 بشأن مسؤولية الدولة عن بعض أخطاء القضاء، وقانون 27 أبريل 1901 بشأن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأماكن المجاورة والبلديات عن الأضرار التي تقع أثناء حوادث الإضرابات والمظاهرات، حتى ولو لم يكن هناك خطأ، وقانون 31 دجنبر 1957 الخاص بمسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تحدثها عربات الدولة.
ولقد اتجه القضاء والفقه الإنجليزي في نفس الاتجاه، حيث أنه حاول بداية من التخفيف من حدة وقسوة مبدأ عدم مسؤولية الإدارة، فقرر في بداية الأمر تكوين لجنة قانونية عام 1921 لنفي مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها، وقد رفعت هذه اللجنة مذكرة بمشروع قانون 1927 يقيم هذه المسؤولية، لكن البرلمان الإنجليزي، رفض إقراره مستندا في ذلك أن إقرار هذا المبدأ يعرض الثروة العامة للضياع، إلا أن المشرع بعد ذلك تدارك الأمر، وأقر … مسؤولية الموظف الشخصية، استنادا إلى السند والمبرر الذي قدمه الفقه في تكييفه في طبيعة العلاقة القانونية التي تربط الموظف العام بالإدارة، وأصبح ذلك القانون ساري المفعول وهو قانون الإجراءات الملكية 1974 .
أما بالنسبة للمغرب، فإن المسؤولية الإدارية قد مرت بنفس التطور الذي عرفته معظم الدول، بالرغم من وجود وزير للشكايات الذي كان ينظر في تظلمات المواطنين وتصارعات بعض الموظفين، وهكذا كانت قاعدة عدم مسؤولية الدول هي السائدة إلى أن صدر ظهير الالتزامات والعقود بتاريخ 12 غشت سنة 1913، الذي قرر فيه صراحة بمبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية، وذلك في الفصلين 79 و 80.
وفضلا عن هذين النصين، فإن المشرع المغربي قد اعترف في الفصل الثامن من ظهير التنظيم القضائي الصادر في 12 غشت 1913 للمحاكم الفرنسية المحدثة في المغرب بالفصل في جميع الدعاوى التي ترمي إلى تقرير مديونية الإدارة العمومية بسبب جميع الأعمال الصادرة عنها والضارة بالغير، وكذا تنفيذ العقود المبرمة من جانبها.
وبالإضافة إلى تلك النصوص ، فإن الفصل 17 من ظهير المسطرة المدنية القديم، قد قرر بدوره اختصاص محاكم الدرجة الأولى بصفة ابتدائية مع قابلية أحكامها للاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى التي ترفع على موظفي الإدارات العمومية، والرامية إلى طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن تدليسهم أو أخطائهم الجسيمة، أثناء مباشرتهم لوظائفهم، وكذا الدعاوي التي ترفع على الإدارات العمومية بطلب تعويض عن الأضرار في حالة إعسار الموظفين المسؤولين. وتطبق الفقرة الثانية من الفصل المذكور على أن نختص نفس المحاكم بالفصل في الدعاوى المرفوعة على الإدارات العمومية، وفقا لنص المادة الثامنة من التنظيم القضائي، وخاصة فيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن سير الإدارات العمومية وعن الأخطاء المرفقية لموظفيها الناجمة مباشرة عن سير الإدارات العمومية وعن الأخطاء المرفقية لموظفيها.
فالمغرب يعتبر من الدول الأولى الذي استلهم التجربة الفرنسية، بأخذه بنظرية المسؤولية الإدارية ونظمها في إطار قانوني يرجع إلى سنة 1913 حيث كانت للمحاكم الابتدائية الولاية الكاملة للنظر في دعاوى التعويض مع الاستئناف أما محاكم الاستئناف والطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى المحدث سنة 1957 محكمة النقض حاليا.
وبمجرد صدور القانون المحدث للمحاكم الإدارية في 10 شتنبر 1993 أصبحت دعاوى التعويض في مجال مسؤولية الدولة من اختصاص المحاكم الإدارية ابتدائيا طبقا للمادة الثامنة التي نصت:”….تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسمها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عدا الأضرار التي تحسبها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام”.وتستأنف أحكام هذه المحاكم أمام محاكم الاستئناف الإدارية المحدثة في 14 فبراير 2016 مع حفظ حق النقض أمام المجلس الأعلى ـ محكمة النقض حاليا .
وهكذا فمسؤولية الدولة تطورت بتطور المجتمع ،فمع إتساع نشاط الدولة في الوقت الحاضر، الذي لم يعد يقتصر كما هو الحال في الماضي على وظائفها التقليدية، بل امتد نشاطها، وأصبح يغطي كافة جوانب الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية…
فمن الطبيعي أن يعجز الفرد عن تلبية حاجاته ومتطلبات عيشه بنفسه، فهو يحتاج إلى مساهمة الدولة من خلال الإدارة لتوفير بعض هذه الحاجيات، الأمر الذي استلزم ازدياد وظائفها وتوسع مجال تدخلها،مما ترتب على ذلك ازدياد المرافق والإدارات العامة.
فالدولة بصفة عامة، بإدارتها وجيشها ومؤسساتها العمومية وما إلى دلك من المرافق، يتم تسييرها من طرف أفراد معرضون للخطأ، ومعرضون من ثمة لإلحاق أضرار بالأخرين، حيث تقوم المسؤولية الإدارية للدولة، التي تفرض على الإدارة تعويض المصابين بالأضرار التي تسببت لهم فيها.
فوظيفة المسؤولية الإدارية، إذن هي وظيفة تعويضية وليست جزائية، تقوم على أساس التعويض المقدم من الدولة من جراء نشاطها أو خطئها، وذلك عندما ينتج عن النشاط أو العمل الإداري المادي حتى وإن كان مشروعا ضررا يصيب الغير في أنفسهم أو ممتلكاتهم، فيترتب عن مسؤولية تختلف في موقوعها، وتتميز في أساسها عن باقي المسؤوليات كونها مسؤولية تتعلق بمرفق عام يؤدي خدمات عامة قصد تحقيق المصلحة العامة .
ومن أهم واجبات الدولة، هو كفالة حماية مواطنيها من التعرض من أي تعدي أو إيداء، عن طريق اتخاذ الوسائل الناجعة التي تحول دون وقوع هذا التعدي أو الإيذاء، أيا كانت صورته أو أيا كانت الوسائل المتاحة لها، سواء التشريعية، الإعلامية، الأمنية والتعليمية وما إلى ذلك، سواء بسبب فعل الغير، أو من جانب الدولة بذاتها عن طريق موظفيها.
وقد تتمكن الدولة بدفع هذا التعدي والإيذاء بتوقيع العقوبة على مرتكب الفعل أو إزالة تصرفه الضار، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا لجبر الضرر، وبالتالي وجب عليها وضع مجموعة من الضمانات والحقوق لحماية الضحايا في كل مراحل المحكمة من تعرضه للضرر إلى حين تنفيذ الحكم لصالحه وتعويضه.
وهكذا فإن من أهم التزامات وواجبات الدولة في البلاد المتقدمة والقانونية، هو كفالة حماية المواطنين المقيمين في إقليمها، سواء أكانوا مواطنيها أم أجانب، أيا كان سبب تواجد هؤلاء في إقليمها، وهذا الواجب هو ما يطلق عليه واجب الأمانة والحماية الذي تقوم به الدولة بمختلف سلطاتها وأجهزتها، والذي من شأنه أن يحول دون وقوع الاعتداء على الأفراد، أيا كانت صورة هذا الاعتداء، وأيا كان شخص مرتكبه.
وبناءا على ذلك، فإذا أخضعت الدولة في ذلك الالتزام ترتب على ذلك تقرير مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، ولكن من الواجب والمتعين، فإن الدولة في حالة تمكنت من دفع هذا الاعتداء أو الرد عليه، حينها يمكنها توقيع الجزاء المقرر لهذا الاعتداء على مرتكبه في حالة التوصل إليه وإقرار مسؤوليته الجنائية والمدنية. أما إذا لم تتمكن الدولة من التوصل إلى هذا المتهم لأي سبب كان، فإن الضحية، يكون قد تعرض لضياع حقه المعنوي والمادي معا، حيث يكمن حقه المعنوي في إحساسه بعدالة الدولة حين يوقع الجزاء الجنائي على المتهم، أما حقه المادي فيتمثل في جبر الضرر الذي لحقه من هذا الاعتداء. ومن هذا المنطلق يتعين على الدولة أن تتكفل بتعويض الضحية، حتى تخفف الألم الذي تشعر به وتشعره بالمعاملة الإنسانية بوصفه إنسانا يحيا في مجتمع منظم.
فالدولة على غرار الأفراد ملزمة بجبر الضرر التي تتسبب فيها لأفراد بفعل نشاطها، فتتحمل المسؤولية، لكونها الحامية للأمن وسلامة المواطنين أشخاصا ذاتيين أو معنويين، ولعل نشاط حفظ الأمن يعتبر من أهم الوظائف التي تضطلع بها الدولة، بهدف حماية النظام العام.
هكذا، فالدولة تلتزم بصفة رئيسية ببدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون تعرض الأفراد إلى أي ضرر كيفما كان، فإذا وقع الضرر، كان على الدولة واجب العمل على إصلاحه .
إن الحديث عن أساس مسؤولية الدولة عن أضرار الفعل الإجرامي وما يخلفه من آثار على الضحايا، يدفع إلى إبراز الخيط الدولة وبين من يطالبها بتغطية أضراره في إطار وظيفتها الأساسية . وفي ظل دستور المملكة الذي نادى في تصديره بإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن، كما أضاف في فعله 21 بأن السلطات العمومية، تضمن سلامة السكان، وفي فصله 20 بأن القانون يمي حق الحياة، باعتباره أول الحقوق لكل إنسان، مما يستنتج أن الأمن، وظيفته سيادية من وظائف الدولة، بل من أجله خلقت حسب فلاسفة العقد الاجتماعي.
إن صور الأمن تتجلى: في الأمن المادي، ويدخل ضمن اختصاص الأجهزة المكلفة به، باعتبارها المنشأ للمحافظة على النظام العام في بعده الأمني، ووظيفة هذا الجهاز هو إشباع حاجة المواطن في العيش المشترك والمستقر .
فأي تقصير في عدم تفعيل الدولة استراتيجية محكمة في ميدان الأمن، و عدم سهرها على ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، و توظيفها مفهوم الأمن الحمائي، الذي يندرج في إطار ما يصطلح عليه بالأمن الاستباقي، ، مما يتعين تحميلها المسؤولية عن التراضي.
ومن جهة أخرى فبالنسبة للأمن الديني، نجد أن الدستور أكد على وجود شرعية الدين في نظام الدولة خاصة في فصله 41 إذ نص على أن” الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية” كما نص في فصله الثالث على أن الدولة تضمن لكل واحد، حرية ممارسة شؤونه الدينية في ظل دين الدولة الذي هو الإسلام، هذا الدين الذي يدعوا إلى الرحمة والتقوى والتضامن وحماية حقوق الأفراد كيفما كانوا دون تمييز باللون أو الجنس أو الدين أو العرق…
من هنا نتساءل أين دور العلماء والوزارة المختصة في نشر الإسلام الرحيم المعتدل قيمه الحميدة، فالابتعاد عن الدين من الأسباب التي تدفع الفرد لارتكاب الجريمة لأنه ليس له رادع ديني أو خوف من العواقب في الحياة الدنيا والآخرة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى أن بسبب هذا التقصير الأمني للدولة دفع بعض الأفراد مثلا في جرائم الإرهاب، من اتخاذ هذا الدين الحنيف كعبائة لتحليل جرائمهم الإرهابية، وإصدار قنوات تدعوا إلى التطرف، بعيدا عن الإسلام الحقيقي، والذي نص الدستور على أسسه في الفصل 41 كدين حنيف مقاصده سمحة، أي بعيد عن العنف .
أما فيما يخص الأمن القانوني، فالدستور ينص في فصله السادس بأن القانون، هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع ملزم بالامتثال له.
إن مكافحة الجريمة وحماية الضحايا من السلوك الإجرامي، يكون عن طريق إصدار قوانين تحصين الأفراد في حالة تعرضهم لضرر سواء قبل ارتكاب الجرم أو أثناء النزاع عن طريق أجهزة العدالة، لكن بالرجوع إلى التشريع الجنائي المغربي يتضح خلوه من حماية كافية من حقوق الضحايا مقارنة مع الحماية الممنوحة للمتهم في جميع أطوار المحكامة.
وبناءا على ماسبق يتضح القصور الواضح في حماية الدولة للأفراد وبالتالي وجب عليها تحمل مسؤوليتها وتعويضهم.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية