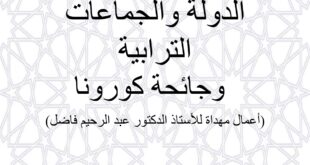تقديم
أشرّ الفعل الانتفاضي في دول الربيع العربي عموما، ومصر خصوصاً على سعي شعوبها بلورة شرعية ديمقراطية مناهضة لشرعيات القهر المنهارة، أجاد الثوار في سبيلها فن التعبئة والتواصل ضمن فضاءات اعلامية والكترونية موازية أفلتت من دائرة الرقابة الأمنية، وأتاحت مساحات مريحة للنقد السياسي والإبداع والمخيال السياسي.
اشتعلت الساحات، لحظة اندلاع الانتفاضات بالعديد من الأماني اللاهثة خلف صناعة حالة ثورية تلفظ الأنظمة السياسية المُحنطة في تونس ومصر واليمن، وتمدُّ المواطن بأسباب التغيير الإيجابي نحو الهدف المجتمعي الذي يحمي المكتسبات الأولية ويطلق الطاقات الخلاقة ضمن مناخ يصون كرامة الإنسان والوجود السليم لبناء مؤسساتي يستنير براهنية الهبّة المجتمعية التي تؤسس لمتطلبات التغيير المنشود.
بعد مرور ست سنوات، بعكس ما كان منتظراً من أن تفضي هذه الحركية إلى انبثاق صفوّة سياسية جديدة تدير المرحلة الانتقالية بأولويات تراعي الطلب الشعبي على الديمقراطية وتقطع تدريجياً مع رواسب الإرث الاستبدادي، انقلبت الصورة رأساً ومعها كل المفاهيم والتطلعات حين رفعت القوى المضادة للتغيير من درجة تأهبها لتفجير المرحلة وتجريد النخبة الجديدة من كل آليات التغيير مما حالَ دون صناعة توليفة سياسية مقبولة من لدن الجميع لتتوه أغلب بلدان “الربيع العربي”، مصر وليبيا واليمن، في الفترة الانتقالية بحروق مجتمعية وفشلٍ ذريع للدولة في الوفاء بوعودها وانحدارها إلى فوضى رهيبة تصارع تحديات الهوية وتداول السلطة.
تبزغ تساؤلات ملحة: لماذا لم تفلت الدولة من مخالب النظام القديم؟ وهل ما يجري في مصر على سبيل المثال منذ الإطاحة بحكم “محمد مرسي” هو انعكاس منطقي للثبات الثوري الموسوم بالتعثر الانتقالي والتنازع على الشرعية أم أن ذلك بمثابة إعلان عن ضياع “ثورة يناير” وسرقتها على طريقة “القرصان مورغان”؟ ما الخلل في الحراك العربي؟ هل تعثر المسار الانتقالي يحيل إلى أنموذج انتفاضي جديد؟ لا سيما في ظل اتساع الخلاف وتحوله من تنافس حول “الديمقراطية” إلى صراع حول “الدولة”؟
المبحث الأول: الإرث السلطوي
كان من أكبر انجازات النظم الحاكمة في بلدان الربيع العربي على مدى عقود من تداول حكم شعوبها لاسيما في مصر، اليمن وسوريا أنها أفرزت طبقة سياسية واجتماعية أفلحت في تكديس سلطوية رهيبة، راكمتها بمنطق عائلي وعشائري بمنأى عن القبول الطوعي لشعوبٍ جرى تعطيل إرادتها تحت طائلة التهديدات الداخلية والخارجية.
ولم يكن، بمقدور هذه الأنظمة الاستئثار بالدولة دون خلق منظومة سرطانية حارسة للسلطة والثروة من أي انتزاع، بصورة جعلها مضادة بشكل آلي لأي مبادرة تغييرٍ نابعة خارج الرغبة السلطوية، وكان من مآلات ذلك تغوّل النخبة الحاكمة في شرايين الدولة وتفكيكها للمجتمع وشخصنتها الدولة، في مقابل هضم الحقوق السياسية والمدنية والثقافية للمواطن وتجميد تام لنصوص الدستور.
ظل الواقع، كما أرادته هذه النخب إلى أن داهمت باغت الشارع العربي التكوين الداخلي القائم، محدثا صدمة كبيرة في مزاج سياسي متكلس لم يألف الاعتراض الشعبي على “أوضاع الأمر الواقع”، وذلك لما يحمله السخط الجماهيري من آمال هدامة لتطلعات الطبقة الحاكمة في استدامة وجودها المزمن في قلب النظام القائم، ما فرض عليها وضع استراتيجيات مواجهة تلتف على الشعوب. أصبح الهدف المشترك هو إجهاض الثورات ووقف تمرد الشعوب، إن وبمعاقبتها على نقض التفويض الحصري واللامشروط للقائد في حكم الدولة والشعب.
انبثق نظام الحكم الحالي في مصر من ثورة قادها الجيش، فيما عُرف بـ “ثورة يوليوز 1952 أو ثورة الضباط الأحرار” التي لم تكن سوى إزاحة لنظام ملكي رسمي مقابل إحلال نظام جمهوري بمواصفات ملكية، وذلك بعد تصفية الطبقة الحاكمة القديمة واحتلال مواقعها من قبل المؤسسة العسكرية التي أسست نخبة جديدة تسهر على إدارة شبكة متشعبة من الفساد السياسي والريع الاقتصادي والولاءات العسكرية التي تقوّت بإدخال فئة الضباط إلى شريحة المنافع التي كان يقودها الرئيس السابق “حسني مبارك” وهو ما استحال الأمر إلى خلق شروط معادية للديمقراطية[1] شكلته فيما بعد ما عرف بـ “الدولة العميقة”[2] أو “الفلول”.
اتسم تعاطي “الدولة العميقة” مع ثورة يناير2011 بنوع من المكر السياسي؛ بدايةً سلكت سبيل الانحناء للغضب الجماهيري من واقع الأوضاع السائدة بعد الفشل في ردعه بالعنف النظامي، لكن المأزق الحقيقي طُرح في كيفية امتصاص غضب الشارع على المدى المنظور دون خسائر تودي بمواريث الطبقة الحاكمة، لاسيما أن الجيش باعتباره أقوى كيان في الدولة لم يكن مؤهلا، حينها، بالشكل المطلوب لاستلام السلطة وأقل جاهزية للتعامل مع حالة مدنية متدفقة، فاقتصر دوره في مرحلة أولى على فض الاشتباك بين المتظاهرين الثائرين وجسم النظام الذي تنتمي إليه مؤسسته، رفعاً لتداعي حلقاته.
أمام تراجع منسوب الاحتجاج الشعبي، بعد تنحي “حسني مبارك” وتفويت السلطة إلى الجيش، بدأت “الدولة العميقة” تدريجيا في استيعاب مجريات المرحلة ومعاينة تناسلات الحدث المزلزل بما تطلبه تواريها الوقتي عن الساحة، مادام المطلوب هو مجانبة غضب الشارع وتأثيث المشهد ببدائل سياسية مقبولة لا تستفز المزاج العام. المُستاء من حكم النظم العلمانية المتسترة خلف الايديولودجية العروبية[3] وما خلفته من كوارث عسكرية ومحن سياسية ومعضلات اقتصادية ناتجة عن فردانية الحكم وربط الدولة ببقاء الحاكم، في تعطيل شبه كلي لآليات اشتغال الدولة، إلا ما اقتضته ضرورات تجميل الحكم بآليات صورية نابعة من داخل السلطة.
في ضوء الانسحاب التكتيكي لرموز النظام السابق، اتسمت فترة ما بعد ثورة 25 يناير بدينامية ملحوظة نحو تشكيل فضاء مدني يستوعب كل التشكيلات المجتمعية إثر حيازة بعضها شرعية قانونية طالما حرمت منها عقودا طويلة وعلى الخصوص الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية التي أبانت عن جهد نظري في متن خطاباتها لتجسير الهوة بين الديمقراطية والمواطنة وتأصيلها في الفكر الإسلامي.
تبعاً لذلك، نُظمت أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تحت أعين المجلس العسكري، حملت “حزب الحرية والعدالة”- الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين- إلى السلطة بعد حوالي 85 سنة من المعارضة. فوزٌ كان متوقعاً في مصر كما تونس، وعاكساً القدرة التنظيمية لهذه الأحزاب على التعبئة الشعبية الموازية بفضل تواجدها العمودي المكثف في المجتمع. ومع توصيف بلوغ”حزب الحرية والعدالة” هرم السلطة كتحول نوعي ضمن منظومة طبَعها التقييد القانوني والتزوير السياسي لعدة عقود، لكن الحدث لم يكن بالأهمية ليعلن عن أزمة سياسية أو قلباً لثوابت الواقع الاستراتيجي السائد في مصر، كما أفصح عن ذلك تتالي الوقائع؛
ظاهريا، تطلبت هبّة “يناير” تغيير واجهة الحكم لتهدئة الشارع وتصويره بكون قواعد اللعبة السياسية استدعت احتواء ودمقرطة نزعات الإسلام السياسي، إلا أنها كانت خطوة تُواري في طياتها مخاطر محسوبة من جانب الدولة العميقة، هدامة للبنات ديمقراطية جنينة، مثلما هي فرصة للتخلص من فصيل سياسي ذي خلفية دينية، مزعج للدولة العميقة عبر تهيئة ظروف مواتية للقيام بعملية فرز فئوي للإسلام السياسي، وعزل بعضه عن بعض بمقولات المعتدلين والمتشددين بغاية تدجينه وإفراغه من قاعدته الشعبية.
زُج بحزب “الحرية والعدالة” لخوض معارك حديث العهد بها يعوزه في تدبيرها رؤية شمولية، مما حفَّ تجربة حكمه بعديد المخاطر:
أولها: حداثة عهد الحزب بالشأن العام وافتقاره إلى الثقافة السياسية اللازمة لتدبير مرحلة انتقالية مطلوب احتوائها لكل الفرقاء، كان أشبه بتجرع سُمٍ بطيء سرى مفعوله في المشهد الداخلي مُحدثاً تشوهات واضحة على اصطفاف ثورة يناير مع الوصول إلى نقطة تناقضت فيها الأهداف وافترقت المسارات بين الثوار ليعود كل فريق إلى التخندق في ثكناته الدينية والسياسية، لاسيما أن تذبذب أداء الرئيس المنتخب “محمد مرسي” في عامه الأول سياسيا، واقتصاديا وأمنيا في ظل التركة الثقيلة لنظام “حسني مبارك”، فضلا عن النظرة النمطية إزاء الجماعة بكونها حاملة لمشروع فئوي تسعى لتعزيز نفوذها وبسط هيمنتها على المؤسسات الرسمية، كل ذلك عزز المخاوف بوجود مخطط لـ”أخونة الدولة”[4] وأفضى إلى رفض كيان الدولة حكم “الإخوان المسلمين[5]؛
ثانيا: اختلاط الحيز العام والحيز الخاص لدى الفاعلين في عموم المشهد المصري؛ من جهة أولى واجه حزب “الحرية والعدالة” باعتباره رأس السلطة التنفيذية معضلة رئيسية تمثلت في تأرجحه بين استحكام الذهنية الرافضة للسلطة الحاكمة زمن تموقعه بالمعارضة وبين رغبته في العمل السياسي من موقع السلطة، دون توافر حوامل ثقافية تجسّر هذا الانتقال، ما وسَم سلوكه بالارتباك والتناقض أوقعه في مأزق التعامل مع النظام والعلمانيين ومؤسسات القديم[6].
من جهة ثانية، تظهر المؤسسة العسكرية أقوى الفاعلين في المشهد المصري، وهي قوة اكتستبها منذ سنة 1952 وتقوّت بعيد إبرام اتفاقية “كامب ديفيد” ومعاهدة “السلام المصرية/ الإسرائيلية” سنتي 1978 و 1979 التي أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، حيث انخرطت المؤسسة العسكرية في غمار الاقتصاد عبر الاستثمار والتخطيط لمشاريع ضخمة ومتنوعة وحيازة نواتجها الربحية، في وقت كان التضييق على المبادرة الفردية يتناسب عكسيا مع تسلط العسكر على كل شيء من التجارة إلى الصناعة والتعمير، إلى حقوق الملكية، وهي أنشطة تعدُ في آن واحد البوابة الخلفية لكبار العسكريين المحالين على تقاعد مريح.
كان لذلك، أثر سلبي على الدور الوطني للجيش، أفقده موقعه الحيادي مُغيّباً الحدود بين أدوار أمنية أصيلة منوطة به وبين أنشطة اقتصادية مكتسبة، ذلك أن إنجاح مشاريعه الاستثمارية لا يحول دون استحضار صفته العسكرية، والذود عنها بل واستدعاء العسكر من الثكنات بذخيرتهم كلما استشعر خطر المساس بها. لم يكن على استعداد لأن يخسر أياً من صلاحياته المتراكمة منذ سنة 1952 وهذا ما يعكس الموقف الساخط للمؤسسة العسكرية من السياسات الاقتصادية التصحيحية للرئيس “محمد مرسي” في قناة “السويس”، بعدما قُرأت كتطاولٍ على منظومة امتيازاته وعلى أنها محاولة لتحطيم سيطرته على الفضاء الحيوي الدولي وإنهاءً لوصايته على الدولة ككل.
بالمثل، كان مضمون خطاب المعارضة جزءً من منظومة عملت على أدلجة الوعي الجماهيري بشكل معاكس لأهداف التغيير، وهي معارضة لم تكن سوى تجميع وتوحيد كتل سياسية وايديولوجية استطاعت تحديد موقعها انطلاقا من حكم “الإخوان المسلمين” ممثلةً أساسا في “جبهة الانقاذ الوطني” التي جمعت الأحزاب غير الإسلامية وأعضاء “الحزب الوطني المنحل” و”حركة السادس من أبريل” بمصلحتها المشتركة في العمل مع بعضها للإبقاء على المعادلة السياسية القديمة بالتعاون مع الجيش، وفي سبيل ذلك لم تتوان عن شيطنة السلطة الحاكمة وضخ الأكاذيب بعدم أهليتها للحكم.
بموازاة ذلك، أطلّ شبح “الفتنة الطائفية” برأسه من جديد مع ما شهدته البلاد من مواجهات دامية كـ “أحداث دهشور:” في 27 يوليوز 2012، وأحداث “الخصوص” في 5 أبريل 2013 ثم أحداث “الكاتدرائية” في 7 أبريل التي أعادت للأقباط خشيتهم التاريخية من كل الحركات الإسلامية، فيما زادهم العلمانيون بشراسة خطابهم رعبا ورهقا.
المبحث الثاني: ضدية اشتغال المؤسسات السيادية
كان من الصعب على الرئيس المنتخب “محمد مرسي” تفكيك مفردات سلطة تزاوج بين السياسة والمال في رباط كاثوليكي لا يطاله الانفصام والفسخ، كما لم يكن من غير الممكن نجاح سياساته في وقت تشتغل فيه مؤسسات الدولة السيادية بضديةٍ تامة للمقاصد الوطنية.
إذ وبمنطق الترقب والترصد، تأهبت “منظومة الدولة العميقة” ككتلة متراصة لتفخيخ الخطوات الأولى للحكم المدني، بألغامٍ سياسية واقتصادية وقلاقل أمنية، أسعفها في ذلك الامساك بشرايين الدولة من مال وإعلام وتحكمها بالمؤسسات الحيوية.
انخرط الإعلام المشدود بالمال السياسي )الإعلام نفسه الذي حارب “ثورة يناير” حتى اللحظة التي استقل فيها الرئيس السابق سلم طائرته( في حملة تحريضية مرعبة ضد السلطة الجديدة والإصلاحات التي باشرها الرئيس”محمد مرسي” عقب اعتلائه سدة الرئاسة في 24 يونيو 2012، وضعته أمام غضبٍ شعبي متعاظم.
إلى ذلك، انتصب جهاز القضاء لإبطال مفعول السياسات الجديدة الرامية إلى معالجة الأوضاع الأمنية والسياسية المأزومة كجواب على ما مسّه من شططٍ جراء “الإعلان الدستوري المكمل” المُستتبَع بعزل النائب العام “عبد المجيد محمود” في نونبر 2012 ودستور 2012. زد عليه أن القائمين الحقيقيين على إدارة المرحلة الانتقالية هم من أتباع النظام السابق، ترجمه الانسحاب المتعمد للمؤسسات السيادية من الإطار العام وما خلفه من فوضى أمنية في أحداث “قصر الاتحادية” سنة 2013.
أفضت الأحداث، إلى تجديد القوى الممانعة للتغيير آلياتها بل واستماتتها في إظهار كيان الدولة رافضا لـ “جماعة الإخوان المسلمين” مستخدمة إياها فزاعة لاستعادة قبضتها على الدولة، وتوجيه دفة الأحداث لصالح تعميق الانقسام الحاصل بين الفرقاء الاجتماعيين، انقسام وإن كان يشكل جوهر التدافع الديمقراطي بيد أنه جرى تصويره على أنه انقضاض على الدولة وتديّين قسري لها.
وكيفما كان التقدير، لمدى الانشقاقات الداخلية التي عسّرت تجربة الإسلام السياسي في مصر، لا يُتصور في إطار الأحداث الادعاء أن ذلك يستجيب لمتطلبات داخلية محضة، فحضور المعطى الاقليمي والدولي بدا جلياً في تلوين الوقائع. وقد تمثلت المواقف الأمريكية بالأساس تجاه الثورة المصرية باستخدام “القوة الناعمة” تفادياً لإثارة الرأي العام على الرغم من أن الثورة اندلعت ضد نظام يُعدُّ في مصاف حلفاء الولايات المتحدة شأنها في ذلك شأن النظامين التونسي واليمني، مما طبع موقفها بعدم الوضوح والتخبط على طول المراحل في أفق استقراءها توجهات السلطة الحاكمة الجديدة، وهو استقراء يجد سنده في ضرورة الحفاظ على الواقع الاستراتيجي الذي فرضته “اتفاقية كامب ديفيد” العازلة لمصر عن الانخراط بالشأن الفلسطيني، إلا في حدود التماهي مع الموقف الإسرائيلي.
من منطق فرضِ القبول بالواقع، نُظر لإجراءات الرئيس “محمد مرسي” كتهديد لمعادلة قائمة: دوره في إنهاء العدوان الإسرائيلي على “قطاع غزة” سنة 2012 وفتحه للمعابر ومناقشته لبنود التهدئة سنة 2012، مع ما قد يترتب عن ذلك من قلب لموازين المقاومة فضلا عن الدخول على خط الثورة السورية، وتعزيز فرص الحركات الإسلامية في لعب دور ومهم في صنع القرار الداخلي[7]. قوبل ذلك فيما بعد بضغط أمريكي خفي باتجاه تحجيم دائرة الرئيس “محمد مرسي” عبر استثمار العلاقات المتينة مع الجيش الذي يشكل حجر الزاوية، والحاكم في أية معادلة على الأرض لاحتكاره القوة اللازمة لفرض رؤاه ورؤى مؤيديه.
استطرادا، استعادت منظومة النظام السابق عافيتها وأمسكت بفرصة تاريخية لضخ دمٍ جديد في شرايينها وإعادة تأهيل نفسها بعد الركون إلى احتياط شعبي مناهض لحكم الإسلاميين، مُخولة لنفسها دور المؤتمن على الدولة وأحلام الشعب من “الاختطاف”.
ضمن هذه الظروف، وما واكبها من شغب المعارضة وتحريض الاعلام وتسلط القضاء، خرجت مظاهرات 30 يونيو 2013 مدفوعة بحالة استقطاب واصطفاف غير مسبوقتين، التقطها الجيش الحائز على تحالف الأضداد السياسية والإيديولوجية ومنهياُ بالدم يوم “3 يوليوز” شرعية نظام مدني منبثق عن اختيار شعبي حر، ويطل بواقع جديد ذو شرعية مصطنعة تحت مزاعم وأباطيل ثورية تدّعي تصحيح مسار ثورة “يناير”، أحالت مصر إلى إعادة إنتاج نظام شمولي يسمح بتوليد ميول سلطوية أكثر تطرفا وبمرجعية متينة لبنية النظام الرئاسي المصري القابل لتراكم السلطة والانسياق بالدولة نحو التمزق والتحطم[8].
برؤية قانونية ووفقا للمفهوم الفني للانقلاب، ما حدث في “3 يوليوز” هو انقلاب في نظام قائم، بخلاف الثورة التي تعيد بناء الدولة والمجتمع معا يسبقه اعتراض شعبي عام، هذا فيما لم يرى أنصار “الثورة المضادة” الانقلاب سطواً على أحلام الثائرين بل تصحيح خطأ مطبعي شابَ “ثورة يناير” كغلطة جرى تصويبها مع منح “حسني مبارك” ونظامه شهادة تقدير متأملين إياه تزويدهم بالنموذج الأصلح للحكم.
بخيار اللعبة الصفرية، أضحى المشهد اقصائيا لا يحتمل التناقض ولا يتسع لأكثر من منصة واحدة؛ بين من أُعدت لهم المنابر ولا رصيد لهم غير العداء لتيار “الإخوان المسلمين” وبين من أُسكتوا وحُشروا في خندق أحالهم من أغلبية حاكمة إلى أقلية تقتلع جذورها قطعاً لأي فرص محتملة تعود بها إلى المشهد مجددا، إن بالحظر القانوني كما بالقوة المميتة الحاملة لكل معاني الانتقام واستعادة الهبة الأمنية الضائعة، كما حدث في “مجزرة فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة”، وهو ما يومئ بإحياء «الدولة الأمنية» التي كان قد بناها الرئيس السابق “حسني مبارك”[9].
في مقارنة بسيطة بين فترتي حكم “محمد مرسي” و “أبراهام لينكولن” مع اختلاف التحقيب التاريخي وإن كان القاسم مشتركٌ بينهما، أن رئيس الولايات المتحدة فاز بانتخابات 1861 بنسبة “أربعون بالمائة” وهي نسبة تقل عن تلك التي فاز بها “محمد مرسي” في الدورة الثانية، بيد أنه ورغم ما تعرض له الأول من شغب المعارضة وتحريض الاعلام ومضايقات القضاء، إلا أنه نجح في تمكين الولايات المتحدة من عبور تلك المرحلة الحساسة بنضج الذهنية الشعبية المنحازة للتغيير الايجابي، وهو عكس ما شابته أول تجربة حكم مدني في مصر أُجهضت بمقاومة مجتمعية لعملية التغيير نتيجة عدم ترسخ الفكرة، والأكثر عدم تكيف الدولة العميقة مع التطلعات الجماهيرية التواقة إلى الحرية والعدالة والديمقراطية.
عموما، ركبّ حدث “يناير 2011” العديد من الوقائع والثنائيات المتقابلة؛ ثنائية فشل المشروع القومي وبزوغ المشروع الإسلامي؛ جمود النظام مقابل حركية المجتمع، وفي خضم ذلك افتقدت مرحلة الانتقال السياسي للإسناد للثقافي المواكب لتأهيل مجتمعي يجعل المجتمع في مستوى المشاركة السياسية المطلوبة في المجتمعات الديمقراطية التي ليست مجرد تقنية تختزل في صناديق الاقتراع[10].
خاتمة
أياً كانت القراءات، من الثابت أن تنميط “الفعل الاحتجاجي” بصيغة الهدم المباشر لهرم السلطة دون أن يطال بنيتها الذهنية والثقافية كما “ثورة يناير”، قد أسهم في كبح عجلة التغيير وحصرها في خانة الأماني والتطلعات دون ملامسة واقعية لمفهوم الثورة، فكان إعلان النصر بتنحي الرئيس سقوطا مدوياً في فخ الرغبة اللحظية، لأن تواري “الزعيم” لا يعني بكل الأحوال أفول النظام الحاكم بقدر ما يرمز لعملية تحويل زمني لمواقع السلطة وبحثٍ عن مرتكزات جديدة للقوة في سياق انتقالي اتسم بعصيان إداري ومؤسساتي خاضته أجنحة الدولة العميقة التي دفعتها غريزة البقاء إلى التكيف الوقتي مع وضع فجائي ومن ثم العودة للدفاع بشراسة عن مراكزها، حتى لو كانت الكلفة على حساب حظ الشعب المصري من الديمقراطية، ونصيبه من العيش الكريم.
– كمال عبد اللطيف، الثورات العربية: تحديات جديدة ومعارك مرتقبة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 2013، ص: 58.[1]
[2]– يحدد الأستاذ “عبد الله ساعف” “الدولة العميقة” بأنها تلك لمواقع التي استمرت لمدة طويلة، وقد تكون عبارة عن عسكر أو مصالح أمنية حسب
طبيعة الدولة وتكتسب مع مرور الزمن صفة الثبات وتحتكر السلطة الحقيقية في البلاد. انظر: . ساعف يحدد تجليات “الدولة العميقة” بالمغرب ويرصد دوافع
الانفصال“. حوار مع مركز هسبريس للدراسات والإعلام، بتاريخ: 17 ماي 2016. انظر الموقع الالكتروني:
http://www.hespress.com/orbites/306480.html
– كمال عبد اللطيف، الثورات العربية: تحديات جديدة ومعارك مرتقبة، مرجع سابق. [3]
– هشام العوضي، “الإسلاميون في السلطة: حالة مصر”، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 413، تموز/يوليوز 2013[4]
ص: 29 و 35 و 36.
[5] – عمرو محمود الشوبكي، كيف سقط حكم الإخوان؟،(مركز كارنيغي للسلام العالمي،01 آب/أغسطس2013)، انظر:
http://carnegieendowment.org/2013/08/01/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/gh1r
[6] – شريف محيي الدين وآخرون، الإسلاميون وآليات التغيير في الدولة، في: “مقاربة إشكالية الدولة في خطاب الإسلام السياسي”، المركز الثقافي
العربي، مؤمنون بلا حدود، سلسلة أبحاث، العدد الأول، الطبعة الأولى 2014، ص: 165.
[7]– صالح النعامي، العقل الاستراتيجي الإسرائيلي: قراءة في الثورات العربية واستشراف مآلاتها، الدار العربية للعلوم ناشرون، مركز الجزيرة
للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى 2013، ص: 19.
[8]– سلمان بونعمان، فلسفة الثورات العربية: مقاربة تفسيرية لنموذج انتفاضي جديد، سلمان بونعمان، مركز نماء للبجوث والدراسات، بيروت، الطبعة الأولى
2012، ص: 82.
– يزيد الصايغ، إعادة بناء (الدولة الأمنية) في مصر، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 22 غشت 2013، (موقع إلكتروني) انظر:[9]
http://www.carnegie-mec.org/2013/08/22/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1/gjq8
– كمال عبد اللطيف، الثورات العربية: تحديات جديدة ومعارك مرتقبة، مرجع سابق، ص: 65.[10]
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية