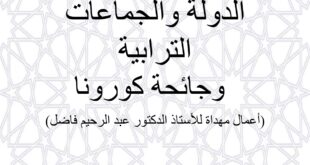تجليات الوعي بالدولة في “انقلاب تركيا الفاشل”
عزالدين أوعلي
باحث في سلك الدكتوراه بشعبة القانون العام والعلوم السياسية
كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية. سلا الجديدة
جامعة محمد الخامس- السويسي
مقدمة
بعد عقود سياسية من وصاية الجيش على الدولة، لأول مرة في مسيرة الانقلابات العسكرية المتواترة في تركيا، وفي مشهد قل نظيره بالعالم، يهبُّ الشعب لإنقاذ الدولة وتخليصها من سطو العسكر حائلا دون تهاويها وإتمام الأخير لمسيرته في تغيير الخريطة السياسية وخلط التوازنات وصياغتها من جديد، بدعوى حماية الحقوق والحريات و”تأمين العلمانية ضد غلو الإيديولوجية الدينية لحزب “العدالة والتنمية الحاكم”.
تتصدى هذه الورقة، لإشكالية أساسية: أين تجلت عوامل فشل انقلاب الجيش على السلطة في تركيا؟ كيف تعاطت النخبة السياسية مع محاولة المؤسسة العسكرية وأدَ التجربة الديمقراطية؟
تروم هذه الورقة إثبات فرضية رئيسية مؤداها أن تطور نظرة المواطن للدولة وفرت مناعة ذاتية لحمايتها من قبضة الجيش، كما وفرت صمام آمان دون إهدار المكتسبات الديمقراطية.
الفرع الأول: تناقضات العلمانية التركية
تلبست العلمانية التركية مُسوحا شرسة غداة إلغاء الخلافة في 3 مارس 1924 وميلاد الجمهورية التركية عام 1922 على يد الضابط “كمال أتاتورك” باستدعاء الأنموذج العلماني الفرنسي (laicite )القائم على الفصل القاسي والتعسفي بين الدين والدولة، باجراءات أخرى: التخلي عن المرجعية الإسلامية للدولة، إغلاق المدارس الإسلامية وإلغاء المحاكم الدينية، حظر الحجاب ومنع تدريس اللغة العربية والفارسية مقابل تعاظم النزعة العرقية، فضلا عن سنّ قوانين هجينة في المعاملات الشرعية. هذه التدابير وإن ترجمت الرغبة في محاربة كل أشكال حضور الدين في الحياة العامة، فقد تخطته إلى أدلجة المجتمع من الأعلى ضمن مشروع خاص للتحديث سنة 1931 عُرف بـ”المبادئ الستة” أو “المبادئ الكمالية” تيمُنا بـ”كمال أتاتورك”، هي:”القومية التركية والعلمانية والجمهورية والدولنة واستمرار التحول الثوري والرؤية لمجتمع متجانس دون طبقية؛ فيما يعرف بالشعبية”[1]تمهيداً لبلوغ مستوى الحضارة الغربية كهدف أسمى.
إن مشروع دولنة المجتمع تأثر بطبيعة الهيكل المؤسساتي المنبثق عن الدولة الجديدة، شغلت فيه المؤسسة العسكرية حجر الزاوية للمجتمع ككل ونصبت نفسها حارسة للقيم العلمانية بل وجعلها المحرك المركزي في عمليات الإدماج والتنمية ومن تم التصرف في برامج التغيير والإصلاح.
تعدى دور الجيش، مجرد تحصين العلمانية إلى التدخل بشراسة لرسم المعادلات السياسية وتحويل اختيارات الشعب الحرة إلى ريع سياسي قابل للمصادرة والتعطيل في كل حين. ما يجب إدراكه خلال الحقبة الممتدة من عشرينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي أنه كان من الصعب الحد من شغفِ الجيش في الاستئثار بالدولة عبر الإمساك بالسلطة بسبب الخلفية العسكرية لنشوء الدولة كما أثبتت ذلك الوقائع المتلاحقة، أمرٌ كوَن لدى بعض التيارات السياسية قناعة بصعوبة إنجاح عملية التغيير بسبب وطأة مؤسسة الجيش التي تتجاوز في تنظيمها وقدرتها على الحركة والقوة الدولة ذاتها، ما أضحى الاتكاء عليه بوصفه محتكراً لـ”شرعية الأمر الواقع” ورقة رابحة من لدن قوى سياسية لاحتلال مواقع الأغلبية والردّة على ما تفرزه صناديق الاقتراع بل طرح نفسها المحاور السياسي المقبول مثلما كان الأمر مع حزب “الشعب الجمهوري” الذي لعب دور الناقل لإيديولوجية الدولة والحامل لـ”الأسهم الستة” لاسيما في الفترة الممتدة من 1923 إلى غاية 1950 عاشت فيه البلاد حكم الحزب الواحد، ومن أمثلة ذلك ما تختزنه ذاكرة التاريخ عند الإطاحة بـ “عثمان مندريس” سنة 1960 أول رئيس للوزراء منتخب ديمقراطيا ثم إعدامه فيما بعد، ويظل انقلاب “كنعان إيفرين”[2] في 12 سبتمبر/أيلول 1980 الأشهر بسبب دمويته ولما أعقبه من قمع سياسي غير مسبوق، أو استخدام “القوة الناعمة” لإزاحة رئيس الوزراء وزعيم حزب “الرفاه” “نجم الدين أربكان” في 28 فبراير سنة 1997 ذو الخلفية الإسلامية الذي خرج من رحمه “رجب طيب أردوغان وعبد الله غول”.
أثمر الاتجاه العلماني الجامد، تشكيل موقف رسمي ناذر حيال ثقافة المجتمع وجعل كيان الدولة كمشّدٍ صلب يلفظُ أي طيف سياسي لا يتماهي مع المبادئ السائدة، ذلك أن الرؤية التركية للعلمانية راعت حقوق الدولة لا حقوق المجتمع ولم تتضمن حياد الدولة عن الدين، بل سمحت للدولة بأن تتحكم بالدين مقابل تصوير العلمانية كدين رسمي بديل[3].
ما لبثت الممارسة إذن، أن غربلت خليط ومزيج الأماني من الواقع باتضاح أن العلاقة بين الإطارات القانونية والدستورية وبين الدولة القومية ليست من جنس الروابط السببية الكلية ولا الهندسات المستوردة. جراء ذلك تلبست الدولة العلمانية في تركيا أزمة تشكلت من ملمحين أساسين؛ الملمح الأول اقتصادي اتسم بعدم القدرة على الإنجاز حيث بدأت تهتز الثقة في المشروع التحديثي بعد مضي عقود من الممارسة والتصرف الوطني، وظهر للعيان أنه مشروع محدود المردودية في ظل تجريب العديد من السياسيات الداخلية القائمة على اختيارات اقتصادية متعثرة لم يقطف ثمارها المجتمع وسياسات خارجية مرتهنة لوعود الإتحاد الأوروبي أظهرت عدم كفاءة الدولة في سلوك استراتيجيات مستقلة: عدم توازن الحوار مع أوروبا بغية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. الملمح الثاني سياسي طال مسألة شرعية الحكومات المتعاقبة ومشروعية سياساتها بحكم فرض العسكر منطق الانقضاض على السلطة دون تفويض شعبي لعدم القدرة على احتمال التباين الايديولوجي مع أي فصيل سياسي أشرّت سياسياته على الخروج عن المشروع الكمالي عبر إحلال تشكيلات الدولة العميقة وتفويت السلطة إليها باعتبارها حلقة الوصل بين الدولة والمجتمع[4].
اكتنفت أزمة الدولة بعداً آخر، ارتسم في عدم قدرتها الإجابة عن سؤال التنوع الثقافي مرده الضرر الذي أحدثه تضخم النزعة القومية “الطورانية” على حساب الهويات اللغوية الأخرى وحتى إزاء الهوية الدينية الجامعة. ولّد ذلك نقض النظام أولا والكفر بالدولة ثانيا من قبل جماعات ترى نفسها خارج الدولة وغير معنية بالانتماء الوطني، ومثال ذلك “حزب العمال الكردستاني” بزعامة “عبد الله أوجلان” على الرغم مما تحبل به القضية من ترسبات اتفاقية “سايكس بيكو” سنة 1917 استبقت ميلاد الدولة التركية.
فرضت تركيا مشروعها للتحديث دون توافر إسنادات ثقافية، لتقدم في النهاية واجهة حداثية بعلمانية سلطوية ذات شرعية تفتقر للرضا الشعبي بسبب تغييبها الشرط الديني للمجتمع المتحرك في بحر من القيم والمعتقدات الراسخة بأزمنة سابقة. إذ تعاطت النخبة السياسية مع علاقة الدين الإسلامي بالمجتمع كعملية جراحية لاستئصاله وتعويضه بالقيم “الأتاتوركية” كمُثلٍ عليا لاحقت أي تواجد للتدين في مختلف المناحي العامة والخاصة، كل تلك العوامل مجتمعة أسست لرفض مجتمعي للنظام السياسي والنخبة السياسية المنبثقة عنه[5] التي وُصفت بكونها “دولانية“[6].
الفرع الثاني: تحولات المشهد الداخلي في تركيا
رغم تموجات التجربة التركية طوال عقود من حكم ظهير سياسي واحد وتربص الجيش المستمر بالسلطة، إلا أنها راكمت إرثا ثمينا أسهم في بلورة الوعي الوطني والاستعداد الفكري للبدء بمراجعات طالت كل مفاهيم الدولة التركية والممارسة السياسية، تجسدت اللحظة الفارقة غداة وصول “حزب العدالة والتنمية” إلى سّدة الحكم في 3 نونبر سنة 2002 كمؤشر على تحولات فكرية وتعليمية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية جذرية، بعدما تسلح الطيف السياسي ذي الخلفية الدينية بخلاصات الماضي في تعاطيه برؤية أكثر واقعية مع السلطة والحكم وتبيانه لجهد نظري في متن خطاباته لتجسير الهوة بين الديمقراطية والمواطنة وتأصيلها في الفكر الإسلامي، مُؤلفاً في نهجه بين إصلاحات “مندريس” الديمقراطية وتوجهات “طورغوت أوزال” الاقتصادية ورؤية “نجم الدين أربكان” بخصوص عودة تركيا لعمقها الإسلامي، لتتعاظم بعده في العالم العربي الدعوات لتطبيق النموذج التركي في الحكم؛ أي الجمع بين الديمقراطية واقتصاديات السوق من جهة وبين الإسلام من جهة أخرى[7].
تجسد التحول، في التحجيم تدريجيا من تغول العسكر وتحييد نفوذهم السياسي بالتوازي مع تغير نظرة المجتمع إلى دورهم وإلى وسائل تنظيم السلطة والحكم مع ما واكبه من تطور في بنية الدولة وتلطيف عقيدتها المدنية ومفاضلتها عن عقيدة المجتمع النابض بمفردات الهوية الثقافية، في سياق إنضاج العلاقة بين الديني والسياسي وفق خط تصاعدي؛ من المجتمع إلى الدولة، وليس العكس. كل ذلك بوأ الجيش مكانة كبيرة كمعبر عن صوت الأتراك بعد فوزه في انتخابات 22 يوليوز 2007[8].
لم تمنع انجازات حكم حزب”العدالة والتنمية” من تأهب “الدولة العميقة” لتلغيم مسيرة حكم الحزب والزّج به لخوض معارك حديث العهد بها يعوزه في تدبيرها رؤية شمولية إلى أن أقدمت على خطوة تحريك أذرعها العسكرية في أكبر خروج عن العملية الديمقراطية منذ سنة 1997، وهي المحاولة الانقلابية التي جرت ليلة 15 يوليوز 2016 وتستحق وقفة تأملٍ.
الفرع الثالث: الشعب ينقذ الدولة
لا مندوحة عن محورية الدولة إذن، ذلك المغزى الرئيسي المتدفق ليلة الانقلاب الفاشل الذي أفصح عن ارتقاء الوعي الديمقراطي المعقلن )نخبة وشعبا( فيما يخص التشبع بفكرة الدولة والالتفاف حولها بكل ما تموج به من تمثلات وطنية في تناغم جماعي لا يعكر صفوه فرزٍ سياسي أو اصطفاف ايديولوجي أو بناءِ موقف إقصائي نابع من حالة تَشفي على منوال ما جرى غداة إزاحة الجيش المصري للرئيس المنتخب “محمد مرسي” سنة 2013.
في مستهل المحاولة الانقلابية من قبل التنظيم الموازي الموالي لـ “جماعة غولن”، قصف الجيش عقل المشاهد التركي ببيان تلفزي أغرقه مشدوهاً في حالة ذهول محاولا استيعاب الوقائع، إلى أن انتشلته المكالمة الصوتية للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عبر تطبيق هاتفي، كانت مفصلية في تناسل إيقاع الأحداث باتجاه آخر؛ من حيث إبطالها مفعول بيان الجيش وإسهامها من ناحية في تعبئة مختلف التشكيلات المدنية ذودا عن الدولة وتصدياً لإهدار المكتسبات الديمقراطية.
تنطحت الأحزاب السياسية بالبيانات الرافضة المساس بشرعية السلطة القائمة والارتداد عن اختيارات الشعب الحرة، وإن تلك المعروفة بعدائها الشديد لحزب “العدالة والتنمية” و”لأردوغان” وعلى رأسها حزب “الحركة القومية”، فقد رشّدت من سلوكه السياسي حين نادت بحتمية العودة للحياة الديمقراطية، بعيدا عن عقيدة الثأر أو سعي لتشويه الوعي الوطني بغرض تفريق الشعب وجني ثمار اللحظة. حتى الأجنحة الإعلامية الموالية للمعارضة التزمت الأمانة في نقل رسالة رئيس الدولة “رجب طيب أردوغان” إلى الشعب دون تحوير مضمونها أو توظيفها لنفث السموم الايديولوجية والسياسية أو تأجيج الملاسنات الطائفية بخلاف “قنوات عربية” نجح فيها الانقلاب منذ أطواره الأولى كاشفة عن عدم مهنيتها ورداءة محتواها الإعلامي.
إن التضاد السياسي لحزب “العدالة والتنمية” مع المعارضة، لم يحُل دون نيله التقدير الاجتماعي لما حققه من عوائد اقتصادية انعكست إيجابا بتنامي الدور الاعتباري لتركيا في الفضاء الإقليمي والدولي، وبالتالي انحصر الصراع في المربع السياسي وتركز حول إبراز وإعمال قيم ومبادئ الديمقراطية النابع من الإيمان بعدالة النظام الانتخابي وإطاراته الدستورية وتحييد الدولة عن الصراع، وحمايتها من مخالب الجيش وغاراته المتعطشة للسلطة.
فضلا عن أن إدراك التشكيلات الحزبية لأكلاف التسليم بوثبة الجيش على السلطة، بعث من جديد هواجس إعادة مأسسة الاستبداد؛ بادئ ذي بدء بإعلان الأحكام العرفية وحل البرلمان وتزيين الفضاء السياسي بواجهات شكلية من التعددية السياسية المفرغة من مضمونها التنافسي، وتطويق الحريات العامة عبر تأبيد حالة الطوارئ.
فبجوار الهبّة الجماهيرية، المندفعة والصانعة للحدث المزلزل الرافض لمصادرة إرادة الشعب، اختزنت مشاهد الاحتجاج تحولاً في المزاج الشعبي والسياسي المناوئ لفكرة التطاول على الدولة وعدم استساغته لمسألة اغتصاب السلطة ونقلها لتشكيل سياسي آخر، مما كان له وقع ايجابي في انبثاق مسؤولية جماعية تروم صيانة المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ومكسب التعددية السياسية والثبات على إنفاذ إرادة الشعب، رفعاً لاستعادة الجيش ميكانزمات الاستفراد بالسلطة.
كما عكس الخروج الجماهيري من زاوية أخرى، استعادة المجتمع شرطه الديني والقومي وفق ما تقتضيه الحاجة الموضوعية لتصور الدولة وفي تحديد أكثر مرونة لمفهوم الانتماء والهوية من أبسط الأشكال إلى أنصعها وأكثرها تجلياً؛ من العائلة إلى القومية إلى الوطن وفق تراتبية لا تُلغى فيها الهوية الفرعية بقدر ما تتوارى لصالح الانصهار في البوتقة الوطنية بتطابق بين الأمة والدولة الحاضنة لأفراد لديهم اتجاه مشترك، وإحساس متماثل بالانتساب إلى الوطن الجامع ضمن هوية سياسية مكتسبة ومتحركة تحفظ للأنساق القومية والدينية مكانتها في مجتمع يشكل فيه المسلمون نسبة 97 في المائة[9].
أُسند هذا التطور الايجابي، بالعلاقة التفاعلية والتكاملية بين الأطياف المجتمعية، والإدراك المشترك لمكامنها كقوى اجتماعية ناضجة مُهيئة للتآلف مع التنوع السياسي والثقافي، تتخطى خلفياتها المتباينة إلى إطار مرجعي واحد يعزز الشعور بالمدنية تزامناً مع الانضواء ضمن الولاء الوطني المشدود بثقة الفرد في الدولة وفق نُهج سليمة ومفردات واضحة على غرار ما ضخته الدولة الوطنية في أوروبا غداة اتفاقية “ويستفاليا” سنة 1648من أفكار: عدم تعسف الدولة، المساواة والعدالة الاجتماعية ومحوريتها في إدارة الصراعات وإبرام التسويات السياسية، وصولا إلى أفكار “عصر الأنوار” حول فصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية تؤطرها علاقة تكافلية تلخص حاجة العلمانية للدين كمصدر مقبول للتوجيه الأخلاقي للمجتمع السياسي بخلاف ما أفصحت عنه الصيغة “الأتاتوركية”[10].
أشّر الفعل الانقلابي غير المكتمل على متانة دعامات الدولة بتوافر تراث ديمقراطي طوّر لدى المواطن الاستعداد الواعي والإرادي للانتفاض، حين مداهمة الآلة العسكرية لمؤسسات الدولة السيادية ومعبدها الديمقراطي “البرلمان”، جاعلا للديمقراطية أنياباً تنافح بها عن قداسة العقد الاجتماعي الحائز لرضائية الشعب وتفويضه الحصري، ضمن فهمٍ حقيقي لاستمرارية الدولة ووجودها مصدراً لإنتاج السلطة وإطاراً للعيش المشترك وكمجال محايد تنتظم في ثناياها الممارسة الديمقراطية، بالركون إلى الأغلبية والأقلية كطبقة حاكمة متماسكة وملتزمة بحماية المصالح الجماعية[11].
يظل الفيصل في التشبع بفكرة الدولة لدى الشعب التركي، هو تلمس الخيط الرفيع بين مفهوم الدولة وبين نظام الحكم كجسم نخبوي محكوم خاضع لدورات الاقتراع الشعبي والتداول السلمي على المواقع السياسية تبعا للأوزان التمثيلية والبرامج الانتخابية، وهو نظام قابل بطبيعته للنقد والمساءلة في حين أن الدولة تشكل إطاراً سياسيا ملزماً ومرجعية للوجود السياسي، ومن غير أن تفضي سياسات هذا الأخير وإن كانت خاطئة إلى استعداء الدولة والكفر بها أو إحداث قطيعة مع المجتمع.
بنجاح الدولة في أخد مسافة واضحة من الجميع، قدمت نفسها كياناً عابراً لكل الاختلافات السياسية والطائفية والهويات الفرعية كوحدات تكوينية أولية، أُعيد تركيبها وإخصابها ضمن مفهوم الهوية الوطنية بمعنى النظام الدولتي الشامل، دون حصول تمزقٍ أو تشققٍ في وحدة الهوية الذاتية المتمايزة والمتواصلة في آن واحد مع الكتلة الوطنية في سياق ما أبانت عنه محاولة الانقلاب من تواري التناقضات المدنية وإحلال شعور وحدوي عام متشبع بشحنة أخلاقية مضمونها حسٌ وطني وهمٌ جماعي جانَبَ الوقوع في فخ شخصنة الدولة أو وصلها بالزعيم المتحلي بكاريزما كبيرة [12].
خاتمة
شكل الوعي بأهمية الدولة والتمركز حولها، وقع ايجابي في استحالتها قلعة عصيّة على غزو العسكر وتفكيك شّيفرته المغلفة بأماني مثالية، مدركا تمام الإدراك أن السيرة التاريخية تحفظ أن زحف الجيش على الدولة في تركيا، كما في أقطار أخرى، لم يجلب يوماً حياة مدنية بقدر ما يتعامل معها كإرث حصري وغنيمة يُحفها بدبابته، حاملا معه الاحتراب الأهلي والتكلس السياسي وبقناعة خالصة أن طموح الدولة المدنية يرتدُ عند حائط العسكر الذي يستأثر بكل الحلول المستقبلية ويخاصم في عمقه التطلعات الوطنية.
تلك، هي الصورة التي صدّرتها تركيا إلى العالم أجمع، بأبجديات وطنية تستحق أن تتملى فيها أنظمة ارتدت عن مسار الانتقال السياسي وما زالت لا تتورع عن معاكسة أماني الشعوب وتدمير المجتمعات والتلاعب بمصير الدول، في إنتاج متواصل لشرعيات القهر المنهارة وترميمها.
– عبد الله أحمد النعيم، الإسلام وعلمانية الدولة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2011، ص: 75 و 76. [1]
[2]- صدر في “كنعان إيفرين” حكم بالسجن مدى الحياة عام 2014 مع قائد القوات الجوية الأسبق “تحسين شاهين كايا” لدورهما في انقلاب 1980 بتهمة “قلب النظام الدستوري”.
[3]– راينر هيرمان، تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية:الصراع الثقافي في تركيا، مرجع سابق، ص: 79.
– راينر هيرمان، تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية:الصراع الثقافي في تركيا، مرجع سابق، ص: 76.[4]
– راينر هيرمان، تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية:الصراع الثقافي في تركيا، مرجع سابق، ص: 112.[5]
– الإيمان بدولة شدية القوة والعنف.[6]
[7]– صالح النعامي، العقل الاستراتيجي الإسرائيلي: قراءة في الثورات العربية واستشراف مآلاتها، الدار العربية للعلوم ناشرون، مركز الجزيرة =
= للدراسات، بيروت، الطبعة الأولى 2013، ص: 92.
– راينر هيرمان، تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية:الصراع الثقافي في تركيا، مرجع سابق، ص: 112.[8]
– عبد الله أحمد النعيم، الإسلام وعلمانية الدولة، مرجع سابق، ص: 290.[9]
– عبد الله أحمد النعيم، الإسلام وعلمانية الدولة، مرجع سابق، ص: 267 و 448.[10]
[11]– دانيال برومبرغ (محرر)، التعددية وتحديات الاختلاف: المجتمعات المنقسمة: كيف تستقر؟، ترجمة عمر سعيد الأيوبي، دار الساقي، بيروت،
الطبعة الأولى 1997، ص: 35.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية