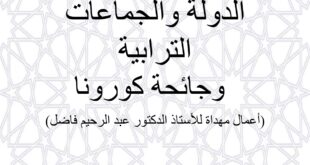الحركة الإسلامية مكون من مكونات المجتمع المدني بالمغرب
أشن خالد أستاذ باحث
حاصل على دكتوراه في القانون العام
بجامعة محمد الأول بوجدة
ما زال الحديث عن الحركة الإسلامية بأطيافها المختلفة وتجاربها المتعددة يعاني من التباس شديد وسوء فهم كبير، مرد هذه الحيرة إلى صعوبة الإمساك بتعقيدات ظاهرة توحي أراء روادها وبساطة محتواها. فالتعقيد هنا كامن في كون الحركة الإسلامية غدت مكونا رئيسيا يصعب اجتثاثه، كما ما فتئ يخطئ حسابات كبرى المقاربات. ولعله من أسباب عدم الفهم الذي تصنعه الحركة الإسلامية على شتى الأصعدة هو في عدم فاعليتها عند خصومها محمل الجد وعدم الاعتراف بإمكاناتها الفكرية والسياسية داخل أشكال التنميط والاختزال الذي تذكيه روح الصراع الأيديولوجي والمنافسة السياسية وعدم اعتبارها المدى الذي قطعته هذه الأخيرة كتجربة سواء في طريقة تفكيرها أو في طريقة تكيفها مع المحيط[1].
وعموما فأهمية الحركة الإسلامية التي تبرز من خلال انتشارها الواسع تكشف عن عمقها وترسيخها في المجتمع، وهذا ما يقتضي البحث عن أكثر من عامل يقف وراء بروزها.
وأول عامل يمكن أن نفسر به الظاهرة هو العامل التاريخي، ذلك أن الظاهرة الإسلامية هي أولا وقبل كل شيء ظاهرة دينية، وقد لعب الدين منذ البداية دورا أساسيا في تشكيل المجتمع المغربي الإسلامي[2]. وبالإضافة إلى هذا التفسير المستند إلى الوقائع التاريخية، يمكن العثور على تفسير آخر ذي بعد سياسي. فالنخب الإسلامية بشكل عام، قد أصبحت مهمشة في المجال السياسي، بعد أن كانت تمثل الشرعية الدينية التي بدونها يبقى الحاكم في نطر الشعب مجرد مغتصب للحكم[3].
إن ما يؤكد أن الأمر يتعلق بصراع سياسي من أجل السلطة هو كون الحركات الإسلامية تنص في قوانينها ومواثيقها الداخلية على أن الحكم في الدولة الإسلامية يجب أن يعود إلى أكثر المسلمين علما بدينهم، أي العلماء والفقهاء وكل الأشخاص الذين استثمروا في الثقافة الدينية، الشيء الذي يضفي الشرعية على مطالبهم السياسية، كما أن الطابع الشاب لقيادة الجماعات الإسلامية يظهر بشكل واضح بأن الإحباط السياسي الذي نتج عن تهميش الشباب المتخرج والراغب في لعب أدوار سياسية مهمة، يقف وراء ميلاد وظهور هذه الحركة الإسلامية.
بمكن أيضا أن نعثر على أسباب اجتماعية وراء ظهور الحركة الإسلامية، إذ ليس من قبيل الصدفة أن تنتشر هذه الحركة في أغلب الدول الحربية الإسلامية في وقت عرفت فيه اقتصاديات هذه الدول أزمات خانقة كان لها وقع كبير على مجتمعاتها، مما جعل الحركة الإسلامية تجد إقبالا كبيرا من طرف الفئات والجماعات المهمشة في المجتمع، كونها لم تكتف بالدفاع على مستوى الخطاب عن مطالب وحاجيات هؤلاء المهمشين، بل تجاوزت ذلك إلى خلق مجموعة من التنظيمات والجمعيات الخيرية التي تحمل على تقديم المساعدة والعون إلى المحتاجين، مستثمرة إلى أقصى حد مبدأ التضامن الإسلامي، ومساهمة في إعطاء الدليل على سلوكها السياسي والاجتماعي في حالة وصولها إلى السلطة، بل إن بعض الجمعيات الإسلامية قد تفوقت على أجهزه الدولة رغم ما تتوفر عليه هذه الأخيرة من إمكانات ووسائل.
وإذا كانت التفسيرات الاجتماعية والسياسية قد لاقت حظها من الباحثين المهتمين بدراسة الحركة الإسلامية، فان التفسير النفسي ظل غائبا باعتبار أن الأمر يتعلق بظاهرة جماعية لا يمكن تفتيتها إلى عناصرها الأولية، إلا أن الأبحاث الأخيرة المتعلقة بدراسة الأيديولوحيا استطاعت أن تظهر نجاعة التفسير السيكولوجي.
أمام تفسيرات كل هذه العوامل يظل الإسلام السياسي ليس بالضرورة فاعلا سياسيا بالمعنى التقليدي، ولكنه حركة ثقافية سياسية لها تجلياتها ومظاهرها وتوقعاتها برزت في العقود الأخيرة من القرن العشرين، وهو البروز الذي تزامن مع صعوبة قراءتها كظاهرة أو رسم آفاقها. بمقاييس الديمقراطية أو حقوق الإنسان، حيث كانت معايير بناء المجتمع الإسلامي تستلهم من مرجعيات تقليدية ككتابات ابن تيمية والغزالي من التقليديين وسيد قطب والمودودي من المحدثين. وكان من الطبيعي في ظل المقتربات التي تفرضها هذه الرجعيات أن تعتبر الديمقراطية كفرا أو في أحسن الحالات أقرب أنظمة الحكم إلى المرجعية الإسلامية فضمن المناخ الذي كان سائدا، كان الإسلاميون يتوقون إلى بناء مجتمع تنظمه قيم دينية صرفة على شاكلة التصور الذي يحملونه عن المجتمع الإسلامي الأول وهو تصور لا يأخذ بعين الاعتبار حق غير المسلم في المشاركة السياسية ولو كان شريكا في المواطنة، ويضع على رأس أولوياته تأسيس دولة الخلافة الجامعة المانعة التي لا تقيم وزنا للاختلاف والتعدد، والتي تقصر علاقة الحاكم بالمجتمع فيها على التشاور والنصيحة. أما فيما يخص المقاربة القانونية فقد كان هؤلاء يرفضون القانون الوضعي ويصفه بعضهم بأنه عودة إلى الجاهلية ويتبنون بدلا عن ذلك الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بصورة مطلقة، وهو ما يتعارض مع أبجديات حقوق الإنسان[4].
وقد لقيت هذه الدعوات رواجا واسعا بعد نجاح الثورة الإيرانية، وساد إحساس عارم بالانتشاء أوساط الإسلام السياسي تمت ترجمته في رفع سقف التوقعات، لاسيما بعد انهيار التيارات اليسارية التي أخلت الفضاء العمومي وتركت الساحة السياسية والفكرية فارغة بعد نهاية الحرب الباردة، ومهيأة لكي ينفرد الإسلاميون بمواجهة “الاستكبار العالمي”.
لقد أدى تراكم هذه المعطيات إلى تشكيل ما سمي بالموجة الإسلامية الكبرى وهي موجة غذاها تعاظم الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية وانعدام الثقافة الدنية أكثر من أي بديل إسلامي يمتلك إجابات فعلية لرسائل الخروج من الأزمة الاجتماعية.
كما أن الإسلام السياسي قدم نفسه من جهة أخرى باعتباره ردا على الآثار السلبية للعولمة بصور خاصة، التطبيق المستعجل والجزافي لاقتصاد السوق وما حمله من تفكيك لبنيات المجتمع التقليدية واختراق المرتكزات الهوية المحلية.
ورغم كل هذه المواقف، نجد أن الإسلام السياسي ما فتئ يقدم مجموعة من المراجعات، فقراءة سريعة للقوانين الأساسية لعدد من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية الممثلة للاتجاه المهيمن بين حركات الإسلام السياسي، وفي المنتديات الإسلامية تبين أن جملة من المفاهيم التقليدية المرجعية للحركة الإسلامية المعاصرة مثل إنشاء “خلافة إسلامية” أو شعار “القرآن دستورنا” أو بناء “المجتمع الإسلامي” أو ” تطبيق الشريعة” لم تعد من بين أولويات هذه الجماعات أو أنها أصبحت متجاوزة بسبب السكوت النظري عنها، وطول الانقطاع الزمني عن تجديد الاجتهاد فيها. لقد أدارت عدد من الحركات الإسلامية الظهر لهذه المناقشات التي تجعلها تبدو غريبة عن عصرها وانخرطت في نقاش جديد يستمد مقوماته الأساسية من صيغ التكيف مع قيم العصر مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحق في التعدد والاختلاف وسبل تبني مبدأ شمولية القاعدة القانونية بغض النظر عن منطلقاتها الوضعية أو الدينية على المستويات القطرية والإقليمية والدولية.
إن هذا التحول العميق داخل التيار الأعم للحركات الإسلامية ليس بالأمر المستغرب[5]. فالنتائج المشجعة التي ترتبت عن المشاركة السياسية لعدد من الحركات الإسلامية، سواء من حيث الانضباط لقواعد اللعبة الديمقراطية أو التجاوب مع فئة واسعة من القاعدة الشعبية يبين أن إدماجها النهائي في الحياة العامة هر جزء من الحل وليس من المشكلة، وأن عملية الإصلاح الديني يجب أن تتم بصورة متزامنة من داخل الجماعات الإسلامية ومن خارجها، ضمن الضمانات القانونية التي توفرها هذه المشاركة السياسية، بما يرفع عنها شبهة الإقصاء والانطلاق من أن من يريد أن يستثمر في السياسة يجب أن يؤمن بأنها فن الممكن وأنها لا تتحمل أية حقائق مطلقة، وأن المطلق الوحيد في السياسة هو تغير الاحتياجات والظرفيات والإرادات[6].
إن منطلق هذه التصورات يجد مرجعيته في أن الكثير من الإسلاميين سيطر عليهم وهم أنهم ما أن يتحكموا في دواليب السلطة السياسية حتى يحققوا مشروعهم السياسي وهو أسلمة المجتمع، وهو وهم لأن التجربة أكدت أن كل محاولة أسلمة تأتي عن طريق القوة وبشكل فوقي من الأعلى تأتي بنتيجة عكسية، أي حرص الرأي العام بأن يتخلص من عبء الأسلمة وكمثال على ذلك إيران وقبلها تونس.
لذا فلكي يسهل الإسلاميون عملية إدماجهم في الحياة السياسية، عليهم أن يراجعوا استراتيجياتهم، وأن يثبتوا قدرتم على التعايش مع خصومهم في نفس الإطار، وهذا لا يكون طبعا إلا من خلال الحوار والحمل المشترك وتنزيل الخطاب من العام الأيديولوجي المفارق للواقع إلى برامج اجتماعية وثقافية وسياسية ملموسة وقادرة على الإجابة عن التحديات المطروحة.
ومن تم فانه إذا راجع الإسلاميون أسلوبهم في العمل واختاروا الاعتدال الحقيقي سيساهمون في تغيير الصورة وفي تقديم أنفسهم كطرف مقبول.
إن الإدماج السياسي واحترام قواعد الديمقراطية يضع الإسلاميون في حجمهم الحقيقي ويبرزهم كطرف إلى جانب أطراف أخرى.
وقد تأكدت هذه الفرضية مع هبوب رياح التغيير بالشعوب العربية، إذ استطاعت الحركة الإسلامية من فرض وجودها بكل من المغرب ومصر[7] وتونس. إذ تأكد لها مدى قدرتها على الاندماج السلس وبالتالي جعل اللعبة السياسية لديها لعبة مقبولة على شتى الأصعدة ومن مختلف المنطلقات.
ثانيا: قدرة الحركات الإسلامية على التأثير مع باقي مؤسسات المجتمع المدني:
إن الجمعيات الدينية المجسدة لمؤسسات الحركة الإسلامية تظل تتأرجح حسب وصف عز الدين لعياشي[8] بين جمعيات تقليدية ومحافظة وأخرى إصلاحية ومعاصرة[9] ورغم هذا التوصيف يظل عنصر الجمع الخصوصي ميزة كل مؤسسة من مؤسسات الحركة الإسلامية، حيث أنه في دولة حيث المجتمع المدني يبرز أكثر ديناميكية وحيث المبادرات لصالح التقدم الاجتماعي تتعدد، فإن الحركة الإسلامية تظهر كتحدي جديد من طرف النظام، ليس كمحدد لتيار منظم، بل كحساسية مشتركة بين الحركات والتي تطالب بخصوصية مميزة بالمقارنة مع كل المسلمين[10].
هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يختلف تعامل الحركات الإسلامية مع مؤسسات المجتمع المدني عن باقي استعمالات الأحزاب السياسية، اللهم من جهة طريقة العمل وخصوصية الفكر الذي تحمله، وهو ما كشف عنه الدخول السياسي للفاعل الإسلامي والذي جعل أدواره تتجاوز ما هو ثقافي جمعوي. إن ذلك يتطلب حسب عبد الله ساعف الموقف من المشاركة، والجديد في هذا الصدد هو البرنامج، فهو مثل البرامج الأخرى بنفس آخر ومرجعية أخرى ومعطيات فكرية مختلفة، ولكن هناك إرادة للفعل في قلب الفعل السياسي، وهذا هو الجديد في المسألة حيث يمكن لذلك أن يدفع في اتجاه إدخال الأخلاق في السياسة[11]. رغم أن هناك عدم اعتراف بنضج الفاعل الإسلامي ورشده[12] في المجال السياسي.
وقد استفادت الحركات الإسلامية في بداية عملها من الإطار القانوني المرن لتأسيس الجمعيات والمنظمات، وهي من ثم اختارت كلها تقريبا هذا المدخل للعمل وبداية التشكل، ثم راحت بعد ذلك تعلن عن نفسها في أحزاب “حزب العدالة والتنمية” أو حركات سياسية “العدل والإحسان” دون أن تفقد ارتباطها بالعديد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية والخيرية، والتي شكلت رافدا مهما لتوسيع قاعدتها الاجتماعية من خلال ما تقدمه من خدمات مادية ومعنوية.
إن ما يجعلنا نعتبر طبيعة اشتغال الحركات الإسلامية في المجتمع المدني لا تختلف كثيرا عن تعامل الأحزاب هو ذلك التوظيف السياسي غير المباشر الذي تلجأ إليه الحركات الإسلامية في علاقتها مع الجمعيات والروابط والمنظمات التي أسستها في البداية والتي تلجأ في مواقيت الانتخابات والتظاهرات السياسية ” تظاهرة البيضاء ضد الخطة الوطنية لإدماج المرأة ” مثلا أو في التحريض ضد اختيارات الحكومة وتوجهاتها.
فالحركات الإسلامية لم تعمد إلى حفظ الدور التطوعي والخدماتي والثقافي لهذه المؤسسات التي أنشأتها في البداية، بل وهي ومنذ الوهلة الأولى اعتبرتها قنوات فقط للتعبئة والدعاية واستماله المتعاطفين والعمل السياسي غير المباشر، بحكم منع السلطة في غالب الأحيان لهذه الحركات من العمل السياسي المباشر ومن تشكيل الأحزاب السياسية. وهذا ما يفسر خلو أدبيات هذه الحركات الإسلامية من أي انشغال نطري أو علمي بمفهوم المجتمع المدني وقضاياه، لأنها منذ البداية تعاملت بشكل “براغماتي” مع هذه المؤسسات باعتبارها أنوية وأوعية تابعة للفعل السياسي، الاجتماعي للحركة وليست مؤسسات مستقلة لها دورها وجدول أعمالها المختلف بهذا القدر أو ذاك عن الحزب السياسي، هذا الأخير الذي يسعى إلى السلطة عبر الصراع السياسي المباشر، في حين أن الأولى لا ترمي إلى الوصول إلى السلطة بل تطمح فقط أن تلعب دور الوسيط والمدافع عن المجتمع اتجاه السلطة[13].
وبالنسبة للمغرب فمن الواضح أن النخب السياسية والثقافية والدينية في المغرب، مستمرة في الاستهتار بمنظومة المجتمع المدني كنتيجة منتظرة من عدم إكتراثها بتبعات الخيار الديمقراطي فالسياسي قائم على انطولوجيا نزعته البطريكية، والثقافي منغمس في نزعته الأيديولوجية أما الإسلامي الأورتدوكسي فإنه مستمر في احتكار “حقيقة الإسلام” واحتقار كل ما يخالف الإسلام. ولعل ما يجمع ما بين هؤلاء هو إحتكار الحقيقة المفروض أن يقوم عليها مجتمع ما بسبب المنطق الكيلاني Totalitaire المستحوذ على عقلية وذهنية هؤلاء. وبسبب التهديد العضوي الذي يفرضه قيام مجتمع مدني حقيقي هو نقيض للمجتمع الشمولي (سياسويا) والأيديولوجي (ثقافويا) والاكليروسي (إسلامويا متشددا). فلا ديمقراطية بدون مجتمع مدني حقيقي وفعال، ولا مجتمع مدني دون استقلال عن الأيديولوجيا البطريكية Patriarcal. أما الخطاب السلفي فقد أصبح مطلوبا منه عدم اختزال الواقع المعاش في صيغة أزمة أخلاق وقيم ومبادئ، غافلا عن تداعيات جمة تواجهها المجتمعات الإنسانية وليس العالم الإسلامي فحسب (مشكل الفقر، الغذاء، توزيع الثروة، البيئة، سباق التسلح، حقوق الإنسان وحقوق المواطنة..) صحيح أن مجتمعاتنا تختلف في سيرورتها عن تلك المجتمعات التي نشأ في أحضانها مفهوم المجتمع المدني لكن السيرورة التاريخية للمجتمعات البشرية تحتم علينا المرور على عملية التحديث الذي يمس شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدها، هو التحديث الذي يمر عبر التجديد الديني الغائب والتحديث السياسي لفكر النخب المغربية[14].
وهنا نجد صعود بعض الحركات الإسلامية كحركات اجتماعية، حاولت استثمار مخزونها العقائدي والسياسي في تنشيط و احتواء الفئات المهمشة وذلك بواسطة المساجد أو مؤسسات ذات صبغة تضامنية أو تعاونية[15]، إنها أكثر ظاهرة من ظواهر إحياء المجتمع المدني التي عرفتها المجتمعات العربية في نصف القرن الأخير من القرن العشرين[16]، مما يوحي بالرغبة التواقة لديها لتجاوز ظواهر تحجيمها وطي صفحة الإستكانة التي ما فتئت ترتبط وبآليات اشتغالها.
ثالثا: الجمعيات الحقوقية.
إن الحديث بداية عن دور المنظمات والمؤسسات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان في العالم العربي تفرض نفسها على الباحث كونها تمثل جزءا مهما من مسيرة حقوق الإنسان والذود عنها. كما أنها مسألة من الأهمية بمكان في مسارات تطور المنظومة الحقوقية العالمية، والتي من غير الممكن تجاهل القطيعة الكبرى التي أحدثها العقل الأنواري الحديث مع الفكر الديني على مستوى هذه المنظومة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان، إذ مع هذا العقل، لم يعد إقرار حق الإنسان والاعتراف به مجرد طقس ديني أخلاقي فحسب، على نحو ما كان عليه أمره في الثقافة الدينية، بل أصبح جزءا من التعبير من العقيدة السياسية للدولة والمجتمع، بمعنى آخر لم يعد الاعتراف بحقوق الإنسان مجرد طقس ديني يمارس ابتغاء مرضاة الله وطاعة لأمره، بل صار يمارس بوصفه عنوان الانتماء إلى المدينة السياسية الحديثة[17].
ومن منطلق هذا التصور المدني/ المدني لحقوق الإنسان انبثقت فكرة تأسيس الجمعيات الحقوقية بالمغرب كنوافذ لإشاعة ثقافة تقوم على احترام ومراعاة الحقوق والحريات الأساسية[18] وليتبلور النشاط الجمعوي في مجال حقوق الإنسان كأحد المكونات الأساسية للمجتمع المدني بالمغرب[19] عبر إنشاء أول منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في دجنبر 1933 والتي شكلت فرعا من العصبة الإنسانية المنضوية هي نفسها تحت لواء الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. هذا الفرع الذي كان وجوده عابرا تم تكوينه من طرف وطنيين سيلعب البعض منهم دورا هاما في الحركة الوطنية[20].
وبعد الاستقلال تكونت العديد من الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان كانت تتغذى في معظمها من الأحزاب السياسية التي تقف موقف المعارضة مثل: الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، اللجنة الوطنية لمقاومة القمع وحركة أسر المعتقلين السياسيين.
وبعد ذلك ظلت حركة حقوق الإنسان في المغرب لزمن طويل مرتبطة بشكل حميمي بالأحزاب السياسية، وبعبارة أخرى فإن النضال من أجل السلطة كانت له الأولوية فيما بقيت مسألة الحريات داخله مسألة تابعة له[21].
هكذا انصبت اهتمامات الطلائع الأولى لمكونات المجتمع المدني على مواضيع محددة، اجتهدت في عزلها عن الصخب الذي كانت غارقة في وسطه منذ الاستقلال، ويأتي على رأس هذه المواضيع، معضلة حقوق الإنسان، التي أولتها منذ البداية أهمية قصوى، وذلك لاعتبارات عديدة من أهمها:
- أن قوى اليسار كانت نفسها ضحية غياب الحريات واتباع السلطات لأسلوب القمع والتنكيل الممنهج.
- اعتبارها استحالة تحقيق تطورات ديمقراطية دون توفر ضمانات دستورية وقانونية وأخلاقية لحماية حقوق الأفراد والجماعات.
- تفعيل الخطابات السياسية التي كانت تعبر عن حسن نية واستعداد لتخليق الحقل السياسي وفسح المجال أمام قوى حية جديدة[22]. وعلى ضوء هذه الاعتبارات انبثقت جمعيات وتنظيمات تابعة للمجتمع المدني أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان، والمساهمة وباستمرار في التتبع اليقظ لاحترام حقوق الإنسان، وفي الدفاع عن حمايتها وفي بث ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ارتباط بالتقدم الديمقراطي للبلاد[23]. إن هذه المنظمات تعتبر زمنيا حديثة الإنشاء إذ لم تتبلور بشكل مؤطر إلا مع بداية السبعينات من القرن العشرين، وأنشأها في الغالب رجال ونساء درسوا وعاشوا في الخارج سنوات عديدة، وتشبعوا بأفكار تحررية وحداثية وأرادوا تطبيقها في بلدانهم بعد عودتهم، خاصة وأنهم اصطدموا بواقع متخلف متحجر وبأنظمة تمارس ديمقراطيتها الخاصة بوسائلها الخاصة. ورغم أن هذه التنظيمات أنشئت للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام أو حقوق فئات معينة، إلا أنها خلطت بين عملها الأساسي والعمل السياسي، فدخلت في صراعات حادة مع الأنظمة الحاكمة وكأنها تحولت إلى أحزاب سياسية. وهي نفس الملاحظة التي يمكن رصدها على مستوى الجمعيات الحقوقية المنبثقة بالمغرب خاصة أنها ظلت مرتبطة بالنشأة والتطور بهذه الأحزاب السياسية. هكذا كانت المبادرة من طرف حزب الاستقلال في إطار استراتيجية القائمة على خلق تنظيمات تملأ كل الفضاءات السياسية والاجتماعية، في تأسيس أول جمعية حقوقية في 11 ماي 1972 هي (العصبة المغربية لحقوق الإنسان) والتي ركزت نشاطها على الاهتمام بمسائل ذات طابع سياسي، كالنضال ضد القمع والتركيز على ظروف المعتقلين ومساندة النظالات العمالية[24]، إلا أن ارتباط هذه الجمعية ارتباطا وثيقا بالحزب جعل منها وسيلة للتنديد بما قد يصيب الحزب وأعضائه من لهيب السلطة، أكثر منه أداة في خدمة المجتمع المدني[25].
وبتاريخ 24 يونيو 1979 عمل مناضلون من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين كانوا يرفضون أن يظل حزب الاستقلال منفردا بالدفاع عن ملف حقوق الإنسان[26]على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي قامت بنشر بلاغات حول قضايا المعتقلين السياسيين والخروقات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، غير أن تطورات الأمور داخل الحزب أدت إلى سيطرة الجناح الراديكالي للحزب على قيادتها مما أدى إلى ابتعاد الحزب شيئا فشيئا عنها ومقاطعة أنشطتها[27].
وفي 10 دجنبر 1988 ظهرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان[28]، والتي تأسست بعد حوالي ثمانية أشهر من المفاوضات المكثفة بين الأعضاء المؤسسين في البداية، وبين هؤلاء والسلطة فيما بعد. وقد تدخلت هذه الأخيرة عدة مرات من أجل تأجيل عقد الجمع العام التأسيسي، مما يبين أهمية هذا التنظيم والرهانات المرتبطة به[29]. إن تأسيس “المنظمة ” في النهاية يعني اتفاقا قد حصل بين السلطة وكل المكونات السياسية في البلاد حول ضرورة الاعتراف بميلاد المجتمع المدني[30]. وبالفعل وافقت أحزاب المعارضة على الدخول إلى المنظمة، وساهم أعضاء منها الإسراع في إنشائها، وبعد جملة من الانسحابات[31] تشكل المكتب في الأخير من أعضاء من الاتحاد الاشتراكي، ومنظمة العمل وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ومن مجموعة كبيرة من الشخصيات المستقلة على رأسها المهدي الذي أختير رئيسا شرفيا[32].
إن النص التأسيسي الموزع من طرف اللجنة التحضيرية للجمع الأول يؤكد على أن “مشكل حقوق الإنسان مرتبط بشدة بمشكل الديمقراطية ودولة القانون”[33]. وهذا يعني بأن السياسة ليست غائبة تماما من اهتمامات المنظمة، إلا أن مقاربتها تتم بطريقة مختلفة عن مقاربة الأحزاب السياسية باعتبار أن “المنظمة” التعبير النموذجي عن المجتمع المدني لا تتوخى الوصول أو الاستيلاء على السلطة، بل فقط تحسين ظروف المواطن وضمان حقوقه في دولة الحق والقانون. وهذا هو التصور الذي تبناه كل الأعضاء المؤسسين ودافعت عنه باستماتة مجموعة المستقلين وهؤلاء عبارة عن مجموعة من المثقفين يرفضون الانتماء إلى الأحزاب السياسية ويتمسكون بحق العمل داخل المجتمع المدني[34]. إلا أن انضمام أحزاب المعارضة لهذا التكتل الحقوقي جعل البعد الحزبي حاضرا على مستواه كذلك بقوة[35].
وعموما فقد حدت الصراعات الحزبية من فعالية هذه الجمعيات الحقوقية والتي حملت منذ نشأتها بذور عقمها، لأنها كانت توظف لأغراض حزبية ضيقة[36]. ومن ثم اتسم نشاط هذه الجمعيات بالمحدودية بالنظر إلى التأثيرات التي تتعرض لها من قبل الأحزاب الوصية عليها[37]. وقد انتبه الجيل الجديد من المناضلين إلى أنه من الأفيد، الابتعاد عن التنظيمات الحزبية والعمل داخل إطار جمعوي مستقل للأسباب التالية[38]:
- إذا كان الحزب يهدف إلى المشاركة السياسية على أساس برنامج عام يصبو إلى تحقيق التغيير في ميادين شتى، فإن العمل الجمعوي انتقائي، يشدد على غاية معينة. ويركز اجتهاداته من أجل دحقيقها، فالحزب يعمد إلى التأطير، أما الجمعية فتصبو إلى خدمة المصالح العامة عبر تنبيه السلطات إلى مكامن الخلل.
- تحقيق الاستقلالية عن الفاعلين السياسيين (السلطات والأحزاب..) وهذه الاستقلالية هي ما يضمن مصداقية مكونات المجتمع المدني ويدعم مطالبها، مما يجعلها قادرة وبكفاءة على تحقيق أغراض متعددة منها أغراض سياسية واقتصادية واجتماعية في إطار اعتراف حقيقي بمجهودات المجتمع المدني.[39]
- مرونة العمل داخل الإطار الجمعوي لأن قوانين اللعبة غير مضبوطة ولأن السلطات عادة ما تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ مواقف مناهضة للجمعيات، فالجمعية خاصة في المغرب تلعب دور حلقة الوصل بين المجتمع والسلطات لأنها تربط بين انتماءات سياسية وفكرية مختلفة تجمع بينها الأهمية التي توليها لقضية معينة. وبالتالي تبرز أهمية العمل الجمعوي من حيث إتساع مداه ليشمل الكل دون إقصاء بطبيعة الحال للجزء، وذلك عكس العمل الحزبي الذي يسعى لخدمة الجزء ولو على حساب الكل.
إن مشكل اختراق الحزبي وكذا السياسي للفعل المدني سيجعل بعض التجارب المدنية بالمغرب تعاني من معضلة الانقسام على خلفية ضعف الحس الاستقلالي لدى هيئاتها، ونشير هنا على سبيل المثال لمعاناة حركة حقوق الإنسان والتي استنزفت بعضها من طاقاتها حول التنازع بين ضرورة اندراج المطالب الحقوقية في أفق علماني أو ضرورة اندراجها في أفق يستلهم قيمه من المنظومة الإسلامية. وعاد هذا الانقسام للظهور ثانية عند الإعداد للميثاق الوطني سنة 1990 بين الهيئات الحقوقية[40]، فواقع الاختراق لايمكن أن ينجم عنه إلا واقع التشرذم.
كما أن تسجيل الحركة الجمعوية لحقوق الإنسان في الحقل السياسي عموما غذ من التوتر الذي كان معروفا في النظام السياسي المغربي، لكن أيضا انتقل إلى ميدان حقوق الإنسان ووضع في أجندته رهان التغيير السياسي[41]. فحتى بداية الثمانينات من القرن العشرين كانت مأمورية إصلاح المجال العمومي حكرا على مؤسسات الدولة أو التنظيمات التي تحظى بتزكية الدولة، وخلال النصف الثاني من هذا العقد، عبرت عدة فعاليات فكرية وسياسية مستقلة على رغبتها من جهة للاهتمام بمشاكل ومعضلات اجتماعية وفق معايير جديدة بعيدة عن المحفزات التقليدية (الأعمال الخيرية والجمعيات الرياضية) ومن جهة أخرى في امتطاء أشكال جديدة للتعامل مع السلطة ومؤسسات الدولة، وعليه تم تأسيس مجموعة من الجمعيات ذات النفع العام، شددت في مواثيقها وتصريحاتها المسؤولين عنها أنها تشتغل ضمن إطار المجتمع المدني[42]، ومنها الجمعيات الحقوقية.
ومما لا شك فيه، فإن ديناميكية قوى المجتمع المدني، وتغطيتها في وقت قصير لمجموع الفضاءات السياسية والاجتماعية، جعلها تلعب دورا فعالا في الدفع إلى الأمام بمسلسل بناء دولة القانون، ويظهر حجم وعمق تسرب هذه القوى، في كونها فتحت مجالات جديدة للمطالبة، وجعلتها تأخذ حيزا كبيرا ضمن لائحة المواضيع التي تستلزم حلولا سريعة[43]، ومنها المساءلة الحقوقية التي فرضت وجودها إبان تلك الفترة. وقد أدى عمل هذه القوى بصفة غير مباشرة إلى تهميش وتقليص وزن أساليب العمل التقليدية واحتلال القوى العصرية لمواقع الريادة، والحقيقة فقد كان لهذا الاختراق تأثير مزدوج الأول هم الدفع إلى الأمام بعملية عصرنة الدولة نفسها والثاني خص تحديث الخطاب السياسي[44].
وكخلاصة، فإن ممارسة حقوق الإنسان في ظل دولة ديمقراطية أي دولة الحق والقانون، متوقف على توافر عدة شروط جوهرية تتمثل في وجود تشريع يحدد الحقوق ويقنن الاختصاصات وينظم المؤسسات، كما أن إشكالية حقوق الإنسان ينبغي ألا تختزل في الحقوق السياسية، بل تتعداها إلى توفير الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات بتحديث الترسانة القانونية في مجال حقوق الإنسان وتدل آليات حمايتها، فضلا عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية (كالأسرة، المدرسة..) وذلك لأن المعركة من أجل حقوق الإنسان هي أيضا معركة من أجل الانتقال نحو الديمقراطية[45]، كما أن الطريق الوحيد لتحقيق التنمية وببلدنا، ولتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحسين صورة البلاد داخليا وخارجيا، هو العمل على ضمان حقوق الإنسان وإقرار نظام ديموقراطي[46]. مما يفيد بمدى أهمية المكون الجمعوي الحقوقي بلادنا في رسم معالم حكامة حقوقية جادة وحيدة قادرة على ترسيخ الفكرة القائلة بالاستثناء المغربي المحكوم دوما بثنائية النفي والتأكيد، فعند تكريس هذه الحكامة يتقين الاستثناء وعند التغاضي عنها تصبح مسألة الاستثناء مسألة تحتاج إلى إعادة نظر وتوضع موضع تساؤل إشكالي.
[1] – إدريس هاني، “ما الذي تغير؟ في نقد نقد الأداء الهوياتي للحركة الإسلامية المغربية”. حالة المغرب 2009/2010، مرجع سابق، ص 57.
[2] – حسن قرنفل، مرجع سابق، ص 127.
[3] – محمد عابد الجابري “المغرب المعاصر” مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر، الدار البيضاء 1988، ص 48.
[4] – المختار بنعبلاوي ” الإسلاميون ودفتر التحملات الديمقراطية في العالم العربي”، مجلة رهانات عدد مزدوج 11/12 صيف وخريف 2000، ص 2.
[5] – نفس المرجع، ص 4.
[6] – نفس المرجع، ص 5.
[7] – رغم أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها مصر جعلت الحركة الإسلامية في هذه الأخيرة، تعرف تشرذما حقيقيا.
[8] – للمزيد من التفاصيل بنظر الدراسة التالية لعز الدين لعياشي
« state society and democracy in morocco, the limites of associative life ». washington DC. Center for contemporary arabe studies georgetown university 1998.
[9] – Marie Angeles Roque « clés politiques dans la société civil ». op cit, P 67.
[10] – محمد الأمين، الركالة “البديل الحضاري” ورقة تعريفية، مجلة نوافد، مرجع سابق، ص 97.
[11]– عبد الله ساعف، “ضعف الثقافة الديمقراطية في المجتمع والدولة” الاية، 04/02/1997، ضمن أحاديث في السياسة المغربية منشورات الزمن، 2002.33، ص 146.
[12]– عبد الله ساعف، “أزمة اليمين ومشكلة اليسار” جريدة المستقلة، نوفمبر 1997.
[13] – توفيق بوعشرين، مرجع سابق، ص 4.
[14] – منتصر حمادة، مرجع سابق، ص 13.
[15] – أحمد بنيس ” المجتمع المدني العربي والتباسات التأصيل”، مرجع سابق، ص 16.
[16] – Mohamed Tozi « champ politique et champ religieux au Maroc : croisement ou hiérarchisation ». D.ES Université Hassan II. Casablanca 1980. P.108.
[17]– عبد الإله بلقزيز ” في الديمقراطية والمجتمع المدني”، مرجع سابق، ص 68.
[18]– عبد العزيز لعروسي “ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط، الموسم الجامعي 2001/2002، ص 374.
[19]– سيدي عالي العلوي، مرجع سابق، ص 71.
[20]– عبد الله حمودي (وعي المجتمع بذاته)، مرجع سابق، ص 179.
[21]– محمد شرايمي، مرجع سابق، ص 114.
[22]– حميد العموري، مرجع سابق، ص 7.
[23]– المغرب الممكن، مرجع سابق، ص 73.
[24]– سيدي عالي العلوي، مرجع سابق، ص 72.
[25]– حسن قرنفل، مرجع سابق، ص 81.
[26]– حميد العموري، مرجع سابق، ص 7.
[27]– Ahmed Gazali « Contribution à l’analyse du phénomène associatif au Maroc » in changement politique au maghreb CNRS. Paris 1991. P 257.
[28] – Ali Oumlil « Droit de l’homme au Maroc. Un enjeu de société » in « democracia y derechos humanos en el mundo arabe » Géma Martin Munoz(ed) Madrid. Institu de coopération con el Mundo arabe 1993. P 196
[29] – Ahmed Gazali. Op cit, P 257.
[30] – Mohamed Tozi « Représentation/ intercession: les enjeux du pouvoir dans les champs politiques au maghreb » in changement politique au maghreb. CNRS. Paris 1991. P 1.
[31] – نشير في هذا الصدد إلى انسحاب من اللجنة التنظيمية المؤقتة للمنظمة. كل من خالد الجامعي مدير تحرير جريدة الرأي وعبد الجبار السحيمي عن حزب الاستقلال.
[32] – J.P. BROS « chronique Marocaine » in annuaire de l’Afrique du nord. CNRS. Paris 1988. P 690.
[33] – Mohamed Tozi, Op cit, P 166.
[34]– حسن قرنفل، مرجع سابق، ص 82.
[35]– وذلك بالرغم من تصريح رئيس المنظمة الشرفي الأستاذ المهدي المنجرة بما يلي: “لا أريد أن أصدر أي حكم على الجمعيتين الموجودتين (يقصد العصبة والجمعية) إلا أنه لا يمكنني أن أكتم حقيقة واضحة هي أنهما أنشأتا لأغراض حزبية وما تزالان تحت وصاية الأحزاب. إن من حق كل حزب أن يخلق الجمعيات التي يريد، فهذا هو حق مشروع. أما نحن من جهتنا فنريد أن ننشأ منظمة مستقلة يمكنها العمل بحرية وبعيدا عن الاكراهات التي يفرضها العمل الحزبي. Kalimah N° 31 Décembre 1988. P 69
[36]– حميد العموري، مرجع سابق، ص 7.
[37]– Abdelmoughit Benmessaoud tredono: démocratie: « culture politique et alternance au Maroc ». Casablanca les éditions maghrébines 1996. P 69.
[38]– هذه الأسباب واردة في بلاغات وتصريحات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
Voir « l’organisation marocaine des droits de l’homme à travers ses communiqués et déclarations ». Mai 1988. Mars 1991. Casablanca éd. Maghrébines 1991.
[39]– كريم متقي، “الهجرة السرية للأطفال القاصرين المغاربة نحو أوربا دراسة في ظل المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص: جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس السنة الجامعية 2005/2006، ص 58.
[40]– محمد الغيلاني. مرجع سابق، ص: 96.
[41]– Mouhamed Mouaquit « le mouvement des droits humains au Maroc » dans « la société civil au Maroc » op cit, P 96.
[42]– Guilain Denoeux et Laurent Gateau « à la recherche de la citoyenneté » in mode arabe maghreb machrek. Niso oct. Dec. 1995. PP 1939.
[43]– Abdelaziz Benani « le mouvement marocain des droits humains, lutte pour la citoyenneté et l’état de droit rapport inédit.
[44]– حميد العموري، مرجع سابق، ص 8.
[45] – سيدي عالي العلوي، مرجع سابق، ص 75.
[46] – أحمد مفيد ” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب: مظاهر الضعف وسبل الإصلاح” ضمن ” الحقوق اقتصادية والاجتماعية في المغرب” مجلة نوافذ. العدد 35/36 يناير 2008. ص 68.
 مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
مجلة المنارة مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية